مقدمة
فيونا مولَعة بالنحل الطنَّان. فعندما كانت طفلة صغيرة، علَّمها والدها كيف تُربِّت عليه؛ بحركة بطيئة رفيقة، مع الانتباه إلى حركة رفع الساق الوسطى التي تُشير إلى انزعاج النحلة. وعندما ترى نحلة واقفة وسط ممرٍّ مرصوف، كما يحدث أحيانًا عندما يتعب النحل أو يدنو من نهاية عمره، فإنها تنقلها إلى جانب الممرِّ لتكون في مأمن. مدَّت فيونا يدَها التي دفأها الجهد البدني الذي كانت تبذله أمام النحلة، فزحفت على الفور لتستقر في راحة يدِها.
نظرت إليها فيونا من كثب فلاحظت أمرين. عرفت من نمط خطوطها أنها ملكة من نوع «بومبس تيريستريس» التي تُسمَّى نحلة الأرض الطنانة، أو النحلة الطنانة البرتقالية الذيل. وجدتْها أيضًا بلا جناحَين. على الأرجح شوَّه فيروسٌ ما جناحَيها، لكن فيونا لم تعرف ذلك إلا لاحقًا. أول ما فعلته هو أنها أدخلت الملكة المسلوبة الجناحَين إلى بيتِها، ومزجت ملعقة من محلول السكر، وراقبت النحلة وهي ترتشف منه وتُنظف وبرَها بعناية، ثم بدأت تفكر في الأمر.
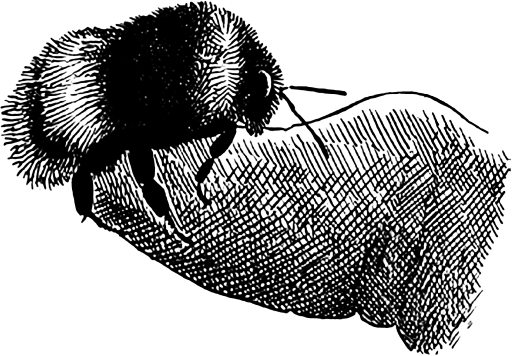
تقول فيونا وهي تصف معضلة مألوفة يواجِهها أي شخص توقَّف لمساعدة حيوان في مِحنة دون أن يفكر في التبعات العملية: «قلت في نفسي، ماذا عساي أن أفعل؟ أنا مضطرة للذهاب إلى عملي»، وكانت فيونا تعمل مساعدة أمين مكتبة في قرية كولودن الساحلية في اسكتلندا. أعادت النحلة إلى حديقتها وذهبت إلى ورديَّتها. وعندما عادت، وجدت النحلة حيث تركتْها، وقد ساء حالها. أدخلتها فيونا إلى البيت وأعطتها مزيدًا من محلول السكر. مرةً أخرى، زحفت النحلة إلى يدِها.
في الأسابيع القليلة التالية، عاشت النحلة «بي»، وهو الاسم الذي أطلقته عليها فيونا، في صندوق جهَّزته لها في المطبخ. في الأيام المُشمسة، كانت تُخرجها في الهواء الطلق. وبحلول شهر مايو، صار الطقس دافئًا بما يكفي لتُقيم النحلة في الخارج؛ زرعت فيونا في أصص أعشاب الشيح والغار والأنيمون التي جلبَتْها من مركز الحدائق المحلِّي، وأحاطتها بشبكةٍ بها فجوات حتى تتمكن النحلة من الخروج منها إذا أرادت. قضت ثلاثة أيام قلقة؛ إذ لم ترَ فيها النحلة. وفي صباح اليوم الرابع، بينما كانت فيونا تُطعم قطة أحد جيرانها، أرسل لها زوجها رسالةً نصية يُخبرها فيها أن النحلة عادت! فهُرعت فيونا إلى المنزل. ووجدت النحلة «بي» تبدو مُتسخة لكنها حية، ومتأهِّبة كي تزحف على يدِها.
هكذا مرَّ الصيف المشمس. عاشت النحلة في حديقة فيونا؛ وكانت فيونا تزورها، وإذا لم ترَها على الفور، كانت تطرُق برفق على الصندوق الذي تُعشش فيه. فكانت النحلة تخرج، رافعةً قرنَي استشعارها. كانت تُحب أحيانًا أن تستقر فوق أنف فيونا، لكن في أغلب الأحيان كانت تستقر في راحة يدِها. تتساءل فيونا الآن إذا كان دفء يدِها وإيقاع نبضها المُنتظم يُذكِّر النحلة بضجيج الخلية.
تقول فيونا: «كانت تُحب أن تستقر في ثنية يدي وتُنظف نفسها. ثم كانت تخفض قرنَي استشعارها وتنام. وكنت أنا أجلس وأطالع كتابًا.» ذات يومٍ عاصف كانت فيونا قد أدخلتها إلى البيت، وحين اقتربت فيونا منها وجدتها تقِف وظهرها إليها، وحرصًا على ألا تُخيفها، أعلنت عن وجودها بنقرِها على الطاولة. استدارت النحلة وأسرعت إليها. تتذكَّر فيونا فتقول: «صدقًا، أظن أن النحلة «بي» كانت تُسَر دائمًا برؤيتي. لم تكن تبحث عما تأكُله أو تشربه. إنما كانت تأتي إليَّ وتستكين في يدي. كأنما تُحب رفقتي بقدْر ما أُحب رفقتها.»
من حينٍ لآخر، كانت «بي» تحاول أن تطير؛ إذ كانت تهز عضلات جناحَيها بلا جدوى. بعد ذلك، كانت تُطرِق وتُخفي وجهها. كانت فيونا تُربِّت عليها وتُهمهم لها؛ فكانت «بي» تطقطق وتئزُّ وتبدأ في تنظيف نفسها. كانت «بي» نحلة مُفرطة في النظافة؛ فلم تتغوَّط في عشها قط، وإذا احتاجت إلى التغوُّط وهي تقِف على يد فيونا، كانت تُبرز بطنها من جانب يدِها. كانت بريسلي تُحب أن تمزح قائلة إن «بي» مدرَّبة على استخدام المرحاض.
مع تقدم الصيف، توقفت «بي» عن محاولة الطيران. لم تعُد صغيرة؛ في الواقع، كانت في منتصف عمرها بالفعل عندما وجدتها فيونا؛ إذ وُلدَت في الصيف السابق، وقضت الخريف والشتاء في سبات. إذا كانت السنة الواحدة في عمر الكلب تعادل سبعًا من سنواتنا نحن البشر، فكذلك الشهر في عمر النحلة. بحلول أواخر الصيف، كانت قد دنت من نهاية عمرها. فكانت تنام أكثر فأكثر. واستمرَّت في الشُّرب لكنها توقفت عن أكل حبوب اللقاح. وتباطأت حركتها.
تقول لي فيونا بضحكةٍ قصيرة مُرتبكة: «هل بكيت؟ نعم.» كانت تعلم أن بعض الناس سيعتبرون هذا سخفًا، لكن بالنسبة إليها كان الأمر جِدَّ مُهم. «كانت في يدي عندما حرَّكَت ساقها الصغيرة للمرة الأخيرة. دفنَّاها في الحديقة. لن يعرف أحدٌ مكانها، لكنني أعرف، هي مدفونة بجانب إحدى نبتات الغار المُفضلة لديها.» أثناء حديثنا، تهدَّج صوت فيونا. قد تكون «بي» مجرد نحلة، لكنها كانت صديقتها. تتابع فيونا قائلة: «قد يظن الناس أنني كنتُ أتخيَّل ذلك»، لكنها تعتقد أن «بي» كانت تعرفها وتُميزها. تقول: «وكأني ما زلتُ أشعر بها في يدي. كانت مُذهلة حقًّا.»
غير أن هذه ليست مجرد قصصٍ مُحرِّكة للعواطف السطحية العابرة. مشكلات العالم واسعة ومؤلِمة للغاية إلى الحد الذي يشلُّ الحركة؛ وقصص التواصُل مع الحيوانات هذه بمثابة شرارات أمَل واحتمالات يمكن أن تتحقق. هذه القصص وثيقة الصِّلة بالتعاطف؛ إدراك أن الحيوانات الأخرى كائنات مُفكرة حساسة تشترك معنا في سِمات كثيرة، رغم ما بيننا من اختلافات.
•••
مع ذلك على الرغم من كل ما تعلَّمه العلماء، كثيرًا ما يبدو أن اكتشافاتهم من الصعب ترجمتها. فعقولنا لا تستوعبها بمجرد أن نغلق الشاشات ونخرج إلى العراء. رغم أننا نعترف بأن حيواناتنا الأليفة المحبوبة كائنات تُفكر وتشعر وتختبر الحياة بذاتها، بل نكافح أحيانًا — وليس دائمًا — لإثبات أن الحيوانات التي نأكلها أو نُجري عليها الأبحاث تُعَد أشخاصًا، فإن مجتمعنا لم يُنشِّئنا على النظر إلى الحيوانات البرية بهذه الطريقة.
الأعراف والمفاهيم التي تُحدد علاقاتنا بالطبيعة متجذِّرة في التقاليد التي تنفي وجود ذكاءٍ غير بشري. عند الحديث عن موضوعات مثل الجمال والإجلال، والتعالي، والموارد، وإدارة الحياة البرية، والوصاية، والحفاظ على الطبيعة، والتنوُّع البيولوجي، ومناصرة البيئة، والاستدامة، بل حتى التاريخ الطبيعي؛ نادرًا ما يُنظَر إلى الحيوانات باعتبارها كائنات ذكية بالمعنى المُعقد للذكاء، أو باعتبارها أفرادًا تشترك معنا في السمات العقلية الأساسية. ورغم أن المشتغلين بتلك الميادين قد يعتقدون خلاف ذلك، فإن هذا الإدراك مُقتصر على قصص الأطفال والأعمال الترفيهية غير المُطلَقة الجدِّية؛ وهي صنوف مُهمة، ولكن من السهل غض الطرف عنها. عندما يتعلق الأمر بالطبيعة والحيوانات التي تعيش خارج منازلنا، فإن تصوُّراتنا الثقافية هي إرث قرون مضت.
تتحدَّى أبحاث الذكاء الحيواني هذه التصوُّرات المتوارثة. في كتابنا «تعرَّف على جيرانك»، سنبدأ بتطبيق أحدث الأبحاث على حيِّز الحياة اليومية العادية في الضواحي المجاورة. هذا الكتاب لا يقتصر على الحياة في الضواحي؛ لكنها مُنطلق جيد لرحلة النظر في عالم العقول المحيطة بنا، لرأب الفجوة بين التقدير المجرد وذلك المختبر فعليًّا. غالبًا ما ينصبُّ الاحتفاء بالذكاء الحيواني على قلَّةٍ مختارة من النجوم، مثل الشمبانزي والدلافين، ولكننا محاطون بعوالم زاخرة بالتفكير والمشاعر والعلاقات.
مجرد إدراك أن البشر لا يفصلهم عن سائر الحيوانات الأخرى حد فاصل واضح وقاطع لهي بداية جيدة. ولكن هذا الشعور بالقرابة يُثير لدَينا سؤالًا عما يمكن أن نفعله إزاءه. كيف يمكن أن يؤثر الوعي بعقول الحيوانات على فهمنا لها، وعلى معايشتنا لها على كوكبنا العزيز الذي نشاركها فيه؟ هذا سؤال محوري في عصرِنا الحالي، وهو السؤال الأساسي الذي حرَّكني لتأليف هذا الكتاب.
صادَقَت فيونا بريسلي نحلةً طنانة، وأحد أوجه جمال قصة الصداقة تلك هو أن فيونا شخص رمزي. إنها ليست ناشطة حماية بيئة متعصبة؛ هي مجرد شخص عادي مُحب للطبيعة، علَّمها أبواها ملاحظة الزهور البرية والبحث عن بيض الضفادع، تتحمَّس عند رؤية صقرٍ يحوم فوق رأسها، وتترك جزءًا من مرج حديقتها غير مشذَّب لأجل الفراشات. كما أنها ليست ناشطة في مجال حقوق الحيوان؛ إنما لديها زميلة نباتية في المكتبة بدأت تُقدِّر أفكارها، وهي ترى أن جميع الكائنات الحية تستحق الاحترام، لكنها لا تزال تُحاول اكتشاف ما يَعنيه ذلك بالنسبة إليها. أعتقد أن كثيرًا منا يتشابَه معها.
سنلتقي بأشخاصٍ آخرين توغلوا في هذه الأفكار إلى أبعد من ذلك، يُناضلون من أجل معاملة الحيوانات باعتبارها أشخاصًا بموجب القانون — وهي صفة ظلَّت حكرًا على البشر مدة طويلة — وحتى لإعطائها صوتًا في الأنظمة السياسية. ثم سنستكشف كيف تتشكَّل علاقات جديدة مع الحيوانات البرية في الحياة اليومية. يسهل أن ننظر إلى الحيوانات بذهنٍ مُتفتح عندما نتأمَّلها من بعيد، ونرى جمالها؛ ولكن ما حق الآفات، أو الحيوانات المريضة أو المُصابة علينا؟ وكيف نتعايش مع الحيوانات المفترسة التي لا يكون وجودها دائمًا مُرحبًا به؟
تدور أغلب القصص الواردة هنا في المدن والضواحي، وهي البيئات التي تعرَّف معظمنا على الطبيعة فيها، وسط المخلوقات التي نُقابلها في حياتنا اليومية. ومنها نسافر إلى مناطق أبعد عن التمدن، لنستكشف ما ينطوي عليه التقدير الأعمق لعقول الحيوانات من تبعات، وما يُثيره من أسئلة أخلاقية، بالنسبة إلى حفظ الطبيعة وعلم البيئة. إذا كانت الحيوانات البرية أقرباءنا، فكيف ينبغي لنا إدارتها؟ وهل يمكن أن يؤدي التفكير بهذه الطريقة إلى مفاهيم جديدة للطبيعة؟
إجابة هذه الأسئلة ضرورية لفهم أنفسنا وسائر الكائنات الحية. ورغم أن اعتبار الحيوانات الأخرى أشخاصًا مثلنا لن يوقف الانقراض الجماعي ويُعيد إثراء التنوُّع البيولوجي على الأرض تلقائيًّا، فإن هذا التغير في منظورنا يبدو شرطًا أساسيًّا لتجنُّب هذه المآسي، مثلما يمكن لاهتمام الناس بعضهم لأمر بعض أن يحلَّ مشكلات المجتمعات البشرية.
من المُحتمل أنك تعرف بالفعل مصطلح «الأنثروبوسين»، أو حقبة التأثير البشري، وهو مصطلح ظهر في مطلع الألفية الحالية لوصف حجم التأثير البشري على الحياة والعمليات الحيوية على كوكب الأرض. إذ باتت البشرية قوة مُهيمنة على الكوكب، تُنظم دورات المغذيات العالمية وتُغيِّر المناخ وتُعيد ترتيب النظم البيئية. هذه السلطة يجب فهمها لا من حيث ما نفعله فحسب، بل أيضًا من حيث هويتنا. لقد فرضنا قيمَنا على الكوكب. بات ما نهتمُّ به بشرًا كان أو حيوانًا، وتصوُّراتنا عن أنفسنا والآخرين، ومبادئنا وأخلاقياتنا، تُشكِّل مسار الحياة برمَّتها. وحتى إذا ثبت أننا غير قادرين على وقف الدمار البيئي، وإذا كان أحفادنا سيَرِثون أرضًا مختلفة تمامًا عن تلك التي نعيش عليها الآن وأقل خضرةً منها، فستظلُّ الطبيعة والحيوانات موجودة، وسيظلُّ حُسن معايشتها حتمية قائمة.
غير أن عبارة براند فيها شيء من الحقيقة. فنحن كأفراد، يملك كل واحد منَّا القدرة على اتخاذ قرارات تُغيِّر حياة الكائنات الأخرى للأفضل أو للأسوأ؛ وكجماعاتٍ أو مجتمعات، وإجمالًا كحضارة مكوَّنة من ثمانية مليارات إنسان، نُشكِّل العالم بسلطتنا. نحن بالفعل بمثابة آلهة، شئنا أم أبَينا. ولكن يمكننا إدخال تعديلٍ طفيفٍ على الشطر الثاني من عبارة براند ليُصبح: «حريٌّ بنا أن نُحسن الجوار.»



