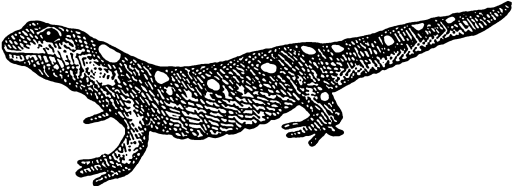خاتمة
مع تجمع أول أسماك الرنجة النهرية في «ليوناردز ميلز»، تقترب هجرة البرمائيات إلى نهايتها؛ ذلك الفيضان الهادئ من الحياة الذي يأتي في الربيع، والذي لا نحتفي به قدْر احتفائنا بهجرات الطيور أو حتى الأسماك؛ ربما لأنها تحدث في ليالٍ ممطرة. ففي تلك الليالي تأتي البرمائيات، تاركةً أكوام أوراق الأشجار، والجذوع المجوفة والجحور القديمة التي قضت فيها الشتاء، وهي تمشي وتقفز وتزحف قاطعة مسافات نقطعها نحن البشر بساقَينا الطويلتَين في دقائق قليلة، لكنها بالنسبة إليها تُعَد رحلة ملحمية. مثل سمك الرنجة النهري، تعود إلى أماكن ولادتها، ليس الأنهار والجداول، إنما البرك الربيعية، وهي مُنخفضات الغابات التي تمتلئ بالمياه كل ربيع وتُصبح ينابيع لحياة كائنات الغابة.
أكثر تلك البرمائيات المهاجرة عددًا هي ضفادع الربيع، التي لا يتعدَّى حجمها طرف الإصبع، لكن صوت جوقتها عالٍ لدرجة أنه يمكن أن يطغى على صوت مُحرك نفاث. في المنطقة التي نشأتُ بها من ولاية مين، توجَد أيضًا الكثير من ضفادع الأحراج، ودائمًا ما تفاجئني قليلًا أصواتها التي تُشبه أصوات البط، والضفادع النمرية وضفادع الكراكي، وهما نوعان ذوا جلدٍ مرقط جميل كالنوعَين اللذين سُمِّيا على اسمهما. يمكن لتلك الضفادع أن تعيش مدة تصِل إلى عقدٍ من الزمان، وهذا بمثابة معجزة. فكيف لشيء صغير وليِّن وهشٍّ للغاية مثلها أن يعيش لهذه المدة الطويلة؟
منذ عدة سنوات، سمعتُ عن شابٍّ يُدعى جريج ليكلير، كان يخرج وهو صغير في ليالي الربيع المُمطرة باحثًا عن البرمائيات ليحملها ويعبر بها الطرق حتى لا ينتهي بها الأمر تحت إطارات السيارات. على الأقل، كان يُوصل بعضها لبر الأمان. وعندما صار طالبًا في المدرسة الثانوية، أسَّس مجموعة على منصة فيسبوك لتنسيق جهود المتطوِّعين الآخرين. ولاحقًا، أضاف إلى تلك الجهود عنصر المشاركة المجتمعية في الأبحاث العلمية، إذ يُحصي المُنقذون عدد الحيوانات التي أنقذوها — وتلك التي لم ينقذوها — وذلك لوضع ممرَّات عبور للبرمائيات في المواضع العالية الخطورة من الطرق عندما يحين وقت صيانتها. انضممتُ إلى تلك المجموعة، والآن أُمضي ليالي شهر أبريل المُمطرة وأنا أذرع جزءًا من الطريق خارج مدينة بانجور جيئةً وذهابًا، مرتديًا سترة عاكسة وكشاف رأس، محاولًا الوصول إلى البرمائيات قبل أن تدهسها السيارات.
حتى حركة المرور المُعتدلة في التوقيت الخطأ يمكن أن تمحو مجتمعًا كاملًا من البرمائيات خلال بضع سنوات، لكنني لا أخرج إلى هناك تحت المطر فقط لأحمي مجتمعًا من البرمائيات، أو لأقوم بدوري لمنع انقراض البرمائيات، أو لأن البرمائيات تُمثل حلقةً مهمة في السلاسل الغذائية، وتوزع العناصر الغذائية في أرجاء المناطق الطبيعية، وتُعزز تنوع ووفرة الكائنات الحية فيها. كل هذه الأمور جزء من السبب، ولكن الجزء الأهم هو الحيوانات الفردية: تلك اللحظات التي أتواصل فيها مع ضفدع أو سمندل.
بفضل سمة غريبة في فسيولوجيا البرمائيات، تتَّخذ أفواهها وضعًا يُشبه الابتسامة. بالطبع هذا لا يعني أنها تبتسِم بالفعل — ربما تبتسم قليلًا عندما تنتهي إقامتها في برك الربيع بعدة ليالٍ من التزاوج الجماعي المحموم — ولكنه تذكير مفيد بأنها تشعر بشيءٍ ما في تلك اللحظة بغضِّ النظر عن ماهيته. وأنها تظل أشخاصًا رغم اختلافها عني، ترى الحياة بمنظورها، كائنات لديها خبرة حياتية فريدة وثرية مثل تلك الحلقة الذهبية المُجزَّعة حول عين ضفدع كراكي.
كل تلك الحسابات للمعاناة والرفاه، والصعوبات التي ستتكبدها في حياتها، وكم من بيضها سيُفترس، وكيف أنه لن يصل من نسلها إلى مرحلة البلوغ أي فردٍ تقريبًا: كل ذلك لا يُهم أمام قناعتي بأنها لا يجب أن تموت الليلة، تحت عجلات سيارة، وأن كل فردٍ أستطيع إنقاذه منها هو وميض نورٍ في هذا العالم، حبة رملٍ في ميزان الحياة. وهكذا، في هذه الليالي الربيعية المُمطرة، التي نحتفي بها كثيرًا بعد الشتاء الطويل، والتي يكون هواؤها مُتشبعًا برائحة التربة وتحلُّلها وتقلُّبها، أظل أذرع الطريق جيئة وذهابًا.
عندما يُضيء كشاف الرأس الذي أرتديه بروزًا في الطريق دالًّا على وجود سمندلٍ أو ضفدع، أركض نحوه، وألتقِطه بين يدي وأجتاز به الطريق، في الاتجاه الذي كان يسير فيه، ثم أضعه وسط الأحراج. في معظم الأوقات، أتمكن من الوصول إليه قبل مجيء سيارة، ولكن أحيانًا تعبر بعض البرمائيات الطريق في التوقيت الخاطئ، وأحيانًا، وهو الأصعب وقعًا على نفسي، لا أراها إلا في ضوء المصابيح الأمامية لسيارة قادمة، بعد أن يكون الأوان قد فات على فِعل أي شيءٍ سوى إزالة جُثثها المشوَّهة من قارعة الطريق ووضعها على جانبه حتى لا تُدهَس أيضًا آكلات الجِيَف على الأقل.
قالت لي أماندا سترونزا: «ما أدهشني هو عدد الأشخاص الذين قالوا «أوه، أنا أيضًا أفعل ذلك أيضًا»، أو «لطالما فكرت في فعل هذا». يشعرني ذلك بأن هناك مجتمعًا كبيرًا بالفعل من الأشخاص الذين يريدون التواصُل مع الحيوانات عن قُرب؛ لكن يبدو أنهم يخشون أن يستهزئ بهم الناس.» هناك قدْر كبير من الاهتمام والمراعاة في قلوب الناس، ينتظر فقط فرصةً للتعبير عنه.
في هذه الليالي لا يوجَد وقت لتلك الطقوس. فكل لحظة تأخير تزيد من احتمالية التأخر لبضع خطوات عن حيوان لا يزال بالإمكان مساعدته. في أول ربيع فعلت فيه ذلك، كانت جائحة كوفيد قد اندلعت لتوِّها، فكانت حركة المرور شِبه منعدمة تقريبًا؛ أما الآن فقد عادت إلى طبيعتها، وتمر سيارة كل دقيقة أو دقيقتَين، أو تمر سيارات أكثر إذا هطلت الأمطار في وقتٍ مبكر من المساء أو في ليلة عطلة نهاية الأسبوع. تمر السيارات مسرعة، وتترك مصابيحها الأمامية بقعًا مُظلمة في شبكية عيني فتصعب عليَّ رؤية البرمائيات، وفي تلك الأوقات يبدو الأمر أكثر من مهمةٍ أفعلها على طريق في شرق ولاية مين. يبدو تمثيلًا لفترةٍ من فترات الانقراض الجماعي، لعالم عامر بالحياة التي يقضي عليها عدم المراعاة والجشع وعقيدة النمو الاقتصادي اللامتناهي، الذي تتحمَّل تكاليفه تلك الكائنات التي لا تستطيع الاعتراض. عالم يُستغَل فيه الجمال ثم يُهمَل، ليس لأن ذلك حتمي، إنما لأن تأثير أولئك الذين يختارون عدم تغيير ذلك الوضع يطغى على جهود أولئك الذين يسعون لتغييره. عالم يبدو فيه احتمال المُستقبل اللائق أبعدَ من أي وقتٍ مضى. في ليالٍ كهذه، تتجسد الخسارة أمام عين المرء.
هل سيؤدي فهم الحيوانات الأخرى باعتبارها أفرادًا تُفكر وتشعر، وتَبنِّي منظومة أخلاقية يُحركها التعاطف والمراعاة، إلى عكس هذا المد الرهيب؟ على الأرجح لن يكفي ذلك وحدَه، مثلما لم تكفِ الجهود المُنفردة لكلٍّ من حركتَي الحفاظ على البيئة وحماية البيئة التقليديتَين. إذا أرادت البشرية أن تكون أكثر من مجرد قوةٍ مدمرة، فإن اجتماع كل طرق التفكير هذه ضروري. ومعًا لدَينا فرصة لتحقيق ذلك.
إن الاهتمام بالآخرين يُذكرك دائمًا بمقدار الألَم والصراع الموجودَين في العالم، وأيضًا بأن كلًّا منَّا بيدِه أن يُحدث فارقًا جوهريًّا في حياة شخصٍ ما. هناك أمور كثيرة يمكن القيام بها، فرادى أو مُجتمِعين، كي نتعايش بشكلٍ أفضل — ونكون أرحم وأكثر مراعاة وإنصافًا — مع جيراننا من الحيوانات. «أهلًا بالجيران» ليس بأي حالٍ من الأحوال كتابًا شاملًا؛ بل الغرَض منه هو أن يُغذي خيالك، ويُشجعك على التفكير في الأشياء المُمكنة التي بيدِك أن تفعلها.
إذا لم نعالج أزمتَي تغيُّر المناخ وانهيار التنوع البيولوجي، فستظل هذه الأفكار مهمة. إذ سنظلُّ بحاجة إلى إنشاء بقاع تسود فيها الرحمة والوفرة، لنخلق عالمًا أفضل من أجل تلك الكائنات التي تنجو. من أجل جيراننا.
ماذا بيد المرء أن يفعل غير ما في وسعه؟ أرى وميض كشافات رأس أخرى على امتداد الطريق. في السنوات التي تلت انضمامي لمجموعة «مين بيج نايت»، ازداد عدد أعضائها من بضع مئات إلى عدة آلاف من الأشخاص، جميعهم يقفون هناك في الظلام لإنقاذ الأرواح.
تمر السيارات، وبين الواحدة والأخرى، أجمع أكبر عددٍ مُمكن من الضفادع والسمندلات. أرى سمندلًا آخر، هشًّا وضعيفًا للغاية في ضوء شاحنة قادمة. لوهلة، يُخيل لي أني أستطيع الركض إليه وإنقاذه قبل مرور الشاحنة، لكنها تقترب بسرعة كبيرة. يقفز قلبي من بين أضلعي؛ بعد فترة من أداء تلك المُهمة، يتمكن المرء من توقُّع متى ستمر السيارة من فوق البرمائي دون أن تمسَّه، ومتى ستدهَسُه، وهذا السمندل في مسار العجلات مباشرة. تمر الشاحنة وسط هدير مُحركها وإطاراتها. ثم أتوجَّه بخطًى ثقيلة إلى الطريق لالتقاط جثة السمندل. فإذا بي أجده سليمًا معافًى.