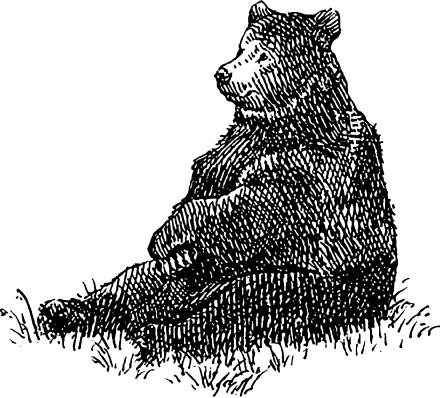الفصل العاشر
تحت إدارة جديدة
في عام ١٩٨٤، حصل فريد كونتز على وظيفةٍ في حديقة
حيوان برونكس بمدينة نيويورك. كان مُسمَّى وظيفته هو
«القيِّم على الثدييات»؛ وهو مُسمًّى وظيفي قديم يعيد
إلى الأذهان زمنًا كانت فيه الحيوانات تُعرَض كمعروضاتٍ
في متحف، ولا تَلقى أي اهتمامٍ بصحتها العقلية، شأنها
شأن التماثيل. لكن كونتز لم يكن ينتمي إلى تلك المدرسة.
كان قد أنهى مؤخرًا أبحاثه للدكتوراه في سلوك الحيوان في
حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية، التي كانت حاضنةً
للأفكار الجديدة — الشائعة الآن، لكنها كانت مُتطرفة
آنذاك — التي تؤكد على أهمية العلم والحفاظ على البيئة
بالنسبة إلى الحيوانات البرية. في حديقة حيوان برونكس،
التقى بالطبيبة البيطرية التي تزوَّجها لاحقًا، وانتقلا
إلى شقة داخل أراضي حديقة الحيوان.
كانا كثيرًا ما يأخُذان بعضًا من الحيوانات التي
يعملان معها إلى المنزل: الثدييات المريضة التي تحتاج
إلى رعاية على مدار الساعة، والصغار التي تخلَّى عنها
والداها. وكان من بين الضيوف غير البشريين في شقتهما
القرود الخرطومية أو قرود الململة، وقرود الطمارين
القطنية الرأس، وقرود المارموزيت القزمية، بل كان من
ضِمن تلك الحيوانات أنثى قرد أبي قلادة تُدعى جيني تُحب
مشاهدة مسلسل «عالم سمسم» وهي تتوسَّد لُعبتها المحشوة
المفضلة. كانت هناك طيور أيضًا، منها ببغاوات الأمازون
وأُنثى طنان ياقوتي الحنجرة وصلت مصابةً أثناء هجرة
الخريف، وأقامت معهما طوال الشتاء قبل أن يرسلاها في
طريقها في الربيع. يتذكَّر كونتز ذلك فيقول: «كانت تتمتع
بقدرات إدراكية عالية. كانت تتعرَّف عليَّ وتتحمَّس
للغاية لرؤيتي.» ولبضع ليالٍ، بات أسد بحر كاليفورني
رضيع في حوض الاستحمام الخاص بهما.
لطالما كان كونتز مُهتمًّا بالحيوانات، لكن العيش معها
أكسبه مستوًى جديدًا من التقدير لقدراتها العقلية
والانفعالية. لم يعتبر خفاش الفاكهة المصري الذي اعتنى
به مجرد فردٍ يُمثل نوعه؛ بل اعتبره فردًا مستقلًّا
أسماه فرودو، وكان فرودو يُحلق في جميع أنحاء الشقة ويحط
على كتفِه عندما يستدعيه.
لكن هذا الكشف لم يكن مُريحًا. على الرغم من تطور
حديقة حيوان برونكس وغيرها في هذا المجال، ومن أنها كانت
قد بدأت تخصيص المزيد من الموارد للحفاظ على الحيوانات
البرية مقارنة بالعقود الماضية، فإن مستوى رفاه أفراد
الحيوانات التي كانت ترعاها حدائق الحيوانات كان أسوأ
بكثيرٍ من مستواه الآن. وحتى في يومِنا هذا، يجوز القول
إنه بالنسبة إلى العديد من الحيوانات، فإن تجربة الأسْر
في حدائق الحيوان تظلُّ تجربة غير سارة، بل مُريعة في
بعض الأحيان؛ ولكننا نُحرز تقدمًا على الرغم من ذلك.
فبالمقارنة بذلك الوقت، كانت بداية الثمانينيات بمثابة
العصور المظلمة. يقول كونتز الذي كان يُحركه شغفه لحماية
الأنواع البرية: «قضَينا لياليَ عديدة بلا نوم. ولكن بعد
ذلك كان عليَّ أن أتجول وأرى هذه الحيوانات موضوعة في
أقفاص.»
ترك كونتز عملَه في حديقة حيوان برونكس عام ١٩٩٨.
بعدها عمل في منظمة بيئية غير ربحية تُشرف على خبراء
الحفاظ على البيئة في البلدان النامية، ثم تولَّى إدارة
محمية طبيعية في نيويورك قبل أن يتولَّى وظيفة في حديقة
حيوان مُتنزَّه وودلاند في سياتل، واشنطن. هناك ساعد في
الإشراف على مشاريع الحفاظ على الحياة البرية الميدانية،
التي كان من ضِمنها التعاون مع إدارة الأسماك والحياة
البرية في واشنطن بشأن استعادة أعداد سلاحف البرك
الغربية وفراشات أوريجون الفضية الرقطاء المُهددتَين
بالانقراض. على الرغم من أن كونتز يعمل في مجال الحفاظ
على البيئة، فإنه ظلَّ محتفظًا بذلك الشعور بالتعاطف
والمودة للحيوانات على مستوى الأفراد.
يمكن اعتباره مجسدًا للتغيُّر الجذري في القِيَم
العامة، التي ابتعدت عن الشعور بالسيادة على الحياة
البرية، واقتربت مما يُسمِّيه علماء الاجتماع الذين
يقيسون ذلك التحول «قيم المعاملة بالمِثل» التي تعتبر
الحيوانات البرية «رفقاء في جماعة اجتماعية
مشتركة»،
1 لها مقاصدها وانفعالاتها وعقولها الخاصة.
هذا لا يعني أن الجميع أصبحوا نشطاء في مجال حقوق
الحيوانات؛ فالأمر ليس كذلك بالمرة. لكن عدد الأمريكيين
الذين يعتقدون أنه يجب إدارة الحياة البرية بما يخدم
مصالح البشر لا ينفكُّ يتقلَّص، في حين يتزايد عدد الذين
ينظرون إلى الحيوانات على أنها أشخاص من جانبٍ
ما.
عندما قاد نشطاء حقوق الحيوان حملةً ضد مسابقات قتل
الحيوانات البرية في واشنطن،
2 كان كونتز من بين المواطنين الذين أدلوا
بإفاداتهم في جلسات الاستماع العامة التي عقدتها
الإدارة. لم تقتصر رسالته على بيان خطأ تنظيم الناس
فعالياتٍ لقتل أكبر عددٍ ممكن من المخلوقات، وذلك
باستغلالهم للأنواع التي لا تحظى بحمايةٍ كبيرة بموجب
القانون — مثل القيوط والراكون والثعالب والغربان والوشق
— ومنح جوائز لمن يقتل أكبر عددٍ من الحيوانات أو أكبر
حيوانٍ أو أصغر حيوان. إنما تضمَّنت رسالته أيضًا
تشجيعًا للإدارة على عدم الخوف من التغيير. كانت تجربته
في حديقة حيوان برونكس مفيدةً للغاية، حيث كان الطرف
الذي تلقى غضب النشطاء الذين دفع ضغطهم الحديقة في نهاية
المطاف إلى عدم اقتناء أفيال
جديدة.
⋆ في بعض الأحيان
تتغير القِيَم العامة. قد يكون ذلك غير مريح؛ لكنه يؤدي
إلى إحراز التقدُّم.
صوَّتت اللجنة في النهاية لصالح حظر مُسابقات القتل؛
إذ كانت نتيجة التصويت سبعة أصوات مقابل صوتَين؛ مما جعل
واشنطن الولاية السابعة التي تحظر تلك
المسابقات،
3 تبِعتها ماريلاند في عام ٢٠٢١ وأوريجون في
عام ٢٠٢٣. لكن تظلُّ المسابقات قانونية في أماكن أخرى.
ورغم أن عدد الحيوانات التي تُقتل فيها — الذي يبلغ نحو
٦٠ ألفًا وفقًا لتقديرات جمعية الرفق بالحيوان
الأمريكية
4 — يُعَد ضئيلًا مقارنةً بالخسائر الناجمة عن
تدمير الموائل أو حوادث اصطدام المَركبات، فإن ما تُجسده
من استخفاف بالأرواح جعلها نقطة خلافٍ حادة في قضيةٍ
أكبر بكثير، وهي ممارسات الوكالات الحكومية لإدارة
الحياة البرية، التي تتوسَّط بدرجةٍ ما العلاقات بين
البشر والحيوانات في معظم أنحاء الولايات المتحدة. كيف
ينبغي تنظيم القنص والصيد بالفخاخ وصيد الأسماك، وكيف
ينبغي للوكالات المَعنية بتنظيم تلك الممارسات وبحماية
الأنواع الأخرى وبتعزيز التنوع البيولوجي تحديد
أولوياتها؟ ومَن ينبغي أن يصوِّت على مثل تلك القرارات؟
وكيف ينبغي أن تُمثل تلك العملية قيم القرابة والمعاملة
بالمِثل والتقدير الأخلاقي للذكاء الحيواني؟
•••
يرجع النظام الحالي لإدارة الحياة البرية في الولايات
المتحدة جزئيًّا إلى قرار المحكمة العُليا عام ١٨٤٢ في
قضية نزاع على حصاد المحار في خليج راريتان في
نيوجيرسي.
5 قضت المحكمة بأن جميع بحيرات نيوجيرسي
وأنهارها ومناطق المد والجزر الساحلية فيها تُعَد ملكية
عامة لساكنيها. كانت هذه المسطحات المائية والأرض
الواقعة تحتها على درجة من الأهمية تمنع مِن أن تتحكَّم
فيها جهات خاصة. بدلًا من ذلك، تَقرر أن تُديرها الحكومة
بما يخدم الصالح العام.
كان ذلك الحكم علامة فارقة فيما يُعرَف الآن بمبدأ
الأمانة العامة، الذي سيتسع لاحقًا ليشمل الحياة البرية
أيضًا. كل حيوان بري في الولايات المتحدة مملوك للعامة
وتديره الحكومة. وتقع مسئولية إدارته في الأغلب على عاتق
وكالات الحياة البرية التي تشكَّلت في أواخر القرن
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حين أدى الطلب الهائل
على اللحوم والفراء والريش إلى ازدهار عمليات الصيد التي
أدَّت إلى انقراض بعض الأنواع، أشهرها الحمام الزاجل
الذي كانت أسرابه ذات يوم تُظلِم السماء، وعرضت أنواع
أخرى مثل الأيائل البيضاء الذيل والبلاشين البيضاء
والتماسيح الأمريكية لخطر التهديد بالانقراض.
ضغطت جمعيات الصيد الرياضي من أجل وضع اللوائح
التنظيمية الأولى.
6 آنذاك، كان مجرد وجود مواسم للصيد أمرًا
مستحدثًا. أصبح ثيودور روزفلت، الذي أسَّس نادي «بون
وكروكيت» الشهير، وساعد في نشر فكرة المطاردة العادلة في
الصيد، رئيسًا للولايات المتحدة في عام ١٩٠١؛ وخصَّص ما
يقرُب من ٣٦٠ ألف ميل مُربَّع لحفظ البيئة، كان من
ضِمنها أولى محميات للحياة البرية في البلاد. قيَّدت
قوانين جديدة الاتجار في أجساد الحيوانات البرية، وحمَتْ
معظم أنواع الطيور المهاجرة. ساهم نشر بيان «سياسة الصيد
الأمريكية» عام ١٩٣٠، التي أشرف على صياغتها ألدو
ليوبولد، في تشكيل مجال تنظيم وإدارة الحياة البرية
الناشئ،
7 الذي أصبح أول مجال عمل يعمل به عُلماء
أحياء مدربون.
خرَّجت الكليات مُتخصِّصين في إدارة الحياة البرية من
الشباب، الذين ذهب العديد منهم للعمل في الوكالات التي
تُشرف على القنص والصيد بالفخاخ وصيد الأسماك. وموَّلت
عوائد التراخيص والضرائب المفروضة على البنادق والذخيرة
هذه الوكالات. كانت تُوجِّههم مجموعة من المبادئ: الحياة
البرية أمانة عامة. والسياسات يجب أن تستنِد إلى العلم.
ولا يجب قتل الحيوانات إلا لأغراضٍ مشروعة.
8 ولا ينبغي شراء وبيع أجسادها. وبخلاف أوروبا
التي كان صيد الحيوانات والأسماك يُعَد فيها حكرًا على
الطبقة الأرستقراطية، سيكون الصيد في أمريكا متاحًا لأي
شخص.
يُطلَق على كل هذا أحيانًا اسم نموذج أمريكا الشمالية
في الحفاظ على الحياة البرية، وهو اسم استحدَثه في عام
١٩٩٥ عالم الأحياء فاليريوس جيست. في مقال بعنوان «ولد
بين أيدي الصيادين»، كتب جيست وعالم الأحياء جون أورجان
من إدارة الأسماك والحياة البرية الأمريكية وعالم الحفاظ
على البيئة شين ماهوني: «أدى ذلك النموذج في النهاية إلى
انتعاش الحياة البرية على مستوى القارة على نطاقٍ لا
مثيل له في العالم.» على الرغم من أن النقَّاد يرَون أن
هذه الإشادات تُقلل من دور غير الصيادين،
9 فإن نموذج أمريكا الشمالية قد حقَّق قطعًا
منافع كثيرة؛ ولكنه انطوى أيضًا على تناقُضات وثغرات
تزايدت بمرور الوقت.
على الرغم من أن مجال إدارة الحياة البرية سيضم لاحقًا
مبادئ علم البيئة، ويتطوَّر لأن يكون أكثر من مجرد «فن
جعل الأرض تنتج محاصيل سنوية مُستدامة من الطرائد البرية
للاستخدام الترفيهي»،
10 كما عرَّف ألدو ليوبولد تخصُّصه، فإنه لا
يزال يركز على الصيد وما يُسمى بأنواع الطريدة. ورغم
تزايد دور الوكالات في الحفاظ على البيئة، يظل صيد
الحيوانات والأسماك يحظى بنصيب الأسد من التمويل المتاح.
كان أحد أسباب إحباط فريد كونتز هو تخصيص خمسة بالمائة
فقط
11 من ميزانية إدارة الأسماك والحياة البرية في
واشنطن لتعافي ٢٦٨ نوعًا من الأنواع غير الطريدة
المُهددة بالانقراض،
12 حسب تقديراته.
بالطبع، هذان الهدفان لا يتعارضان بالضرورة؛ فحماية
الأراضي الرطبة، على سبيل المثال، تساعد شبكات حياة
واسعة، وليس فقط الطيور المائية التي يسعى إليها
الصيادون. ومع ذلك، هناك أوقات تتعارض فيها إدارة
الطرائد مع ما يعده كثير من الناس ممارسات الحفاظ على
البيئة، وكذلك مع قِيَمهم الأخلاقية. وأبلغ مثال على ذلك
هو الحيوانات المفترسة. فحتى القرن العشرين، كان من
الشائع أن يشجع مُتخصصو إدارة الحياة البرية على إبادة
الذئاب والقيوط والدببة وأسود الجبال وغيرها من
الحيوانات التي تُنافس الصيادين على الطرائد التي
يَنشدونها. هذه الكراهية تضاءلت اليوم، لكن يظلُّ من
الشائع تنظيم أعداد الحيوانات المفترسة من أجل زيادة
أعداد الأنواع التي يستهدفها الصيادون.
هل يُعَد هذا سببًا مشروعًا للقتل؟ قد يختلف العقلاء
على إجابة هذا السؤال. ماذا عن القتل من أجل الرياضة
بدلًا من المعيشة؟ يختلف الناس على ذلك أيضًا، وكذلك على
شرعية اصطياد الحيوانات من أجل فرائها. إذ يرى بعض الناس
— وجميع وكالات الحياة البرية — أن هذه الأنشطة لا بأس
بها ما دامت لا تُهدد سلامة أعداد تلك الحيوانات. بينما
يرى البعض أن سلامة الأعداد مسألة ثانوية، وأن المسألة
الأساسية هي كيفية تعامل تلك الوكالات مع أفراد
الحيوانات؛ فيقول عالم الأخلاق بيل لين، إن الوكالات «لا
تفكر في القيمة الجوهرية لهذه الحيوانات باعتبارها
أشخاصًا: عاقلة واجتماعية وتربطها علاقات مع أفراد
آخرين. وهو ما يتطلَّب مستوًى أعلى من التفكير
الأخلاقي.» بالتأكيد يرى عدد كبير جدًّا من الناس — ليس
فقط دُعاة حقوق الحيوان، ولكن العديد من الصيادين وغيرهم
من دعاة الحفاظ على البيئة أيضًا — أن مسابقات القتل غير
شرعية، لكنها تظلُّ قانونية في معظم الولايات.
قبل التصويت على مشروعية مسابقات القتل بعدة سنوات،
عقد كونتز اجتماعًا للعلماء والنشطاء والصيادين ونشطاء
حقوق الحيوان ونشطاء الحفاظ على البيئة لمناقشة كيف يمكن
تغيير إدارة الحياة البرية في واشنطن. كان من بين
الأفكار التي ناقشوها فكرةٌ ظلَّ دعاة الإصلاح يضغطون
لتنفيذها في العديد من الولايات لكن دون جدوى: مقاعد في
اللجان الحكومية المسئولة عن تحديد أولويات، وقواعد
وكالة الحياة البرية في كل ولاية. هذه اللجان تتكوَّن في
أغلبيتها من أشخاصٍ لديهم خلفيات في القنص وصيد الأسماك
وأحيانًا الصيد بالفخاخ؛ أي إنهم فئة تُسمَّى
بالمُستخدمين المستهلكين للحياة البرية.
13 ولكن إذا كانت الحياة البرية ملكًا للعامة،
فهل من العدل أن يكون لفئة واحدة من العامة مثل هذا
النفوذ الكبير في إدارتها؟
في القرن الماضي، عندما كانت هذه الأنشطة أكثر شيوعًا
بكثيرٍ مما هي الآن، لم يُثِر ذلك غضب الكثيرين. أما في
الوقت الحاضر، فقد زاد عدد الأمريكيين الذين يُراقبون
الحياة البرية وليسوا صيادين بمقدار ثمانية
أمثال؛
14 ببساطة لا يرى كثير من الناس الحيوانات
البرية «موردًا يمكن إدارته بشكلٍ مُتجدد ومستدام»، كما
جاء في تقرير لجمعية الحياة البرية، وهي المُنظمة
المختصَّة التي أسَّسها ألدو ليوبولد.
15 وصف ذلك التقرير الاعتقاد بوعي الحيوان بأنه
تهديد صريح. إذ جاء فيه: «إذا أصبحت فلسفة حقوق الحيوان
قانونًا، فلن تُعَد الحياة البرية ملكية، ومِن ثَم ستخرج
من نطاق الأمانة العامة.»
إن القلق بشأن الأمانة العامة مفهوم. ففي خضم أزمة
انقراض، ليس من الملائم فقدان الدعم الذي يُقدمه
الصيادون للحفاظ على البيئة. ومع ذلك، ليس من الصعب
إدراك أن ثَمة صدامًا أعمق، أو صراعًا بين الأنظمة
القيمية؛ كما أن استبعاد القيم العامة المُنتشرة على
نطاقٍ واسع من الاعتبار الجاد أثناء إدارة أمانة عامة
يبدو مخالفًا لكلٍّ من مبدأ الأمانة العامة والمبادئ
الديمقراطية الأساسية.
لهذا عندما دعت إدارة الأسماك والحياة البرية في
واشنطن كونتز للانضمام إلى لجنتها، كان في غاية السعادة.
فقد كانت تلك فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي كان يأمُل فيها
هو وغيره؛ فرصة لتمثيل وجهات نظر مُستبعدة عن الحيوانات،
والضغط لأجل جعل إدارة الحياة البرية تُركز أكثر على
الحفاظ على البيئة، وأقل على الاستهلاك. لكن سيتبين له
أن الأمر أصعب بكثيرٍ مما كان يتوقع.
•••
كان كونتز واحدًا من مُفوَّضَين جديدَين في اللجنة.
وكانت الثانية لورنا سميث،
16 وهي ناشطة بيئية ومدافعة عن حقوق الحيوانات
البرية. وبلغة العلوم الاجتماعية، منح وجودهما أصحاب
توجُّه المعاملة بالمِثل ثلاثةَ مقاعد في اللجنة، في حين
شغل أصحاب الفكر التقليدي خمسة مقاعد. كانت تلك نسبة
معقولة، بالنظر إلى التركيبة السكانية لمدينة واشنطن،
لكنها كانت مزعجة لمجتمع الصيد الذي هيمن فترةً طويلة
على اللجنة وشعر بأنه مُقيد. وما زاد من التوتر أن
المقعد المُخصَّص للجزء الشرقي من الولاية، وهي منطقة
ريفية ذات ميول محافظة يشيع فيها الصيد أكثر من
المقاطعات الغربية الحضرية، تُرك شاغرًا.
17
بعد عدة أيامٍ من تعيينهما، نشرت كيم ثوربورن، عضوة
اللجنة من مدينة سبوكان الشرقية، مقالًا افتتاحيًّا
تستنكِر فيه الادعاءات بأن بعض الممارسات المُثيرة للجدل
— الصيد بغرض جمْع التذكارات، والصيد بالفخاخ، واستخدام
الكلاب والطعم لصيد الدببة — غير أخلاقية.
18 كانت واحدة من المُفوَّضَين اللذَين صوَّتا
ضد حظر مسابقات القتل، رغم أنها كانت تُخالف الصورة
النمطية لمشجعي الصيد؛ بل إنها بدت النموذج المثالي
للمُستخدِم غير المُستهلِك للطبيعة، فهي طبيبة صحة عامة
متقاعدة ومراقبة طيور شغوفة كرَّست جهودها لاستعادة
أعداد طائر الطيهوج الحكيم، ولا تُمارس صيد الحيوانات
ولا الأسماك. لكنها استشهدت بالتفويض القانوني للجنة
بزيادة فرص الصيد الترفيهي للأسماك والحيوانات. وكتبت:
«لا يذكر تفويضي أي شيءٍ عن الصيد الأخلاقي.»
علاوة على ذلك، رأت أن الانتقادات جزء من حرب ثقافية
يشعلها أصحاب الأيديولوجيات الذين يستهدفون إلغاء الصيد.
أصرَّت لورنا سميث، وهي صيادة مُعتزلة، وفريد كونتز على
أن تلك ليست نواياهما، لكن لهجة الحرب الثقافية كانت
مواتية، وسرعان ما وجد كونتز نفسه في مرمى
النيران.
في وقتٍ لاحق من ذلك العام، ترأس هو وباربرا بيكر،
المفوضة صاحبة توجُّه المعاملة بالمِثل الثالثة في
اللجنة، لجنة لصياغة دليل مشترك بين الإدارات للحفاظ على
البيئة.
19 عرفت اللجنة هذا الدليل بأنه «إجراءات
تستنِد إلى العلم للحفاظ على سلامة البيئات الطبيعية
ومرونتها، وحماية القيم الجوهرية للطبيعة غير البشرية،
وتوفير منافع عادلة للأجيال الحالية والمُستقبلية من
البشر والأنواع الأخرى»؛ وهو بيان نبيل كُتِب بمصطلحات
مُنمَّقة متخصِّصة وبلُغة محايدة، وتبعه على الفور تأكيد
على أن الحفاظ على البيئة هو أساس صيد الحيوانات
والأسماك. لكنه أثار عاصفة من الجدل. في مقالٍ نشرته
مجلة «نورثويست سبورتسمان» عن رد الفعل العنيف الذي أعقب
البيان، وصف عالم أحياء لم يُذكَر اسمه من الإدارة هذا
البيان بأنه «نثر مدفوع بأجندة تخريبية لتغيير النموذج
السائد.»
20 وندَّدت ماري نيوميلر، المديرة التنفيذية
لمجموعة للحفاظ على البيئة مُهتمة بالصيد تُسمَّى مجلس
الحياة البرية في شمال غرب الأراضي الداخلية، بلهجة
«نحن» و«هم» التي تجسد مبدأً للحفاظ على البيئة عفَّى
عليه الزمن.
21
قالت مخاطبة اللجنة: «نحن جزء من الطبيعة؛ لذلك نحتاج
إلى أن نكفَّ عن فصل البشر عن الطبيعة وسياسات الحفاظ
عليها.»
22 كانت لحظة سريالية؛ استحضار مفهوم استُخدم
في الأصل لتوسيع منظور الحفاظ على البيئة — الكف عن تبني
تصوُّرات رومانسية لجمال الطبيعة البكر، وتقدير الطبيعة
التي نعيش ونعمل فيها — للتنديد بتهديدٍ مُتخيَّل
للصيد.
23 قال لي كونتز: «أعرف أن البشر جزءٌ من
الطبيعة. لكنهم لا ينبغي أن يكونوا مركزها
بالضرورة.»
كل ذلك كان تمهيدًا للتصويت على موضوع مُثير للجدل،
وهو صيد الدببة السوداء في فصل الربيع. أوصى علماء
الأحياء في الإدارة باستمرار الصيد خلال ذلك الموسم،
الذي يُمثل عدد الدببة التي تصاد فيه ما بين ٥ و١٠
بالمائة من عدد الدببة التي يقتُلها الصيادون كل
عام؛
24 وعلى إثر ذلك أمطر سكان واشنطن المُعترضون
الإدارة بالتعليقات. إذ رأوا أنه ليس من الإنصاف قتل
دبٍّ خرج لتوِّه من البيات الشتوي، جائعًا وضعيفًا، وأن
فُرَص قتل الدببة الأُمهات وتيتيم أبنائها كانت عالية
جدًّا. أما مؤيدو الصيد فاستشهدوا بكلام العلماء الذين
قالوا إن الصيد لا يُمثل أي خطرٍ على أعداد الدببة. كما
أنه سيمنع تلَف أخشاب الشجر — ففي بداية الربيع، تُجرِّد
الدببة الأشجار من اللحاء وتأكل خشب النُّسغ الغني
بالسكَّر تحته — وغير ذلك من الصراعات المُحتملة.
انتقد كونتز أيضًا الأساليب التي يستخدِمها علماء
الأحياء في الإدارة لتقدير كثافة أعداد الدببة وحساب
حِصص الصيد، وإن لم يكن ذلك هو جوهر الخلاف. وقال:
«الأمر يتعلق بالقِيَم. إذا كان غرض الصيد هو الترفيه،
فإن غالبية سكان واشنطن يرفضونه.» وحتى لو لم يكن الغرَض
هو الترفيه فحسب، فهل تُعَد حماية أرباح شركات الأخشاب
سببًا وجيهًا لقتل الدببة؟ قد يتعاطف الناس مع مُورِّد
محلي صغير إذا خسر أشجارًا، ولكن ألا يُمكن لشركات تبلُغ
قيمتها مليارات الدولارات تقبُّل شهية بضع مئات مِن
الدببة السوداء باعتباره تكلفة ممارسة الأعمال التجارية
في الطبيعة؟
العديد من الصيادين لا يفضلون صيد الدببة السوداء في
موسم الربيع أيضًا، ولكن كل طرفٍ كان مضطرًّا لأن ينحاز
لأحد المُعسكرَين. يتذكَّر كونتز أن صيادًا بارزًا أخبره
على انفراد بمعارضته للصيد في الربيع، ومع ذلك فقد صوَّت
أمام اللجنة لصالح السماح به. كان الصيادون يخشَون من أن
يكون منع الصيد في موسم الربيع منزلقًا يُفضي في نهاية
المطاف إلى حظرٍ كامل للصيد. لكن في رأي كونتز، كانت هذه
المخاوف غير واقعية؛ إذ إن الدعم الشعبي الهائل للصيد من
أجل الأغراض المعيشية يحُول دون ذلك. ومع ذلك، فقد عبَّر
الصيادون عن تلك المخاوف مرارًا وتكرارًا خلال النقاشات
المُتعلقة بصيد الدببة، وتكرر كذلك اتهام معارضة الصيد
بأنها مُعادية للعلم.
قال أحد المفوضين، وهو عالم أحياء مُتخصص في الحياة
البرية سابق ومدير ملجأ للحياة البرية: «لا أعتقد أن
المخاوف بشأن أعداد الدببة المُستقرة بالفعل وجيهة من
الناحية العلمية.»
25 وقالت مجلة «نورثويست سبورتسمان» إن «رد
الفعل الشعبي العنيف يستند في أغلبه إلى العواطف»؛ إذ
يقول علماء الأحياء إن الصيد «لا يشكل أيَّ خطورةٍ على
أعداد الدببة.»
26 إذن، فإن معاملة الدببة على أنها أشياء يمكن
قتلها من أجل المتعة، أو باعتبارها وحداتٍ من الموارد
وليست أفرادًا، يُعَد موقفًا علميًّا، أما العكس فهو
مخالف للعلم. وهذا منطق مغلوط؛ فكِلا الموقفَين
قِيَمِيَّان وليسا علمِيَّيْن. طبَّق علماء الأحياء في
الإدارة العلم على مسألة أفضل طريقة لإجراء الصيد، ولكن
ما إذا كان يجب إجراء الصيد في المقام الأول لم يكن
قرارًا علميًّا.
إذا كان النقاش يستند إلى العلم فعلًا، فحريٌّ به أن
يضع في الاعتبار الآثار الأخلاقية للأبحاث حول ذكاء
الدببة السوداء. وهو نوع لم يخضع للدراسة المُكثفة مثل
الشمبانزي أو الدلافين، ولكن توجد دراسات — بالإضافة إلى
كمية هائلة من الأدلة السردية — تشير إلى أن ذكاءه مُعقد
بقدْر مُماثل. فالدببة السوداء تتمتع بمهارة استثنائية
في حلِّ المشكلات،
27 ونظام تواصل يُشبه اللغة،
28 ومجتمعات أمومية مُعقدة.
29 وتشير الأدلة إلى أن الدببة تتبادل الخدمات
على مدى سنين؛
30 إذ يتشارك الأفراد الفاكهة والمكسرات من
مناطقهم الخاصة مع أفرادٍ آخرين مقابل أن يتلقَّوا منهم
المساعدة في المواسم العجاف. لا يستطيع العلم أن يجزم
بأن ذلك الذكاء يستحق اعتبارًا أخلاقيًّا أكبر، لكن
بإمكانه أن يكون أساسًا للنقاش، وتلك جوانب عادة لا
تؤخَذ في الاعتبار في مداولات وكالات الحياة البرية
الحكومية.
وصلت اللجنة إلى طريقٍ مسدود؛ إذ كانت نتيجة التصويت ٤
أصوات مقابل ٤؛ وبسبب بندٍ في لوائح الإدارة، أدَّت تلك
النتيجة إلى إلغاء صيد الربيع تمامًا. ساد الغضب. أثار
قرار الإلغاء ضجةً إعلامية وطنية. نُشر مقال في مجلة
«أوتدور لايف» بعنوان «إلغاء صيد الدببة في الربيع في
ولاية واشنطن بالتجاوز السياسي؛ وما تلك إلَّا البداية»،
ندَّد ﺑ «إساءة استخدام السلطة» و«التحيُّز للمناطق
الحضرية، المُتمثل في جهود مكافحة الصيد التي تشهدها
جميع الولايات، بما فيها ولايتك.»
31
من الواضح أن الخلافات لم تكن مقتصرةً على صيد الدببة
في فصل الربيع. إذ أصابت وترًا حساسًا لدى ثقافة فرعية
شعرت بأنها مضطهدة وأُسِيءَ فهمُها، وأثارت تساؤلاتٍ
شائكة عن طبيعة صنع القرارات الجماعية في بلدٍ ديمقراطي
ليبرالي. ما التوازن الصحيح بين حُكم الأغلبية وحقوق
الأقليات؟ متى يكون مِن المناسب فرض قِيَم سكان منطقةٍ
ما على سكان منطقةٍ أخرى؟ بالطبع لم يكن الانقسام واضحًا
إلى تلك الدرجة؛ إذ عارض بعض الأشخاص في شرق وريف واشنطن
الصيد تمامًا، في حين أيَّده بعض سكان المدن. لكن هذا
التفاوُت في الآراء سرعان ما طُمِس في خِضمِّ النقاش
الشعبي.
يسهل القول إن رأي الأغلبية، لا سيما عندما تكون تلك
الأغلبية ساحقة — أشارت استطلاعات الرأي إلى أن ٨٠
بالمائة من سكان واشنطن يُعارضون صيد الدببة في
الربيع
32 — يجب أن يسود، وهو صحيح نظريًّا. لكن في
الواقع، كان ذلك يعني سحب السلطة من جماعةٍ كانت تتمتَّع
بها في السابق، وفرض سلطة جماعة أخرى عليها. ورغم أن ٤
بالمائة فقط من سكان واشنطن مُعرَّفون بأنهم صيادون،
وعددًا أقل من ذلك بكثير معرَّفون بأنهم صيادو دببة، فإن
شعور أولئك الصيادين بالمظلومية تردَّد صداه خارج ذلك
المجتمع. ولا يتضمَّن نموذج أمريكا الشمالية للحفاظ على
الحياة البرية توجيهات مُفيدة بشأن كيفية تهدئة هذه
الخلافات المضطربة.
ورغم ضراوة معركة صيد الدِّببة في الربيع، سرعان ما
طغت عليها المعركة حول قطيع أيائل بلو ماونتن، الذي
يُعَد واحدًا من ضمن عشرة قُطعان في الولاية، وانخفض
تعداده إلى ٣٦٠٠ حيوان. كان هذا أقلَّ عددٍ سُجِّل منذ
عام ١٩٩١، وهو أدنى بكثيرٍ من العدد الذي تستهدفه
الإدارة، البالِغ ٥٥٠٠. وجدت الأبحاث التي أجرتها
الإدارة أنه لا يصمد من كل عشرة صغارٍ خلال أول صيفٍ في
حياتها إلا واحد فقط.
33 ربما يكون من العوامل التي تساهم في ذلك
برودة الطقس القارسة ونقص التغذية، إضافة إلى افتراس
الذئاب والدِّببة لها، لكن العامل الأهم والأكبر كان
أسود الجبال؛ إذ كانت تفترِس أكثر من ٤٠ بالمائة من
أعداد جميع الصغار التي أُحصيت. اقترح علماء الأحياء
التابعون للإدارة إعدام أسود الجبال للمساعدة في زيادة
أعداد القطيع.
عارض فريد كونتز ولورنا سميث هذا الاقتراح. واقترح
كونتز أن عدد الأيائل المُستهدَف البالغ ٥٥٠٠ قد يكون
مرتفعًا للغاية، ويعكس تقديراتٍ وُضعت في وقتٍ كانت فيه
أعداد الحيوانات المفترسة تكاد تكون معدومة، وأعداد
الموائل أكبر في الولاية. قال كونتز: «في هذه الحالة، قد
يكون العدد المقبول اجتماعيًّا أعلى من العدد الذي يسمح
به النظام البيئي.»
34 لكن اقتراحه لم يلقَ استحسانًا. ففي اجتماع
للجنة عبر تطبيق «زووم»، عبَّر الصيادون واحدًا تلوَ
الآخر عن شعورهم بعدم احترامه لهم. وقال أحد المسئولين
القَبَليِّين عن إدارة الحياة البرية إن كونتز يستغل
الأفضلية التي يمنحها إيَّاه كونه رجلًا أبيض.
35 كما وصف مُضيف برنامج إذاعي شهير يذاع على
الهواء مباشرة على قناة «إي إس بي إن» اقتراحه بأنه
«أغبى تصريح سمعتُ مفوضًا يُدلي به على مدار ٣٠
عامًا».
36
كان رد الفعل العنيف مشوبًا بمسحةٍ من الكراهية
للحيوانات المفترسة ومُحمَّلًا بالخلافات الثقافية. قال
الإذاعي ذو التوجُّه الليبرتاري دوري مونسون، تنديدًا
بتدخُّل «الليبراليين العاطفيين» في إدارة الأسماك
والحياة البرية: «بإنقاذ أسد جبال واحد، فإنك تكون قد
حكمتَ على الأيائل والغزلان الجميلة بخسارة حياة
إحداها.»
37 وظهرت الاتهامات بمعاداة العِلم مجددًا، رغم
أن الخلاف هنا أيضًا كان خلافًا قِيَمِيًّا. هل يجب
إدارة المناطق الطبيعية على نحوٍ يؤدي إلى زيادة أعداد
الأيائل إلى أقصى حدٍّ أم على نحو يُعزز العلاقات
البيئية التي تُشكل آكلات اللحوم الكبيرة جزءًا طبيعيًّا
منها، ويكون فيه لأسود الجبال الحق في الأيائل بقدْر ما
للبشر حق فيها؟
أخبرني كونتز عن الأبحاث التي تناولت الحيوانات التي
استفادت من جِيَف الأيائل التي تُخلِّفها أسود الجبال.
كانت مئات الأنواع تعتمد، بطريق مباشر
38 أو غير مباشر،
39 على توزيع الجِيَف على امتداد المساحة
الطبيعية. لكن الصيادين كانوا يرَون أنهم يعتمدون أيضًا
على الأيائل؛ وعلى الرغم من أن بعض الأيائل التي
يَصيدونها سينتهي بها المطاف معلقةً على الجدران، فإنها
لا تُعَد حيوانًا يصاد من أجل الترفيه. لم يكن هؤلاء
الصيادون في هذه الحالة أقليةً تبحث عن مُبررات لقتل
الدببة. إذ يصطاد الناس الأيائل لأكلها، كما أن عدد
المُتقدمين للحصول على تصريح بصيد الأيائل يفوق بكثيرٍ
عدد الذين يحصلون على هذا التصريح. كان علماء الأحياء قد
اقترحوا بالفعل خفض عدد الأيائل المصرَّح بصيدها، ووافق
الصيادون على ذلك، لكنه لم يكن حلًّا مُجديًا. فلماذا
يجب أن يكون لأسود الجبال الأولوية عليهم؟ كما أن
المساحات الطبيعية التي تحتوي على عددٍ أقل من الحيوانات
المفترسة والمزيد من الفرائس تظلُّ مكانًا بديعًا.
والطبيعة تُهِمُّهم بقدْر ما تُهِمُّ نشطاء الحفاظ على
البيئة في المدن الكبرى، كما أنهم ساهموا في دفع تكاليف
إدارة هذه الأراضي، ورغم كل هذا يأتي رجلٌ ما من سياتل
ويعِظهم عن القُدرة الاستيعابية الاجتماعية.
في الظروف المثالية، كانت تلك المحادثة صعبة، غير أن
الظروف لم تكن مثالية. كان لتلك الانتقادات تأثير سلبي
على كونتز. هو رجل ودود المُحيَّا أشيب الشعر، يرتدي
عادة بنطالًا رسميًّا وقميصًا من الفلانيل، إنه ذلك
النوع من الأشخاص الذي تتوقَّع أن تُصادفه في نزهة مشيٍ
يوم الأحد في الأراضي التي يُديرها صندوق الأراضي
المحلي؛ من ثَم فقد أثارت قلقَه المحادثات التي جرت عبر
الإنترنت، والتي تقترح شنق المُفوضين الذين صوَّتوا ضد
الصيد وتسأل عن محلِّ سكنه. قال لي: «لا أظن أنهم يقصدون
تلك التهديدات فعليًّا، لكن يظلُّ احتمال أنهم يقصدونها
قائمًا.» ذات يومٍ نظر من النافذة فرأى شاحنة صغيرة
مُتوقفة في ممرِّ منزله وبداخلها رجل. كان ذلك يفوق
طاقته على الاحتمال. وقبل أيامٍ قليلة من عيد الميلاد
المجيد، استقال من منصبه. كتب في استقالته: «لقد فقدْنا
إلى حدٍّ كبير القدرةَ على إجراء محادثات جماهيرية
حضارية. آمُل أن يكون المُعيَّنون المستقبليون في اللجنة
سياسيين أفضلَ منِّي، فأنا في نهاية المطاف لستُ إلَّا
عالم أحياء مُتخصِّصًا في الحفاظ على البيئة.»
40
يعمل كونتز الآن خلف الكواليس؛ إذ يقدم الاستشارات
للإدارة فيما يخصُّ التركيز على نقاش التنوع البيولوجي.
يتخيَّل أحيانًا ماذا يمكن أن يحدُث لو أن إدارة الحياة
البرية في الولايات المتحدة ركزت أدواتها وآلياتها
الهائلة على التنوُّع البيولوجي بقدْر ما تركزها على
موارد الحياة البرية. لكنه قال لي إن الأمر قد لا
يستحقُّ عناء المحاربة من أجلِه. فقد تؤدي محاولات
الإصلاح إلى تفاقُم الأمور؛ إذ يمكن أن تؤدي إلى تحوُّل
إدارة الحياة البرية إلى حربٍ ثقافية شاملة، تكون ضحيتها
في النهاية الحيوانات.
أو ربما كان مِن الحتمي حدوث هذا التوتر، وأن تؤدي هذه
السلسلة من المشكلات المُتفاقمة بعد سنوات من الآن، وبعد
الكثير من الحلول الوسط والنقاشات الصعبة، إلى توازُن
جديد عادل بين وجهتَي النظر اللتين تظلَّان متعارضتَين
في الوقت الحالي. في ربيع عام ٢٠٢٣، صوتت اللجنة لصالح
وقف صيد الدببة في الربيع،
41 ووافقت الهيئة التشريعية في واشنطن على
تخصيص ميزانيةٍ قدرها ٢٣ مليون دولار لجهود إدارة
الأسماك والحياة البرية فيما يخصُّ التنوُّع البيولوجي
لغير الطرائد،
42 وهو ما يُكافئ ثلاثة أضعاف الميزانية التي
كانت مُخصَّصة لها من قبل. التغيير ليس سهلًا ولا يمكن
التنبُّؤ به، لكن كونتز متفائل.
•••
حتى الآن، كان تركيزنا منصبًّا على ما لا ينبغي أن
تكون عليه إدارة الحياة البرية؛ على أنه لا ينبغي للناس
إقامة مُسابقات للصيد، ولا ينبغي لهم قتل الدببة بغرَض
الترفيه، ومنح الأولوية للأيائل على حساب أسود الجبل.
لكن ماذا عن التصوُّر الإيجابي للشكل الذي يمكن أن تكون
عليه إدارة الحياة البرية؟
للإجابة عن هذا السؤال، يمكن للمرء أن يُسافر بضع
مئاتٍ من الأميال شمالًا إلى مجتمعات السكَّان الأصليين
في الساحل الأوسط لمقاطعة كولومبيا البريطانية. حيث عاش
أسلافهم لمدة ١٤٠٠٠ عام على الأقل قبل وصول المُستكشفين
الأوروبيين إلى المنطقة في أواخر القرن الثامن
عشر،
43 ويرجع تاريخهم الشفوي إلى الزمن الذي كشفت
فيه الأنهار الجليدية المتراجعة عن السواحل الجبلية
ووديان الأنهار الواسعة لما هو الآن غابة مَطيرة
مُعتدلة. على مدى آلاف السنين، طوَّروا أنظمة لإدارة
عمليات الصيد والحصاد، ووضعوا كذلك القِيَم التي
يحتكِمون لها. ينبغي أن ننظر إلى القِيَم أيضًا
باعتبارها ابتكارات، صقلتها الخبرة وطوَّرتها بحيث تسمح
للبشر والطبيعة من حولهم بالازدهار.
تلك الأنظمة مُنبثقة من مجموعة من القِيَم. أبرزها
الشعور بالارتباط بالكائنات غير البشرية. مثل أسلاف كاثي
بولارد ومارجريت روبنسون في الشمال الشرقي، تحكي شعوب
الساحل عن وقتٍ كانت فيه الحيوانات قادرة على التحوُّل
إلى بشَر والبشر إلى حيوانات؛
44 يسهل اعتبار تلك الحكايات مجرد أساطير،
لكنها تظلُّ تحمل مَغزى التواصل. كانت العلاقات بين
البشر والمخلوقات الأخرى قائمة على أخلاقيات المُعاملة
بالمِثل، والكرم المبذول الذي يُرد من خلال دائرة من
تعامُلات تبادل المصالح المؤدية لازدهار جميع الأطراف.
تقول إحدى الحقائق الجوهرية الواردة في كتاب «الثبات على
الطريق، البقاء على قيد الحياة»، الذي يضم مجموعة من
التعاليم جُمعت من مُقابلات مع شيوخ قبائل هايلستوك
وكواكواكواك وهايدا: «كلنا واحد وحياتنا مُترابطة. كل
الحيوات متساوية في القيمة. نحن نُقِر ونحترم أن جميع
النباتات والحيوانات لديها قوة الحياة.»
45
اعتقدت الأُمَم الأولى الساحلية أن استغلال هذه
المخلوقات ينطوي على مسئولية الحفاظ عليها،
46 وهو ما يُشبه تعاليم إدارة الحياة البرية
المُعاصرة، ولكن ثَمَّة اختلافًا جوهريًّا. هذا الاختلاف
هو أنهم كانوا يعتبرون هذه المخلوقات التي ينبغي الحفاظ
عليها أقاربهم؛ ولم يعتبروها ملكيةً خاصة بهم، بل كانوا
يرَون الحصاد هدية، ويعتبرون أن المخلوقات التي لم
يُقدِّروا كرمها حق قدْرِه ستُعاقبهم على جشعهم وعدم
احترامهم.
47 على أي حال، فإن هذه القيم والدروس
المُستفادة من تطبيقها أدَّت إلى خلق عالمٍ طبيعي تسوده
وفرةٌ يصعب تصوُّرها اليوم.
عندما جاء المُستعمرون، تعاملوا مع الأراضي والمياه
التي طالما اعتنى بها السكان الأصليون بمحبة، على أنها
مُستودع ينهبون منه ما شاءوا. فقضَوا على ثعالب الماء.
وقطعوا أشجار الأرز والتنوب والصنوبر التي يبلغ عمرها
آلاف السنين. وقتلوا الحيتان. وفي موجة من النهب
استمرَّت قرونًا، قضَوا على حيوانات أذن البحر (من
الرخويات)، وأسماك القد والهلبوت، وقنافذ البحر، وأسماك
الشمع والرنجة والسلمون. في أوائل القرن العشرين، حظرت
الحكومة الكندية أساليب الصيد التقليدية:
48 السدود وأقفاص صيد الأسماك التي استخدمتها
الأمم الأولى للصيد الانتقائي، والتي سمحت لأكبر الأسماك
حجمًا وأصحِّها بأن تُحرِّر نفسها، مما يُثري مجتمع
الأسماك، والعِصي المربوطة بعشب البحر التي تضع عليها
أسماك الرنجة بيضها، التي سمحت للناس بجمعه دون أن
يَصيدوها؛ جاء ذلك الحظر لحماية مصائد الأسماك التجارية
التي أنشئوها حديثًا. هذه المصائد التجارية، إلى جانب
بناء السدود والتعدين وقطع الأشجار، دمَّرت الجداول التي
تتكاثر فيها الأسماك، وكادت تقضي على الأسماك التي كانت
وفرتُها عاملًا جوهريًّا في الثقافات الساحلية.
لم تخلق تلك المُمارسات مشكلةً مادية فحسب، بل أدَّت
إلى إعادة هيكلة جوهرية؛ إلى تجريد الحياة اليومية من
مضمونها وتدهورها. كانت جزءًا من سياسة أوسع ترقى إلى
وصف الإبادة الجماعية،
49 ولا تنفصم عن تهجير الأمم الأولى من أوطانها
وإرسال أطفالها قسرًا إلى المدارس الداخلية حيث كانت
لُغاتهم محظورة، وكان الاعتداء الجنسي مُتفشيًا، وغالبًا
ما كان يُدفن أولئك الذين ماتوا من أمراضٍ يمكن الوقاية
منها في قبورٍ مجهولة. عندما بدأ أبناء الأمم الأولى
فترةً من النهضة الثقافية والسياسية في أوائل القرن
الحادي والعشرين، وحصلوا على اعترافٍ رسمي بهذه المظالم،
وأكدوا حقوقهم في الحُكم الذاتي، استعادوا أيضًا إدارة
الحياة البرية.
احتلَّت الدببة الرمادية مكانةً بارزة في ثقافة الأمم
الأولى. فلطالما شعر أبناء الأمم الأولى الساحلية
بقرابتهم لجميع الحيوانات، لكنهم شعروا بقرابةٍ خاصة مع
الدببة الرمادية. كانوا يعتبرونها أقارب ومُعلمين
مُقربين،
50 «تتطلَّب الاحترام وتغرس في نفوسهم حسًّا
بالمسئولية تجاهها يُشبه ما يشعر به أبناء الثقافات
المُستوطنة تجاه أقاربهم من البشر»،
51 كما كتب باحثون في وصفِهم لبرنامج مراقبة
الدببة الرمادية الذي دشَّنه شعب الهيلتسوك في عام ٢٠٠٦.
من الدببة، تعلم أسلافهم تسميد شُجيرات التوت المَحبوبة
بجِيَف أسماك السلمون،
52 وفرك جروحهم بصمغ الصنوبر،
53 وأكل جذور ملفوف الظربان للتخلُّص من
الطفيليات المعوية.
54
كانت هذه القرابة مع الدببة، لا سيما الدببة الرمادية،
شِبه سائدة بين البشر الذين شاركوها مساحاتها، وهو ما
لاحظه العديد من علماء الأنثروبولوجيا، ولكن دراسة أسماء
النباتات توضِّحه بشكلٍ أكثر شاعرية. تحتوي اللغات
الأوراسية على أكثر من ١٢٠٠ اسم للنبات مُشتقة من
الدببة:
55 توت الدب، ثوم الدب، ملفوف الدب … إلخ. من
الواضح أن بعض تلك النباتات اكتسب اسمه من التشابُه بينه
وبين الدببة، لكن كثيرًا منها نُسِب اسمه إلى الدببة لأن
الدببة عرَّفت الناس بها. تقول جينيفر والكوس إن أبناء
الأمم الأولى الساحلية كانوا يتحدثون إلى الدببة
الرمادية مُتوقِّعين أن تفهم كلامهم.
كشف تحليل حديث لبِنية مجموعات الدببة عن وجود ثلاث
مجموعات فريدة وراثيًّا، يكاد يتطابق توزيعها الجغرافي
مع التوزيع الجغرافي لعائلات اللُّغات الأصلية الثلاث في
المنطقة.
56 سبب ذلك غير معلوم بالضبط، ولكن التفسير
الأرجح هو الاعتماد المُشترك على موارد المياه ومصادر
الغذاء. أيًّا كان السبب، فذلك دليل قوي على الصِّلة
الوثيقة التي ربطت بين البشر والدببة. وعلى الرغم من أن
الخراب الذي أتى به الاستعمار أدى إلى اندثار العديد من
التقاليد، إذ انمحت الحكايات والممارسات بموت أولئك
الذين يتذكَّرونها، أو ضمرت بسبب قلَّة ممارستها، فقد
ظلت مشاعر القرابة تجاه الدببة الرمادية باقية.
كان الصيد شائعًا في هذه المجتمعات، لكن صيد الدببة
الرمادية كان محظورًا. لذا كان من المُحزن لهم أن يرَوا
الدببة الرمادية تُصاد لتكون تذكارات داخل أوطانهم بدعمٍ
كامل من الحكومة، وتُكَوَّم جُثثها وقد سُلِخ جلدُها
وقُطع رأسها وكفوفها،
57 واعتبروا ذلك انتهاكًا تُقرُّه الدولة. في
عام ٢٠١٢، اتحدت الأمم الأولى في الساحل الأوسط للوقوف
ضد الصيد التذكاري للدببة الرمادية.
58 وأعلنت أنه بموجب قانون السكان الأصليين
يُعَد الصيد التذكاري محظورًا، وإن لم يحظره القانون
الكندي بعد، وفي عام ٢٠١٧ أقرَّت حكومة كولومبيا
البريطانية ذلك الحظر.
59 كما تعاونت مع مؤسسة «رينكوست كونسرفيشن»
لشراء حقوق الصيد التجارية داخل منطقة الساحل
الأوسط
60 — مما أدى إلى إنهاء الصيد التذكاري لأنواع
أخرى أيضًا — ولإجراء أبحاثها العلمية الخاصة على الدببة
الرمادية.
بدأت هذه الجهود قبل سنوات، وقادها في البداية شعب
الهيلتسوك، الذي استعان بباحثين من مؤسسة رينكوست
للمساعدة في إجراء تحليل ديموجرافي للدببة في وادي كويه،
وهو موطن الهيلتسوك. كتب الباحثون بقيادة مدير موارد شعب
الهيلتسوك ويليام هوستي أنهم يريدون اكتساب هذه المعرفة،
ليس بغرَض استغلال الدببة إنما بغرَض الحفاظ
عليها.
61 وأصر الهيلتسوك على أن يُعامِل العلماء
الدببة باحترام. فمنعوهم من استخدام الأطواق اللاسلكية
لتتبُّع تحركاتها؛
62 فكيف ستشعر لو أنك أُفقِدتَ وعيك ثم أفقت
لتجدَ طوقًا معدنيًّا ثقيلًا يُحيط برقبتك؟ كما لم يُسمح
للباحثين بنزع أسنانها،
63 وهي طريقة معتادة لتقييم العمر. بدلًا من
ذلك، سيعتمدون على الكاميرات المُثبتة في المسارات،
والأوتاد المُصمَّمة لجمع عينات الفراء (أوتاد تُنْصَب
ويُمَد بينها سلك ويوضع داخلها طُعم، عندما يدخل الدب
لأخذ الطُّعم تعلق خصلةٌ من فروه في السلك دون الإضرار
به)، والمراقبة الميدانية. كما سيأخُذ العلماء على محمل
الجد الأشخاص الذين طالما تجاهل علماء الأحياء الحكوميون
معرفتهم وقِيَمهم. وسيتعاملون مع الدببة باعتبارها
أندادًا للبشر.
وقد أدى هذا البحث في النهاية إلى فهمٍ دقيق لأماكن
عيش الدببة الرمادية في وطنها التقليدي. كان شعب
الهيلتسوك يتحكم في جزء فقط من هذه المنطقة؛ بينما كان
جزء كبير منها يقع داخل ما يُسمى بأراضي التاج الكندي،
التي تملكها وتُديرها الحكومة الكندية بالتشاور مع شعب
الهيلتسوك، وتُستخدَم في الاحتطاب التجاري. داخل هذه
الأراضي، يُحظَر قطع الأشجار في جزءٍ فقط من موطن
الدببة، وبفضل ذلك البحث صار لدى الهيلتسوك بيانات كافية
للضغط من أجل زيادة تلك المساحة. في المساحة التي
تتداخَل فيها أنشطة الاحتطاب مع موطن الدببة، يُحظَر قطع
الأشجار في مواقع عرائنها والمنطقة المُحيطة بها، ويشمل
ذلك الحظر أيضًا عرائن الدببة السوداء.
64 فبدلًا من الدعوة لقتلِها بسبب أكلها لحاء
الأشجار، كما اقترح مسئولو إدارة الحياة البرية في
واشنطن، رحَّب الهيلتسوك بوجودها.
كما أقامت أُمم أصلية أخرى في منطقة الساحل الأوسط
مشاريعها الخاصة بالدببة. فقد شكَّلت أُمة نوكسالك، التي
كان موطنها في وادي بيلا كولا بؤرة صراع بين الدببة
والبشر أثناء مواسم تكاثُر سمك السلمون في الربيع
والخريف، مجموعة نوكسالك لسلامة الدببة.
65 يساعد أعضاؤها في تركيب أسيجة كهربائية
وأجهزة استشعار للحركة وأضواء كاشفة حول أشجار الفاكهة
وأكوام السماد العضوي ومعامل تدخين اللحوم والأسماك التي
تنجذِب إليها الدببة فتتورَّط في مشكلات، كما يُراقبون
مواقع الدببة ويُذيعونها يوميًّا عبر الإذاعة ووسائل
التواصُل الاجتماعي، حتى يعرف الناس الأماكن التي
يحتاجون لتوخِّي الحذَر الزائد فيها. وعندما يُبلغ الناس
عن اقتراب دبٍّ مسافةً أكبر من اللازم، يحضر عمال سلامة
الدببة في شاحنات مزوَّدة بمكبِّرات صوت وأضواء وامضة
للمساعدة في إبعاد الدب. إذا لم يبرح الدب مكانه، فإنهم
يبقون لتحذير الناس وإبعادهم عن الموقع. تلك الممارسات
هي النقيض التام لحلِّ قتْل الدببة من أجل تقليل
الصراع.
ركزت أُمة كيتاسو هاي هاي، التي تعيش في شمال الساحل،
على إنشاء السياحة البيئية في منطقتهم.
66 يُعَد نزل «سبيريت بير» — الذي سُمِّي على
اسم نوعٍ نادر من الدببة السوداء ذات الفراء الأبيض التي
تعيش في المنطقة — ثاني أكبر جهة توظيف في
بلدتهم.
67 بينما قرَّرت أُمة ويكينو، التي شهدت بنفسها
الحرمان الذي تعرضت له الدببة نتيجة انخفاض أعداد سمك
السلمون، البحث عن الطريقة المُثلى لتُشارك سمك السلمون
مع الدببة الرمادية.
•••
قبل أن تتقلَّص أعداد السلمون في هجراته الساحلية، كان
يمر في النهر القصير الذي يفصل مصبَّ خليج ريفيرز إنلت
الموحِل عن بحيرة ويكينو ما بين مليونين وستة ملايين من
سمك السلمون الأحمر يمرُّ كل صيفٍ حسبما تقول ميجان
آدامز. (يُنطق اسم البحيرة والأمة نطقًا واحدًا: وي كي
نو.) كانت تصِل إلى هناك بعد أن تقضي فترة بلوغها في
البحر، حيث تتغذَّى على العوالق الحيوانية والأسماك
الصغيرة، ثم تحمل غنيمتها من العناصر الغذائية إلى
الجداول التي فقست فيها بيضها، بعد أن تكون أجسامها
المُفضَّضة المَمشوقة قد تحولت إلى اللون القرمزي الداكن
كأنما تحتفي بهجرتها التي تبلُغ مسافتها آلاف الأميال،
والتي ستنتهي بوضعها للبيض ثم موتها.
كانت عائلات أُمة ويكينو تصيدها؛ وكانوا يدخنونها بعد
وضعها في أسياخٍ من خشب الأرز وتثبيتها فوق نار مشتعلة،
أو في أفاريز مداخن الأسماك، وهي عمليات كانت تستغرِق
أيامًا، وتُزوِّد المجتمع بما يكفي من الغذاء للعام
المُقبل. كان سمك السلمون عنصرًا جوهريًّا في حياتهم،
وكذلك في حياة الدببة الرمادية التي كانت تتجمَّع حول
الأنهار والجداول التسعة التي يمر بها سمك السلمون،
والتي تصب في بحيرة ويكينو، وتأكل الأسماك التي تدعم
أجسامها خلال البيات الشتوي، وتُزوِّد الحليب الذي ترضع
به صغارها بالعناصر المُغذِّية.
ثم جاء الاستعمار؛ ذلك النهب الجامح للموارد الذي
سيحول هذا الفيض المانح للحياة إلى قطرة. بحلول مطلع
القرن العشرين، كان يوجَد أكثر من اثني عشر مصنعًا
كبيرًا للتعليب يعمل في خليج ريفرز إنلت حسبما تقول
ميجان آدامز. كانت تلك المصانع تعالج ملايين الأسماك
التي تُحصَد سنويًّا بواسطة مئات القوارب الصغيرة التي
تَستخدِم الشباك الخيشومية؛ كانت آلاتها البخارية
تستخدِم جذوع الأشجار المحلية وقودًا لها. أُغلق آخر
مصنع تعليب محلي في عام ١٩٥٧،
68 ليحلَّ محله الاحتطاب التجاري ومصائد سمك
السلمون الآلية الأحدث. بقِيَ عدد ضئيل من سمك السلمون
الأحمر لأُمة ويكينو؛ وتقول ميجان آدامز إن تعدادها قد
تقلَّص للغاية مقارنة بما قبل الاستعمار؛ لكنها لا تكاد
تكفي الدببة. وفي التسعينيات، ظهر التأثير الكامل
للخسائر التي تَسبَّب فيها الصيد وتدمير الموائل.
وانخفضت أعداد سمك السلمون انخفاضًا ساحقًا. وفي عام
١٩٩٩، بلغ عدد سمك السلمون الأحمر العائد عشرة آلاف فقط
كما أخبرتني ميجان آدامز.
لم يكن ذلك العدد كافيًا لأُمة ويكينو، فما بالك
بالدببة. جاعت الدببة. تقول جينيفر والكوس إن الدببة
كانت تتجوَّل في شوارع القرية بحثًا عن الطعام، يتهدَّل
فروُها من أجسامها الهزيلة، وتستند على النوافذ، بل
تقتحم المنازل. لم تعُد أُمهاتها تدافع عن صغارها. كان
ذلك وضعًا لم يشهده أحدُهم من قبل. وهم أناس مُعتادون
على التعايش مع الدببة؛ فلا يستغربون إذا مرُّوا بدبٍّ
في طريقهم إلى المدرسة، أو وجدوا دبًّا نائمًا تحت
شُرفتهم. لكن ما يحدث كان مُخيفًا ومفجعًا. أراد بعض
الناس إطعام الدببة. إذ اعتبروها ضحايا نظام معطوب،
مثلهم تمامًا بطريقةٍ ما؛ إذ أفقرها جشع الآخرين وقصر
نظرهم. لكن إطعامها كان يُهدد بخلق علاقة اعتمادية
مُتبادلة خطيرة، فاتخذ سكان القرية قرارًا مؤلمًا وهو
إعدامها رميًا بالرصاص.
وقعت تلك المُهمة على عاتق أمهر الصيادين في القرية.
لا يزال بعضهم يبكي حُزنًا على ما فعله حتى يومِنا هذا.
طلبوا المغفرة؛ كان ما فعلوه قتلًا رحيمًا، لكنه يظلُّ
قتلًا. كانوا يقتلون أقاربهم. تتذكَّر جينيفر والكوس
جدتها وهي تقول لها: «تحدَّثي إلى الدببة بلُغتنا؛ لأن
الدببة هي مَن علَّمتنا إيَّاها.» كانت جينيفر مديرة
مصائد الأسماك في ذلك الوقت، وقد وُلدت عام ١٩٧١، في خضم
أزمة انهيار أعداد السلمون، ولكن في وقتٍ مبكر بما يكفي
لأن ترى لمحةً مما كانت عليه الحياة قبل ذلك. تقول إنه
حتى قبل ذلك الصيف المريع، أدرك الناس أن الدببة باتت
أضعف مما كانت عليه من قبل، وأن صغارها كانت تولد أصغر
حجمًا مما كانت في الوقت الذي كانت الجداول تتحول إلى
اللون الأحمر في مواسم تكاثر سمك السلمون الأحمر، ولكن
ذلك الصيف تجلَّى المدى الكامل لمِحنتها حتى صار واقعًا
ملموسًا.
قالت لي: «لقد شهد الناس الذين كانوا يعيشون هنا آنذاك
كثيرًا من المُعاناة التي تعرضت لها تلك الدببة.» بدءوا
يبحثون عن طريقة لضمان حصول الدببة على ما يكفي من السمك
للبقاء على قيد الحياة. لدى أُمة ويكينو مفردة تُعبر عن
ذلك المعنى، وهي «ناناكيلا»، التي تحمل معنى التطلُّع
إلى الأمام، والعناية بشخصٍ ما.
69 هذه القيمة ستكون أساس الدراسة العلمية
لكيفية ضمان حصول الدببة الرمادية على طعامٍ وافر. وأبوا
أن يطلبوا المساعدة من علماء الحكومة؛ الحكومة نفسها
التي أيَّد علماء الأحياء التابعون لها الصيد التذكاري
لأقاربهم، وسمحوا لصناعة صيد الأسماك بإبادة سمك
السلمون، وتحويل موطنهم إلى موردٍ لصناعة الأخشاب؛
الحكومة التي استخفَّت بخبرتهم ومعرفتهم. قالت جينيفر
والكوس عن أصحاب المصانع: «هم أصحاب الصوت الأعلى. بينما
نحن الوحيدون الذين نتحدث نيابة عن الدببة والأسماك
والنسور.»
70
توجَّهت جينيفر إلى كريس داريمونت، المدير العلمي في
مؤسسة رينكوست، الذي كان من ضمن العلماء المتعاونين مع
أمة هيلتسوك. فأرسل لهم ميجان آدامز، وهي عالمة بيئة
شابة ذات توجُّهٍ مثالي تسعى للحصول على درجة الماجستير.
وستساعد ميجان آدامز جينيفر في البحث عن إجابات لأسئلتها
على أرض الواقع. كم عدد الدببة الرمادية التي تعيش في
وطنهم؟ ما الكمية التي تأكُلها الآن من السلمون؟ وما عدد
سمك السلمون الذي تحتاج إليه، وكيف يمكن أن يشمل حصادهم
من سمك السلمون احتياجات الدببة؟
كانت ميجان هي الشخص المِثالي لتلك المُهمة. إذ كان
رفض إرث الهيمنة الاستعمارية أمرًا مُهمًّا بالنسبة
إليها. كانت لا تزال تتذكَّر لوحةً عرضَها أحد الأساتذة
في أحد فصولها الجامعية، بعنوان «التقدُّم الأمريكي»،
وهي لوحة كثيرًا ما تُقلَّد، رسمها جون جاست عام ١٨٧٢
احتفاءً باعتقادٍ يُسمى «القدَر المُتجلي»، تصور «جميع
السكان الأصليين وحيوانات البيسون والذئاب يفرُّون مِن
مَلاك القدَر»؛ في الواقع تظهر في اللوحة كولومبيا،
التجسيد الملائكي لأمريكا، وهي تطفو غربًا فوق البراري،
«على إثرها يمتدُّ خط سكة حديد، وتجر وراءها أسلاك
الهاتف، ويتبعها في سلامٍ كل هؤلاء المهاجرين.» رأت
آدامز أن تلك اللوحة تمثل جوهر الاستعمار في كندا وكذلك
أمريكا. كان الاستعمار لا يزال محسوسًا في تحويل الطبيعة
إلى شيء، وإنكار أن الحيوانات والشعوب الأصلية على حدٍّ
سواء أشخاصًا مثل المستعمرين.
درست ميجان سمك السلمون في المرحلة الجامعية. وقد حولت
الآن انتباهها إلى الدببة، حيث نصبت أعمدةً لالتقاط
عيِّنات من الفراء في المواضع التي يُحتمل أن تحتكَّ بها
الدببة الرمادية، وحللت تركيب الفراء لتحديد عدد الدببة
الموجودة وكمية سمك السلمون التي تأكلها. بالنسبة إلى
بعضها، شكلت الأسماك ما يقرُب من ثُلثَي
غذائها.
71 بعد ذلك أدخلت البيانات وسجلات أمة ويكينو
لهجرات السلمون في نماذج أخبرتها بتأثير نِسَب الصيد
المختلفة على أعداد الدببة.
72
كانت هذه خطوة غير تقليدية. قد يظنُّ المرء أن قيود
الصيد المُستدام تضع في الاعتبار احتياجات المخلوقات
الأخرى، ولكن كريس داريمونت يقول إن هذا لا يحدُث في
أغلب الأحيان. إذ تحدد قيود الصيد المُستدام عادةً عدد
الأسماك التي يمكن للناس صيدها دون التسبب في انهيار
أعدادها؛ ونادرًا ما تؤخَذ المخلوقات الأخرى التي تعتمد
عليها أيضًا في الاعتبار. حتى ما يُسمَّى بنماذج مصائد
الأسماك القائمة على النظام البيئي، وهو ابتكار حديث
يهدف إلى إصلاح هذا العيب، غالبًا ما تُعطى الأولوية
للتفاعلات مع الأنواع الأخرى التي نُريد استهلاكها — إذا
كان عدد سمك السردين «س»، فسيكون عدد سمك التونة «ص» —
بدلًا من اعتبار احتياجات مجتمع الكائنات الحية
بأكمله.
استغرقت الدراسة مِن ميجان آدامز والفنيين الميدانيين
من أمة ويكينو والباحثين الآخرين الذين استشاروهم ما
يقرُب من عقدٍ من الزمان: قضوا آلاف الساعات يتجولون في
مناطق نائية، ويَعُدُّون سمك السلمون في الجداول،
ويُعالجون البيانات، وكل ذلك للوصول إلى مجرد
رقم.
73 وجدوا أنه إذا ظلَّت أعداد سمك السلمون على
ما هي عليه — يعود نحو مائتَي ألف سمكة سلمون حمراء الآن
كل عام — ولم يصطَد أبناء أمة ويكينو أكثر من خمسةٍ
وأربعين ألف سمكة، أي أقل بما يقرب من ١٠ بالمائة من
الحدِّ المُستدام المحسوب سابقًا، فستقل أعداد الدببة
الرمادية بنحو ١٠ بالمائة فقط مما لو لم يصطادوا أي سمكٍ
على الإطلاق.
74 بدا هذا توازنًا مُنصفًا.
ستأتي احتياجات الدببة أيضًا في المرتبة الأولى. تحدثت
مع جينيفر والكوس في الربيع، بعد فترةٍ وجيزة من ازدهار
أشجار توت السلمون، التي سُمِّيت كذلك بسبب لون توتِها
البرتقالي المائل للوردي الذي يُشبه لون السلمون، وقالت
لي إن المصائد ستظل مغلقة حتى يعبر ١٠٠ ألف من سمك
السلمون الأحمر محطة العد في القرية. عندها فقط يُتاح
الصيد لأبناء أمة ويكينو البالِغ عددهم عدة مئات. وقالت
لي أيضًا إنهم في الوقت الحالي، لا يصيدون إلَّا جزءًا
صغيرًا من الحد المحسوب حديثًا؛ إذ يظلُّون دون الحد
المسموح الذي يحافظ على استدامة أعداد السمك المهاجر
بكثير، وإن كانوا يأمُلون أن يأتي يوم يرتفع فيه هذا
العدد. ولكن حتى ذلك الحين، ستكون الأولوية للدببة،
يليها أبناء أُمة ويكينو، ولا يُحتمل أن يتبقى بعد ذلك
عدد كافٍ من السمك لدعم مصائد الأسماك التجارية. تقول
جينيفر: «هذه هي الحجة العلمية التي سنستخدِمها لمنع
الحكومة الفيدرالية من فتح مصائد الأسماك. فعدد السمك لا
يكفي لأن يُحافظ النظام على نفسه. عددها يكاد لا يكفي
لأن يتشاركها الناس والدببة. لكنها تظلُّ كافية.
فليتركوها وشأنها.»
قد يقول المرء إن جينيفر والكوس وأمة ويكينو يتَّسمون
بالكرم. لكن ميجان آدامز استخدمت هذه الكلمة أيضًا لوصف
سمك السلمون والرنجة. قالت لي: «لم أُصدق مدى كرم هذه
الأسماك وروعتها. هذه الأسماك الصغيرة، تُغادر النهر
بهذا الحجم»، وباعدت بين يدَيها مسافة بضع بوصات، «وتعود
إلى موطنها بهذا الحجم»، ثم زادت المسافة بين يدَيها إلى
أقصى مداها. «إنها تُخصِّب كل شيءٍ وتُطعم الجميع،
ببساطةٍ كل شيء يزدهر بعودة سمك السلمون. لدينا نوعان من
الأسماك في غاية الكرم، يزوروننا مرةً كل سنة. سمك
الرنجة موجود الآن، وسيليه السلمون. يأتي النوع الأول
بعد الشتاء مباشرة، والثاني قبل الشتاء مباشرة. ما تفعله
تلك الأسماك أشبه بالسحر. إنها تجلب البروتين والدهون،
وهي أشياء لم تكن موجودة قبل قدومها. تخرج إلى المحيط
المفتوح، وتُخزن في داخلها الكثير من الطاقة. ثم تعود
إلى الوطن وتترك مخزونها من الطاقة هنا في صورة أكوامٍ
من بيض الرنجة يبلغ ارتفاعها قدمًا يمكن للطيور أن
تتغذَّى عليها لمدة شهر، أو في صورة عدد لا نهاية له من
السمك الذي يمكن تدخينه وتجفيفه، ولا تزال تنتج ملايين
من الصغار التي سوف تخرج إلى المحيط وتُعيد
الكرَّة.»
ليست الدببة المُستفيد الوحيد. يتضمن النموذج الذي
يحسب كمية السلمون التي تحتاجها الدِّببة ضمنيًّا
الفقمات والحيتان والنسور التي تصِل إلى الأسماك قبل
الدببة، وتأكل حتى تشبع عند مصبِّ النهر قبل أن يدخل
السمك النهر الذي يمرُّ ببحيرة ويكينو. وما إن يصل السمك
إلى الجداول، حيث تترقَّب الدببة وصوله لاصطياده، حتى
تنتشر الحياة المُخزَّنة في أجسامها في أرجاء المساحة
الطبيعية. من الصعب تحديد المدى الكامل لتأثيرها؛ فقبل
انهيار أعداد السلمون الأحمر بعام، تدفَّق ما يقرُب من
٤٥ مليون رطل منه إلى الجداول المغذية لبحيرة ويكينو.
أما اليوم، فإن ما يصل لا يتعدى قطرةً من ذلك الفيض،
ولكن حتى تلك القطرة تظل وافرة. تتغذى الزبَّابات
وحيوانات المنك على جِيَف السلمون التي تُخلفها الدببة،
وكذلك تفعل الذئاب والعقبان الرخماء والبوم؛ نحو ٨٠
نوعًا من الفقاريات إجمالًا.
75 وتتغذَّى عليها اللافقاريات أيضًا؛ إذ تتحول
كل جيفةٍ إلى مدينة لخنافس الجيف ويَرَقات الذباب التي
تُساهم بدورها في تلقيح النباتات المُزهرة التي تدعم
نموها الجِيَف المُتحللة وروث الدببة، حتى إن أوراقها
تحتوي على كثافاتٍ عالية بشكلٍ غير عادي من الثُّغَيرات،
وهي البِنى التي تسمح بتدفق الغاز بين النباتات والهواء
المحيط.
76 تتنفس النباتات بشكلٍ أفضل عندما يكون هناك
عدد وافر من سمك السلمون ومن الدببة التي توزِّعه في
الأرجاء.
يتغير تركيب أنواع النباتات أيضًا. نظرًا لأن مجموعة
واسعة من أنواع النباتات تتكيَّف مع التربة الغنية
بالمُغذيات أكثر من التربة الفقيرة من المُغذيات، فإن
الأنظمة التي تكثُر فيها أعداد الدببة والسلمون تكون
وفيرةً وتتمتع بمستوياتٍ استثنائية من التنوُّع
البيولوجي.
77 هذه الأنظمة تكون غنيةً أيضًا بالنباتات
المُثمرة التي تحتاج إلى الحيوانات لنشر بذورها. قد
يحتوي روَث دبٍّ رمادي واحد على مئات الآلاف من بذور
التوت؛
78 ويُعَد بمثابة مستودع غذاء شتوي للفئران
واليرقات، ورقعة ذاتية التخصيب للجيل القادم من
النباتات. قالت ميجان آدامز: «نحن نعلم أنه كلما زاد عدد
الأسماك، زاد عدد الدببة. وكلما زاد عدد الدببة، زاد عدد
التوت الذي تأكُله، وزاد عدد البذور التي تتغوَّطها.
هناك تبادُل منافع بين جميع الكائنات.»
•••
بدأت جينيفر والكوس مؤخرًا مشروعًا آخر لمساعدة الدببة
الرمادية. تحتوي العديد من المواقع القديمة لقرى أُمة
ويكينو على بساتين مُهملة من أشجار التفاح البري التي
تنضج ثمارها في الوقت الذي يعود فيه سمك السلمون الأحمر،
ويمكن أن تؤدي العناية بها إلى جعلِها غذاءً للدببة في
السنوات التي تكون فيها أعداد السلمون المهاجر شحيحة.
استعانت بسارة ويكهام، وهي عالمة شابة تدرس الممارسات
التقليدية للعناية بأشجار التفاح البري لتُعيد تلك
البساتين القديمة إلى الحياة؛ إذ يُعَد التقليم إحدى
المُمارسات التي ربما يكون أسلاف أُمة ويكينو قد
تعلَّموها من الدببة، التي يؤدي كسرها للشجيرات أثناء
اقتياتها عليها إلى تعزيز نموِّها في السنوات
اللاحقة.
بعد عقودٍ من الآن، ستكون هذه البساتين هي إرث
مُمارسات إدارة سمك السلمون والدببة الرمادية باعتبارها
أقارب لنا. وستُجسد رؤيةً تعتبر البشر والطبيعة
مُتضافرين. ولكن بدلًا من أن تكون هذه الرؤية مبررًا
للمزاحمة على الموارد والاستحواذ عليها، ينبغي أن تدفعنا
إلى الالتزام بأن نرجع خطوةً للوراء ونتشارك مع الكائنات
الأخرى ونعتني بالبساتين التي تحمي الكائنات الضعيفة من
تقلُّبات القدر. هذا لا يعني أن مثال ويكينو يُعَد حلًّا
سحريًّا أو أنه عالج جميع التوترات؛ إذ يتساءل المرء،
على سبيل المثال، ما الذي سيؤدي إليه ضغط مصائد الأسماك
التجارية التي تحركها الأطماع اللامحدودة والدوافع
اللاأخلاقية للأسواق العالمية.
تعتقد جينيفر والكوس أنه من غير المُحتمل أن يُمثل هذا
الأمر مشكلة. فأعداد السلمون قليلة جدًّا، وإذا تغيَّر
ذلك، فإن أبناء أمة ويكينو سيقاومون إغراء أن يأخذوا
منها أكثر من القدْر المنصف. وتذكر تعامُلهم مع الغابات
كمثال حي؛ فالخطط التي وضعوها للاحتطاب تعطي إثراء
البيئة على المدى الطويل أولويةً على زيادة الأرباح على
المدى القصير. بخلاف الشركات التي يُمكنها الانتقال إلى
موقع آخر بمجرد أن تستنفِد موردًا ما، فإن أُمة وينيكو
تعيش هنا. على الأرجح سيكون من غير المُنصف، أو غير
الواقعي، أن نتوقَّع من أي نظام أن يكون مُحصنًا تمامًا
من الاستغلال. أقصى ما يمكن أن نأمُله هو أن تسود
التقاليد والقيم.
ولكن ماذا عن مُمارسات صيد الحيوانات والأسماك لأغراض
المعيشة؟ كيف يُمكننا أن ننظر إلى الحيوانات ليس فقط
باعتبارها موارد — وهو مصطلح تستخدِمه الأمم الأولى
الساحلية — ولكن باعتبارها أيضًا أشخاصًا مِثلنا وأقارب
لنا، ومع ذلك نقتُلها؟ عندما يتعلق الأمر بسمك السلمون
الأحمر العائد إلى موطنه، فإن هذه لا تُعَد معضلةً
كبيرة؛ فهو يتكاثر مرة واحدة فقط ثم يموت بعدَها؛ لذا
حينما يمرُّ في بحيرة ويكينو، يكون الباقي من عمره
أيامًا معدودة، سواء صاده الناس أو لم يصيدوه؛ ولكن
الأمر يختلف بالنسبة إلى الحيوانات الأخرى، بما فيها
الدِّبَبة السوداء، التي يصيدها الناس على عكس الدببة
الرمادية. يبدو أن بعض الأقارب أقرب لنا من
غيرهم.
لن أُنكر على أي صيادٍ من أُمة ويكينو صيده لتلك
الحيوانات. فبعد عدة قرونٍ من تعرُّضهم للإبادة الجماعية
وانتزاع الملكيات على يد غرباء يُمْلون عليهم طريقة
عيشِهم، سيكون ذلك ذروة الغطرسة. فهي أُمة تعيش في مكانٍ
ناءٍ، لا تصل إليه الطرق البرية، وأقرب متجر لها هو
قاعدة عائمة تبعُد ساعة بالقارب حسب قول ميجان آدامز؛
وهذا يعني أن وارداتها من الغذاء شحيحة ومُكلفة. ولكن في
حين أنه يمكن تجنُّب طرح الأسئلة الأخلاقية التي يُثيرها
الصيد في تلك الظروف الخاصة، فإنها تظلُّ قائمة. بالنسبة
إليَّ، أحاول الآن تجنُّب استهلاك أي حيواناتٍ على
الإطلاق؛ لقد أكلتُ منها الكثير جدًّا في حياتي، ولست
أهلًا لأن أستنكِر على أحدٍ أكلها على الإطلاق، كما أني
ما زلتُ آكُلها في بعض الحالات الاستثنائية، كأن يُقدم
لي أحدهم وجبةً تعب في إعدادها، لكن هذا ليس أمرًا أشعر
بالراحة تجاهه.
متى يكون القتل مقبولًا؟ قتل حيوان ووضعه في المُجمِّد
لأكله أفضل قطعًا من قتلِه من أجل الترفيه، غير أنه لا
يُلغي تلقائيًّا الأسئلة الأخلاقية. كما أني لستُ
مقتنعًا بالحُجج التي تقدم عادة لتبرير الصيد؛ فمبدأ مثل
قتل الحيوانات التي منحت الصيادين «إذنها» فقط يبدو
أنانيًّا ويمكن استغلاله. من المُهم أن تعيش الحيوانات
حياة جيدة على الأقل، بخلاف تلك التي تعيشها في مزارع
الإنتاج، لكن يظلُّ من المُحزن أن تُسلَب منها هذه
الحياة. أما بالنسبة إلى مبدأ أن الصيد مُستدام، فببساطة
لن يكفي عدد الفقاريات الموجودة على الأرض لسدِّ شهية
البشر إذا استبدلنا حيوانات المزارع التي نأكلها
بأقاربها البرية.
79 قد يكون استهلاك الحيوانات البرية مُستدامًا
في أماكن مُعينة، كما هو الحال في الساحل الأوسط
لكولومبيا البريطانية، حيث يُعَد نحو ٤٠٠٠ شخص جزءًا من
نظامٍ بيئي يمتدُّ على مساحة ٨٥٠٠ ميل مربع، وهي مساحة
أصغر قليلًا من مساحة ولاية نيوجيرسي. لكن معظم الناس لا
يعيشون في مثل تلك الظروف.
ومع ذلك، أعرف أيضًا أن العديد من الصيادين، من بينهم
أناس أعتبرهم أصدقائي، يعتنقون قيم الرعاية والاحترام.
أُدرك أن تأثيرات نظامي الغذائي تظلُّ تشمل تدمير
الحيوانات وموائلها، وإن كان بقدْرٍ أقل من السابق. وأن
المُمارسات التي أعتبرها اليوم مقبولةً قد تصير يومًا ما
غير مقبولة. وقطعًا لا يسعني أن أدَّعي أني شخص مُستنير
أو لديه اليقين الأخلاقي المُطلق. وفي مجتمعنا الذي
يحتاج فيه المرء أن يجاهد من أجل العيش وفق معايير
أخلاقية، والذي تتآمَر فيه الكثير من الضغوط للتفريق بين
الناس، أنا أُفضِّل أن أبحث عن أرضية مشتركة بدلًا من
أوجُهِ الاختلاف.
هنا أذكر شيئًا قاله لي عالم الحفاظ على البيئة
والأخلاق فرانسيسكو سانتياجو أفيلا؛ هو يُحب أن ينظر إلى
الحمية النباتية باعتبارها محاولةً مستمرة للتحسين،
للتفكير فيما يمكن للمرء فعله لتقليل الضرَر، بدلًا من
اعتبارها نظامًا منفصمًا يفصل بين أولئك الذين يستهلكون
الحيوانات وأولئك الذين لا يفعلون ذلك. ما يُهم ليس بلوغ
الكمال الأخلاقي. إنما أن يتمعَّن المرء في أفعاله
ويُحاول أن يُحسِّن من نفسه.
في محاولة لتأمُّل ما تعنيه معاملة الحيوانات
باعتبارها أشخاصًا مثلنا، كتبت مجموعة من علماء الأحياء
وعلماء الأخلاق في دورية «كونسرفيشن بيولوجي» أن ذلك لا
يعني بالضرورة الامتناع عن إيذائها تمامًا أو توحيد
الْتزاماتنا الأخلاقية تجاه كل الحيوانات. كتبوا: «بين
الوضع الذي يتساوى فيه جميع المخلوقات في المكانة
الأخلاقية والوضع الذي تستأثر فيه فئة قليلة من الكائنات
بمكانة أخلاقية استثنائية، توجَد مساحة لاستكشاف خيارات
أخلاقية واسعة أكثر شمولًا ومراعاة للسياق.»
80
ما يحدث في منطقة الساحل الأوسط هو إحدى صُور ذلك
الاستكشاف. والمبادئ التي توجِّه الناس هناك يمكن أن
تكون مصدر إلهامٍ في أي مكان؛ إذ تقوم العلاقة مع العالم
غير البشري على أساس المنفعة المتبادلة وحِسِّ القرابة —
أي الإقرار بأن الحيوانات أشخاص مثلنا، والاستعداد لعدم
الاستئثار بنصيب الأسد من الموارد لأنفسنا — بدلًا مِن
تصنيف الحيوانات في فئة الموارد التي يحقُّ لنا أن
نستحوذ عليها. قد تختلف كيفية تطبيق ذلك من مكانٍ لآخر
ومِن شعبٍ لآخر. تُرى ما الصور الأخرى المُمكنة؟ وكيف
سيكون شكل إدارة الحياة البرية عندما تنبع من روح
السخاء؟
الهوامش
⋆
خلال فترة عمل
كونتز في حديقة حيوان برونكس، عرف أنثى الفيل هابي،
المُدَّعية في الدعوى القضائية التي رفعها مشروع
حقوق غير البشر. آنذاك، كان يعتقد أن الحيوانات لا
يمكن أن تُمنَح حقوقًا قانونية لأنها لا تتحمل
مسئوليات. لكنه لاحقًا اقتنع بحجة أن الإنسان الذي
يُعاني من عجزٍ عصبي حاد قد لا يتحمل مسئولياتٍ
أيضًا، ولكن يُمكن تعيين وصيٍّ لتمثيل مصالحه. يقول
كونتز إنه يدعم الآن منح شكلٍ من أشكال الحقوق لهابي
وجميع الحيوانات الواعية. في حالة هابي، يرى أنه —
نظرًا لعمرها وشخصيتها — فإن مصالحها مكفولة على
أفضل وجهٍ ببقائها في حديقة الحيوان. لكن رغم ذلك
التقدير الشخصي، فإنه يرى أن أفضل نتيجةٍ للدعوى
القضائية كانت أن تُعين المحكمة لجنة من الخبراء
المُستقلين وعلماء الأخلاق لتقرير ما فيه صالح
هابي.