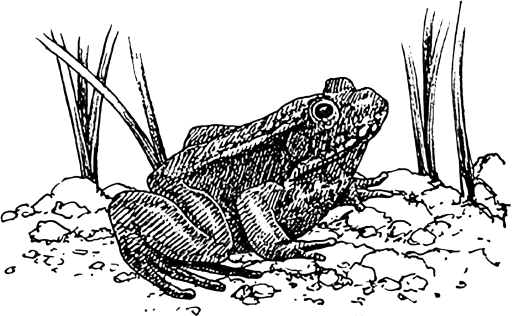الفصل الثاني
طبيعة مُفعمة بالمشاعر
بعد النشاط الصباحي، يعود الهدوء إلى البركة حتى أول
المساء، حين تبدأ موجة من النشاط الجديد لتوديع الضوء
الآفل. إذ تخرج الأرانب القطنية الذيل من بين العشب
الطويل لتقضم الطعام في الممر. إنها كائنات ذات جمالٍ
هادئ، لها فرو بُني تراه مُصمت اللون من بعيد، ولكن عن
قرب يبدو لونه كالخيط المَغزول من درجات ألوان مُتعددة.
عيناها السوداوان الكبيرتان ترَيان في كل الاتجاهات؛
وأُذناها الطويلتان بمثابة ميكروفونين محمولَين على
محورَين دوَّارَين. هذا هو العتاد الذي منحه التكيُّف
لتلك الكائنات الحذرة للغاية. أما عدم خوفها من المارة،
وقفزها مبتعدةً عن الممر بضع أقدام فحسب، فيبدو أنه
لأنها تُهدينا ثقتَها. وربما ساهم طعم البرسيم والهندباء
اليانعَين أيضًا في تردُّدها في الابتعاد عن الممر. فمن
الصعب دائمًا ترك وجبةٍ لذيذة.
على مسافة قصيرة من الجدول الذي تستحمُّ فيه الطيور،
ووراء السور الحديدي الذي يُحيط بمجمع المعاهد الوطنية
للصحَّة، تقف شجرة صفصاف أسود كبيرة — الأكبر من نوعها
في المقاطعة
1 — إذ يبلغ ارتفاعها ٦٠ قدمًا، ولها تاج قائم
على جذوع مُتعددة يكاد عرضه يقارب ارتفاعها. عند قاعدة
أحد فروعها التي تتدلَّى فوق الممر، توجَد فتحة صَنعت
فيها سنجابةٌ أمٌّ عشَّها. بعد زوال حَر النهار، يخرج
صغار السنجاب للَّعب. يطارد بعضها بعضًا عبر الفروع ومِن
حولها، وتتقافز بين الأغصان وتتدلَّى منها رأسًا على
عقب، وتتوقَّف من حينٍ لآخر للحصول على لمسةٍ حانية من
أُمِّها قبل أن تُعيد الكرَّة. يبدو أنها مُستمتعة
للغاية.
من الغريب أن نُفكر أنه حتى وقت قريب، كان إسناد صفة
الاستمتاع إلى تصرُّفات السناجب الطريفة أو لذَّة
التذوُّق الحسِّي إلى ذلك الأرنب الذي يتلذَّذ بتناول
الهندباء سيُثير الجدل بين العديد من العلماء.
2 وكانوا سيقابلون هذا الادعاء بالتشكيك: هل
يُمكننا أن نعرف حقًّا ما إذا كان السنجاب يستمتع
باللعب، أو إذا كان الأرنب يتلذَّذ بوجبة؟ رغم أن تلك
الحيوانات تبدو لنا كذلك ظاهريًّا، لكن هل هي قادرة
حقًّا على اختبار تلك المشاعر كما نفهمها؟
حتى حين بدأ العِلم يستكشف بذهنٍ مُتفتح إمكانات
الذكاء الحيواني، تجنَّب التطرُّق إلى موضوع انفعالات
الحيوانات. وأحد الأسباب التي دفعت العلماء إلى ذلك هي
التحدِّيات التي تنطوي عليها دراسة الانفعالات في
كائناتٍ لا تستطيع التعبير عنها لفظيًّا، ومن تلك
الأسباب أيضًا مفهوم الناس عن الانفعالات. على مدى قرون،
صوَّر العلماء أنه يُوجَد تبايُن حاد بين الذكاء
والانفعال،
3 ووضعوا الذكاء في مرتبةٍ أعلى. وهذا إرث لا
يزال حاضرًا في النقاشات المعاصرة. فإعمال العقل يُعَد
نقيضَ اتباع القلب، وذلك منذ أن قال أفلاطون بوجود
العقلانية والشغف في جزأين مختلفين من جسم
الإنسان؛
4 فالألغاز الذهنية لا تنطوي على أي انفعالات.
ونادرًا ما يوصف ذوو التعاطف الاستثنائي بالعبقرية. وتلك
الفكرة فيها مسحة من الانحياز الجندري أيضًا؛ فتاريخيًّا
تُعَد العقلانية من صفات الرجال، في حين تُعَد
الانفعالات مُتقلِّبة وأنثوية، وللمؤسسات العلمية تاريخ
مؤسِف من التحيُّز ضد النساء.
ولعل موضوع انفعالات الحيوانات غير مريح للبشر لأسبابٍ
أخرى. كانت نظرية التطوُّر، التي تعتبر الإنسان العاقل
مجرد فرعٍ من الأفرع العديدة لشجرة الحياة، مُزعجة بما
فيه الكفاية للمُعتقدين بتميز الإنسان. وإن أقر العلماء
على مضضٍ بأنَّ السنجابة الأم قد تمتلك تبصرًا أو ذاكرة،
فإن فكرة اختبارها للمشاعر نفسها التي نختبرها — أن ذلك
الإرهاق المُحبَّب الذي يعتريها بسبب رعايتها لأطفالها
المُفعمين بالحيوية قد يُشبه ما تشعر به الأم البشرية —
هي فكرة مُستبعَدة تمامًا لأنها خاصة بالبشر بدرجةٍ
كبيرة للغاية.
حاجج بعض العلماء والفلاسفة بأن اختبار أي شكلٍ عميق
من الانفعالات يستلزم لغة.
5 فبدون كلمة تدلُّ على الحب، لا يمكن تحويل
أحاسيس الحب الفسيولوجية البحتة إلى مشاعر مُدركة. غير
أنَّ ذلك ادِّعاء تكهُّني، ويفترِض ضمنًا وجود تبايُن
أوسع بين التواصل البشري والحيواني من ذلك الموجود
بالفعل. بعض الفلاسفة الآخرين لم يذهبوا إلى حدِّ اعتبار
اللغة شرطًا أساسيًّا، لكنهم حاججوا بأنه في غيابها، لا
يُمكننا ببساطةٍ تحديد ما تشعُر به الحيوانات بطريقةٍ
علمية دقيقة.
6
وهذا الرأي مُتفهَّم. فالانفعالات ذاتية؛ وبخلاف سِمات
— مثل التعلُّم أو الذاكرة — يمكن قياسها بدقة بنجاح
الحيوان في الخروج من متاهة أو حلِّ لغز، فإن الانفعالات
لا يُمكن قياسها بسهولة. وفي الدراسات التي تُجرى على
البشر، يُجلِّي العلماء هذا الغموض بسؤال الناس عن
مشاعرهم. لكن هذا غير مُمكن مع الحيوانات؛ ومِن ثَم يسهل
فيه الوقوع في أخطاء. كتب داروين في كتابه «التعبير عن
الانفعالات في الإنسان والحيوان» عن قرد مكاك أسود يُعبر
عن مودته بابتسامةٍ كاشفة عن أسنانه.
7 لكنَّنا صِرنا نفهم الآن أن تلك الإيماءة
تعبير عن الخوف أو الخضوع.
غير أن ذلك التردُّد في الإقرار بامتلاك الحيوانات
للانفعالات ربما يبدو غريبًا لأي شخصٍ عاشر حيوانًا.
خارج الأوساط الأكاديمية، لم يُساور الكثير من الناس أي
شكٍّ في أن للحيوانات مشاعر. ومن هنا جاء العدد الهائل
من القصص الشعبية، والأعمال الترفيهية، والروايات
الشخصية التي ساهمت في تشكيل الثقافة الغربية الحديثة؛
مثل مسلسل «الكلبة لاسي»، وشخصية «جنتل بن»، والفيلم
الوثائقي «مسيرة البطاريق». غير أن هذه الملاحظات لم
ترقَ إلى مرتبة المعرفة المنهجية، وفي الأوساط العلمية،
رفض العلماء هذه الأفكار باعتبارها إسقاطًا عاطفيًّا
للصفات البشرية على غير البشر.
اجتمعت عدة عوامل لإنهاء هذا التردُّد. وقد كان للفهم
العلمي الأعمق للعقل البشري، والبيولوجيا العصبية التي
تقوم عليها انفعالاتنا، تأثير على الأبحاث المُتعلقة
بمشاعر الحيوانات، التي قادتنا بدورها إلى المزيد من
الأفكار عن أنفسنا. نتج عن ذلك تصور جديد للإدراك
والانفعال — التفكير والشعور — يراهما مُتشابكَين لا
ينفكَّان.
8 إذا نُحِّيَت المشاعر عن معادلة العقل،
فستتعطل عمليات عقلية تبدو في ظاهرها مجردة مثل
الاستدلال وحل المشكلات. بل إن من العلماء من يقترح أن
النظم التي تستند إليها الانفعالات نشأت لدى أقدم
الفقاريات.
9 ساعدت المشاعر الكائنات على التفاعُل مع
الظروف المُتغيرة وتبنِّي أنماطٍ سلوكية مفيدة. تلك
الأرانب الموجودة في الممر تأكل الهندباء لأنه يُعَد
حافزًا شعوريًّا.
ادمج هذه الأفكار مع الأساليب البحثية الحديثة الذكية
والمبتكرة، ولن يسعك إلا أن تُقرَّ بثراء انفعالات
الحيوانات. ومع ذلك، حتى في وقتِنا الحالي الذي تزخَر
فيه المجلات العلمية بمثل هذه الدراسات، فإن الدروس
المُستفادة منها لم تتغلغل بعدُ بالكامل في وعيِنا
بالطبيعة. نقرأ عن استخدام فئران البراري لدراسة
البيولوجيا العصبية للحب،
10 ونقرأ أن أسماك السلمون تُصاب
بالإحباط،
11 وأن جراد البحر يُصاب بالقلق؛
12 وبالطبع هذا لا يحدُث فقط في البيئات
المختبرية. فأراضي كوكبنا ومياهه وسماؤه تزخر بالذكاء،
وكذلك بالمشاعر.
•••
راقِب تلك الأرانب القطنية الذيل وهي تأكل العشب،
وأنوفها الحساسة وهي ترتعش ببطء؛ إن ما تفعله أكثر من
مجرد نيل حاجتها من المُغذيات، إنها تتلذَّذ بالوجبة.
لذة الأكل هي وسيلة التطوُّر لحثنا على التغذِّي جيدًا؛
وإذا لم تُجرَ بعدُ دراسة على تأثير حاسَّة التذوق على
الأرانب القطنية الذيل، وكيف تختبر الطعام وهي تملك
ثلاثة أمثال براعم التذوُّق التي يمتلكها البشر، فلَنا
أن ننظر إلى دراسة ذات صِلة اختارت الجرذان المشارِكة
فيها أن تركض مسافة ٥٠ قدمًا في درجات حرارة فائقة
البرودة من أجل تناول الكعك والصودا بدلًا من طعام
المُختبر المعتاد.
13 التذوُّق إحدى الملذَّات الأبدية، وهناك
شيءٌ خفيٌّ باعث على الرضا في مشاهدة الأرانب وهي
تأكل.
أما فيما يخصُّ تلك السناجب الصغيرة البهلوانية في
شجرة الصفصاف الأسود، فتوجد الكثير من الأبحاث العلمية
عن أهمية اللعب بين الحيوانات. اللعب يساعد الحيوانات —
ويُساعدنا نحن أيضًا — على التعرُّف على
العالم؛
14 على القوانين الفيزيائية والخواص
الفيزيائية، وعلى سمات بيئاتها، وآليات عمل أجسادها،
وقواعد الآداب الاجتماعية.
15 كأفضل المُعلِّمين، يشجع التطور على اللعب
بجعله مُمتعًا.
يُحب أحد السناجب الصغيرة أن يتدلَّى رأسًا على عقب؛
يتصرَّف كطفل في ساحة ألعاب تسلق. ينبغي أن تكافئ دفقة
صغيرة من الدوبامين هذا الفعل الجريء للسنجاب،
16 مما يجعله يرغب في الإتيان بالمزيد منه،
وهذا ما يدفع تلك السناجب الصغيرة لأن تقفز بين الأغصان،
وتطارد بعضها حول جذع الشجرة حتى يُنهكها التعَب. وهذا
النوع من اللعب، الذي يُعرِّفه العلماء بأنه سلوك
اختياري ومُتكرر لا يخدم وظيفةً واضحة،
17 يختلف عن السلوك «الجدِّي»، وتسلُكه في حالة
غياب التهديدات؛ وقد وثَّق العلماء حدوثه ليس فقط لدى
الحيوانات التي يُتوقَّع منها ذلك، ولكن أيضًا في جميع
أفراد المملكة الحيوانية. تركب شراغب الضفادع الطحلبية
الفيتنامية الفقاعات،
18 وتُوازن أسماك الفيل الأغصان على
خطمها،
19 وتُشبِهُ تنانين الكومودو وهي تركض وراء
كرة
20 — عند مشاهدتها في مقطع فيديو مُسرَّع —
كلابًا تمرح.
بينما تلعب السناجب في ضوء الشمس الغاربة الخافت، يرِد
زوجان من طيور الزرزور جدول الاستحمام في زيارة متأخرة.
يغمسان رأسيهما ويرفرفان بجناحَيهما في الماء، فينثُران
رذاذًا يغمر ريشهما، ويغمق لونهما القزحي الذي يكتسيان
به أثناء موسم التزاوج. لا يُقدَّر جمال الزرازير حقَّ
قدره. في هذا الوقت من العام، تكتسي الزرازير البالغة
المتزاوجة باللونَين الأرجواني والزمرُّدي اللامع، في
حين تبدو أطراف ريش الزرزور البالغ غير المُتكاثر كأنها
غُمسَت في ماء الذهب.
قبل عدة سنوات، أجْرت عالمة إيثولوجيا (علم سلوك
الحيوان) بريطانية تُدعى ميليسا بيتسون سلسلةً من
التجارب المُصممة لمعرفة شعور الحيوانات عند
الاستحمام.
21 وأجْرت تعديلات على ما يُسمَّى باختبارات
الانحياز المعرفي التي طُورت في الأصل لدراسة البشر، لا
سيما الأطفال الصغار وغيرهم من الأشخاص الذين يجدون
صعوبة في التعبير عن مشاعرهم. تعتمد هذه الاختبارات على
تأثير الحالة المزاجية على الاستجابة لعدم اليقين: عندما
تكون حالتنا المزاجية جيدة، نكون متفائلين، ونرى نِصف
الكأس مملوءة، ونكون أكثر ميلًا للمجازفة. وعندما تكون
حالتنا المزاجية سيئة، يحدث العكس. وهذا ينطبق على
الحيوانات أيضًا.
سجلت ميليسا صيحات تحذيرٍ لزرازير وأسمعتها للطيور في
مختبرها. فوجدت أن الطيور التي استحمَّت في وقت سابق من
ذلك اليوم رفعت بصرها، وتفحَّصت مُحيطها، ثم ما لبثت أن
استكملت تناول وجبتها. كانت تلك الطيور في حالةٍ مزاجية
جيدة. أما الطيور التي لم يُسمح لها بالاستحمام، فقد
تأخَّرت في استكمال تناولها لوجبتها، وظلَّت حذرةً طوال
التجربة. كانت مُتوجِّسة؛ وبدا لها احتمال تعرُّضها
للهجوم كبيرًا. هذان الزرزوران اللذان يستحمَّان في
الجدول لا بد أنهما مُسترخيان للغاية.
أُجريَت اختبارات الانحياز المَعرفي للعديد من الأنواع
البرية والداجنة. بعض الأشياء التي تستكشفها تلك
الاختبارات هي التأثيرات النفسية للحبس الانفرادي على
الخنازير،
22 وما إذا كان الشمُّ يجعل الكلاب
سعيدة،
23 وكيف أن الغربان تتضايق عند رؤية غرابٍ آخر
في حالة مزاجية سيئة.
24 تُعَد ميليسا بيتسون واحدة من الباحثين
الذين طوَّروا أيضًا هذه الاختبارات للنحل.
25 ووجدت أنه مِن غير المُحتمل أن يستكشف ذكور
نحْل العسل مصدر رائحة حلوة غامضة بعد أن تُهَز
خليَّتهم، وذلك على ما يبدو لأن تعرُّضهم للهجوم يُغير
حالتهم المزاجية؛ والحالة المزاجية هي حالة انفعالية
مُستمرة وليس مجرد شعورٍ عابر. أجرى باحثون آخرون تجربةً
مُشابهة مع النحل الطنَّان، حيث دربوا النحل أولًا على
أن يقرن الزهور الزرقاء الصناعية بالرحيق الحلو والزهور
الخضراء الصناعية بالماء العديم المَذاق، وبعد ذلك
قدَّموا له زهورًا لونُها أخضر مائل للأزرق بها مكافأة
غير معروفة.
26 لكن بدلًا من هزِّ خلية النحل، أعطى
الباحثون بعض النحل مكافأة مِن محلول السكر. ذلك النحل
الذي حصل على المكافأة طار بسرعة نحو الأزهار الغريبة.
إذ كان في حالةٍ مزاجية جيدة.
إذا تراكم العديد من التجارب الإيجابية والحالات
المزاجية الجيدة، فستؤدي في النهاية إلى حالةٍ عامة من
السعادة لدى الحيوانات — وكذلك لدى الإنسان العاقل — لكن
حدوث ذلك في النحل يبدو أمرًا مُستبعدًا حتى بالنسبة
للأشخاص الذين لا يُمانعون الإقرار بأن الحيوانات تمتلِك
انفعالات. غير أن اختبارات التفاؤل والتشاؤم ليست إلا
أحد المسارات البحثية العديدة التي تقود إلى النتيجة
نفسها. فعندما زوَّد الباحثون النحل بجرعاتٍ من المواد
الكيميائية التي تُثبِّط عمل السيروتونين والأوكتوبامين
والدوبامين — وهي الناقلات العصبية التي تنظم الانفعالات
عند البشر — وجدوا أنه لم يعُد يتصرَّف وفق
انفعالاته.
27 وعند الفحص الدقيق لأدمغة النحل وغيره من
الحشرات، تَبيَّن أنها تمتلك بِنًى وكيمياء دماغية تُشبه
إلى حدٍّ كبير بِنى الدماغ البشري وكيمياءه،
28 إلى الحدِّ الذي جعل الباحثين يدرسون الآن
اللافقاريات لتكوين فَهمٍ أفضل للاضطرابات الانفعالية
البشرية. وصفت أبحاث أخرى كيف تستمتِع ذبابة الفاكهة
بالقذف،
29 وتكتئب عندما تتعرَّض للإجهادات المُتكررة
والخارجة عن تحكُّمها.
30 حتى عالم اللافقاريات يفيض بالمشاعر.
على جانب البركة المقابل للجدول الذي تستحمُّ فيه
الطيور، زُرعَت المنحدرات بصفوفٍ عريضة من نبات قفاز
الثعلب أو القمعية الخماسية الأسْدية المزهِرة الجميلة.
يُسمى ذلك النبات بالإنجليزية
foxglove
beardtongue، وربما يكون الشطر
الأول من اسمه الإنجليزي
foxglove اشتُق في
الإنجليزية القديمة من لفظة
folk،
31 التي تعني «الجنيَّات»، ذات اليدَين
الصغيرتَين بما يكفي لإدخالها في أزهار ذلك النبات؛ أما
الشطر الثاني
beardtongue الذي
يعني «اللحية المُدببة»، فيصف شكل الشُّعيرات الناعمة
التي تبطن البتلة السفلية في كل زهرة. في الربيع، تكتظ
بنحل الخشب والنحل الطنَّان، وتزحف كل نحلة إلى داخل
الزهرة لترتشف من رحيقها وتنال قسطًا من حبوب اللقاح من
تلك «اللحية المُدببة». يغدو النحل ويروح بأعدادٍ مهولة
إلى حدِّ أن طنينه يُسمَع من على ملاءة مفروشة على
العُشب على مقربة. هذا الطنين هو صوت اللذَّة التي تغمر
هذا المكان.
نقيض اللذَّة هو الألم، وهو نتاج اتحاد الحسِّ
والانفعال؛
32 فهو ليس مجرد الضغط المادي الناجم عن اصطدام
إصبع القدم بشيء، إنما أيضًا الانفعال الذي يجعل تلك
التجربة غير سارة. حتى وقتٍ قريب جدًّا، كان من العلماء
من يُحاجج بأن الكائنات ذات الأدمغة الكبيرة تشعر
بالألَم بشدة أعلى من الكائنات ذات الأدمغة الصغيرة، وأن
البشَر فقط، وربما الثدييات الأخرى، يُمكنهم الشعور به
بصورته العميقة المُعقدة.
33 لم تعُد هذه الآراء تحظى بقبولٍ علمي كبير،
ولكن حقيقة أنها كانت تتمتَّع به من قبل تكشف لنا
الكثير. ولعلَّها لا تكشف لنا معرفةً علمية بقدْر ما
تكشف لنا صعوبة التعاطف مع المخلوقات التي تختلف عنَّا
جسديًّا.
أحد الآراء الكاشفة هو رأي لا يزال قائمًا حتى يومِنا
هذا عن الأسماك، التي نشأتُ وأنا أصطادها، وهو أنها لا
تشعُر بألَم فِعلي، مهما تلوَّت عندما تعلق في خطاف
معدني. كان من المفترض أنه شيء يُسمَّى الألم العصبي؛
وهو استجابة إدراكية بحتة ليس لها أي بُعد شعوري. كانت
هذه الفكرة تقوم إلى حدٍّ كبير على الاعتقاد بأن الأسماك
تفتقر إلى البِنى الدماغية التي تنظم الشعور بالألم عند
البشر.
لكن وجهة النظر هذه لم يعُد لها رواج. تُظهر العديد من
الدراسات أنه عند تعرُّض الأسماك لشيءٍ يُعَد مؤلمًا
بالنسبة إلينا، فإنها تتصرَّف كما نفعل.
34 إذ تُغيِّر سلوكها كي تتجنَّب تكرار تلك
التجربة، مما يُشير إلى وجود بُعدٍ نفسي يحثها على
التعلُّم والتكيُّف. ومثلما حدث مع النحل، أدى إعطاء
الأسماك أدوية مُثبطة للألم إلى عدم تفعيل هذه
الاستجابات. تحتوي أدمغة الأسماك، وكذلك أدمغة سائر
الفقاريات، على بِنًى مناظرة لتلك المنظِّمة للألم في
الدماغ البشري؛ ليست مطابقة لها تمامًا، لكنها تُشبهها
كثيرًا. وجد التطوُّر سبلًا لإنتاج خبراتٍ مماثلة بواسطة
أشكالٍ مختلفة. ففي النهاية، الألم مُفيد للغاية.
لا يعني هذا أن الألَم الذي تختبِره الأسماك — أو حتى
اللذة — مُماثل تمامًا لذلك الذي نختبره. فثَمة بعض
الاختلافات الواضحة. على سبيل المِثال، لا تستجيب
الخلايا العصبية المسئولة عن الإحساس بالألَم لدى سمك
السلمون المُرقط لدرجات الحرارة الشديدة البرودة للمياه
تحت الجليد الشتوي،
35 رغم أن جلدَها الرقيق أكثر حساسية من جلدنا.
كذلك، لا يجب أن نَعتبر انفعالاتنا معيارًا لطَيف
الانفعالات المُمكنة. تضرب بيكا فرانكس، عالمة النفس في
جامعة نيويورك المُتخصِّصة في إدراك الأسماك ورفاهها،
مثال أسماك السلمون الأطلنطي العائدة من المحيط للتكاثر.
تُرى كيف يكون إحساسها بتيارات موطنها؟ ولا أعني فقط
الإحساس الجسدي، بل مشاعرها أيضًا.
ليس خطأً أن ننظُر إلى الضفادع وهي تستحمُّ تحت الشمس
فنتخيَّلها سعيدة؛ ولكن هل سنقِف عند هذا؟ يمكن للعديد
من البرمائيات الإحساس بالمجالات الكهربية
الدقيقة،
36 وفي كل شتاء، تتباطأ العمليات الحيوية في
أجسادها حتى تكاد تتوقَّف عدة أشهر؛ هذه القدرات
الفسيولوجية المُميزة تقع خارج حدود إدراكنا، وتدفع
المرء لأن يتساءل إن كان لها نظير انفعالي. تُرى ما
المشاعر التي قد تكون موجودةً لكنَّنا لا نملك حتى
مرجعًا نقيسها عليه؟
•••
مع حلول الظلام، يُغرد طائر مُحاكٍ مُنفرد يقف على أحد
أعمدة السياج فوق نبات القمعية. يبدو من مخزونه الهائل
المُتنوع من الأغرودات أنه ذكَر. تُغرد الإناث أيضًا —
وهي حقيقة لا تحظى بالتقدير الكافي،
37 ليس فقط في طيور المُحاكي ولكن في أنواعٍ
عديدة من الطيور — ولكن أغروداتها تكون أقلَّ صخبًا، كما
أنها لا تُغرد كثيرًا في الربيع. ريشُه رمادي باهت
وأبيض، لكن عينَيه لونهما أصفر صارخ يليق بشغفه في
التغريد، الذي يتجاوز مجرد أغرودةٍ منفردة إلى حفل
موسيقي كامل، إنه مثل عازف جاز يعزف مقطوعاتٍ مُتنوعة من
الألحان الشعبية أو مشغل أسطوانات يمزج الأغاني. يستمر
تغريدُه مدة ثماني دقائق أو عشر قبل أن يطير إلى عمود
سياج آخر ويبدأ من جديد.
في مقطوعاته المتنوعة تجد مقتطفات من زغاريد الشحرور
الأحمر الجناحَين والصيحات الحادة للباز الأحمر الذَّيل
— أو لعَّل تلك صادرة من زرياب أزرق يقلد بازًا — ومواء
طائر موَّاء ونعيق غراب؛ نداءات تعلَّمها من عشرات
الأنواع، يُطلقها بتتابُع سريع تعجز عن متابعته الأذن
غير المُدربة. كتب شاعر القرن التاسع عشر سيدني لانيير،
وهو واحد من العديد الذين احتفوا بهذا النوع الذي أَطلقَ
عليه الشاعر الأمريكي والت ويتمان «المحاكي الأمريكي»،
قال: «كل ما تفعله الطيور أو تحلم به، يمكن لهذا الطائر
أن يقوله.»
38 تؤلِّف طيور المحاكي أيضًا أغروداتها
الأصلية،
39 وهي موهبة تُخفيها وراء ميلها للتقليد. في
نيو أورليانز، ثَمة خلاف حول ما إذا كانت تلك الطيور
تُقلد المقطع الختامي الذي يعزفه الموسيقيون لبدء
المسيرات الاستعراضية في الشوارع أم إن الموسيقيين هم من
استعاروا أغرودة طيور المحاكي.
40
لكن لماذا تُغرد تلك الطيور في الأساس؟ أحد التفسيرات
المعتادة هو أنها تُرسِّم حدود منطقتها. أُحب أن أُشبِّه
ذلك بموكب إرساء الحدود، وهو تقليد قديم كان يُمارَس منذ
آلاف السنين في إنجلترا وويلز حيث كان القرويون يطوفون
حول حدود أراضيهم كل ربيعٍ وهم يغنون.
41 ربما يحاول ذلك المُحاكي الواقف على عمود
السياج أيضًا جذب شريكةٍ أو الاحتفاظ بشريكته؛ وتستمر
شراكات تلك الطيور سنوات، وأحيانًا مدى الحياة، ويُغرد
الذكور لإناثهم على مدار العام.
42 غير أن تفسيرات رسم الحدود وجذب الشريكة قد
تجعل التغريد يبدو عمليةً آلية، بل تستبعِد النظر في
الجوانب الأخرى له. إذ تتعامل معه باعتباره فعلًا
روتينيًّا. ولا تتطرَّق هذه التفسيرات إلى الشعور الذي
ينتاب الطائر عند التغريد. تُرى هل يختبر هذا المُحاكي
بعضًا من مشاعر البهجة التي تنتاب مطربًا
بشريًّا؟
الإجابة المختصرة: نعم، ولكن الأمر مُعقدٌ بعض الشيء.
تشير الأبحاث على طيور الحسون المُخطط — وهو نوع
يُستخدَم أحيانًا لاستخلاص استنتاجات عامة عن آليات عمل
دماغ الطيور المُغرِّدة — إلى أنه عندما يكون المُستمع
للتغريد شريكةً حالية أو مُحتملة، فإن باعثه يكون البحث
عن المُتعة؛ فبعد الجماع، يتوقَّف الذكور عن التغريد،
على ما يبدو لأنهم أشبعوا تلك الحاجة.
43 يختبر العلماء ذلك تجريبيًّا عن طريق إعطاء
ذكور الحساسين المُخططة مواد كيميائية تُعزِّز نشاط
المواد الأفيونية الموجودة طبيعيًّا في دمِها، وهو ما
يُحاكي النشوة التي تلي الجماع. بعد إعطائها تلك المواد
تَخفُت أغروداتها الموجهة للإناث وتفقد حماستها. لقد
أُشبعَت حاجتُها بالفعل، ولا حاجة لها لمزيد من الإشباع.
كما يبدو أن مكافآت التغريد لترسيم الحدود تكمن في
تبعاته وليس في التغريد بحدِّ ذاته.
لكن ليس كل تغريد غرضُه ترسيم الحدود أو التزاوج.
فالطيور اليافعة تُغرد قبل أن ترِد في ذهنها تلك
الاهتمامات بوقتٍ طويل، وكثيرًا ما تغرد الطيور البالغة،
ذكورًا وإناثًا، في عدم وجود شركاء مُحتملين أو منافسين.
تلك الأغرودات تتجاهلها الطيور الأخرى. ويبدو أن صاحبها
يؤدِّيها لنفسه، لأسبابٍ تشير إليها دراسات عن دور
الدوبامين في تعلُّم التغريد. عندما تغرد الطيور، فإنها
تعقد مقارنة ذهنية بين نسخةٍ مثالية من الأغرودة موجودة
في ذهنها، والألحان التي تخرج من مناقيرها. وحين تتطابق،
يؤدي ذلك إلى دفقةٍ من ذلك الناقل العصبي. مجرد الوصول
إلى اللحن الصحيح يُعَد مكافأة بحد ذاته.
وماذا عن خبرة الاستماع إلى التغريد؟ فيما يتعلَّق
بجذب الإناث على وجه التحديد، تُعَد التفسيرات العلمية
قاصرة؛ فقد تنزع الإناث إلى تفضيل الذكور التي تقترن
سِماتها الصوتية بالنجاح التكاثري، ولكن تلك الأنماط
تتكشَّف على مدى الزمن التطوُّري. ولا تصِف تلك
التفسيرات ما تختبره الإناث عند سماع أغرودة. في هذا
الصدد، منحتنا دراسة العصافير البيضاء الحلق بعض
الاستبصارات، وهي زائر غير مُنتظم للبركة؛ إذ تقضي
الشتاء في جنوب الولايات المتحدة، ولكنها تتكاثر في
غابات الصنوبر بكندا ونيو إنجلاند. يستدعي صفيرها العالي
الواضح في الذهن الصباحات المُشمسة والجداول المُتدفقة
فوق جذور الأشجار. عندما تُصغي إناث العصافير البيضاء
الحلق إلى تلك الأغرودات، تنشط في دماغها المسارات
العصبية التي تنشط لدى البشر استجابةً لسماع
الموسيقى.
44•••
رغم أن داروين لم يكن أفضل مُفسِّر لتعابير القردة،
فإنه كان رائدًا في رؤيته للانفعالات الحيوانية. لم يرَ
أي سببٍ لتفرُّد نوع الإنسان العاقل بالمشاعر؛ إنما يمكن
تتبُّع مشاعرنا نحن البشر — مثل الفرح، واليأس،
والإصرار، والغضب، والاشمئزاز، والدهشة — إلى قدراتٍ
أساسية اعتقد أنها موجودة لدى كثيرٍ من
الحيوانات.
45 خلُص داروين إلى أن الانفعالات متجذرة بعمق
في التاريخ التطوُّري، إلى حدِّ أن التواصُل الصوتي في
حدِّ ذاته موروث منها، وأنه نشأ عندما تسبَّبت تشنُّجات
ناجمة عن الانفعالات في انقباضات في القصبة الهوائية لدى
بعض الكائنات البدائية المُتنفسة للهواء؛ مما أدى إلى
إنتاج أصواتٍ أولية مبتورة، وألَّفها الانتخاب الطبيعي
لاحقًا لتُصبح نقيقًا لدى الضفادع، وزئيرًا لدى
التماسيح، ولغةً لدى الإنسان.
طوَّر الانتخاب الطبيعي لاحقًا أيضًا القُدرة على
الإحساس بهذه الأصوات. في الواقع إذا كان التعبير
العاطفي نابعًا من أصلٍ مشترك، فينبغي أن يكون البشر
قادرين على تفسير الأصوات الناجمة عن الانفعالات في
كائناتٍ مختلفة؛ وهذا افتراض اختُبرَت صحَّته منذ عدة
سنواتٍ عندما طلب الباحثون في جامعة رور بمدينة بوخوم
الألمانية من الناس الإصغاء إلى تسجيلاتٍ لأصوات تسعة
أنواع، كان منها أنواع مُمثلة للثدييات والطيور والزواحف
والبرمائيات، وتخمين ما إذا كانت الحيوانات التي أنتجتها
تشعُر بالإثارة.
46 بغضِّ النظر عن النوع، صح تخمين الناس. كان
أحد تلك الأنواع هو القرقف الأسود الرأس البسيط، صديقنا
الذي يخطط للمستقبل، الذي قابلناه في الفصل السابق؛ في
الواقع تعرَّف الناس على انفعاله أسرع من الخنازير أو
قرود المكاك البربري اللذَين تربطنا بهما قرابة أوثق
بكثير.
حلَّل باحثون آخرون أصوات الاستغاثة التي يُصدرها صغار
شتَّى أنواع الفقاريات ما عدا الأسماك، فوجدوا بصماتٍ
صوتية مشتركة بينها.
47 قادت ذلك البحثَ عالمةُ الأحياء سوزان
لينجل، وقد أجْرت أيضًا تَجارِب أسمَعَت فيها غزالةً
أمًّا تسجيلاتٍ لأصوات استغاثة لصغار ثدييات منها
حيوانات المرموط والفقمات والقطط والخفافيش
والبشر.
48 استجابت الغزالةُ الأم لجميع تلك الأصوات
بما فيها أصواتنا. إن استغاثة رضيعٍ مكروب إشارة تفهمها
الحيوانات كافة.
تؤكد مثل هذه النتائج
49 على نفاذ بصيرة داروين، وكذلك على أن الرابط
بين الانفعال والحياة الاجتماعية وثيق إلى حدِّ أن
تعبيراته الأولية الأبسط تتجاوز فجوات تطوُّرية قدرُها
مئات الملايين من السنين. إذا كانت الانفعالات قد نشأت
باعتبارها وسيلةً تُساعد المخلوقات على التكيُّف مع
الظروف المُتغيرة، فإنها سرعان ما باتت سِمةً أساسية في
التفاعُلات الاجتماعية؛ في جميع سلالات الفقاريات،
تتداخل الشبكات العصبية الحيوية التي تُنظم الانفعالات
مع تلك التي تحكم السلوك الاجتماعي.
50
الانفعال سِمة اجتماعية في جوهره، وخير مِثال على ذلك
المبدأ هم جيراننا الذين يقطنون تلك الحفرة على الرصيف
بجانب المطعم وشجيرة اللبلاب الإنجليزي؛ الجرذان البُنية
«راتوس نورفيجيكوس». في العقد الماضي، أجرى العلماء
تجارب تُظهر شدة تأثُّر مشاعر الفئران بعضها
ببعض.
51 فهي تستجيب لكرب أقرانها المحبوسين في قفصٍ
إلى حدِّ أنها تتخلَّى عن قطعة شوكولاتة — وهي طعام شهي
للفئران مثلما هي بالنسبة لنا — في سبيل إنقاذهم، كما
أنها تتشارك طعامها بسخاء بالغ مع الجرذان
القلقة.
تجعلنا هذه التجارب نرى ذلك الكائن المَكروه بشدة
بمنظور جديد، وتوضح لنا كذلك جوهر المواجدة. لا تمتلك
الجرذان القدرة — التي تستلزم مستوًى عاليًا من التجريد
— على تخيُّل نفسها في موضع شخصٍ آخر، حتى بعد أن تكون
قد عرفت بأمره بطريقٍ غير مباشر؛ فتلك قدرة لعلها فريدة
لدى الإنسان. ولكنَّ ثَمَّة أشكالًا أبسط من المواجدة،
كتلك التي تظهر لدى الجرذان، كما يحدُث عندما يبكي شخص
أمامك ولا يسعك إلا أن تحزن لحُزنه.
يُعتقد أن هذه «العدوى العاطفية» تطوَّرت لتعزيز
النزعة الاجتماعية،
52 لا سيما في الأنواع التي تعتني فيها الأمهات
بصغارها، وتحتاج إلى أن تكون مُنتبهةً لمزاجها
واحتياجاتها. تفعل الجرذان ذلك؛ إذ تُرضِع الأمَّهات
صغارها وتعتني بها داخل جحورٍ متوارية عن أعيُننا، ويصدر
الصغار أصواتَ فرحٍ شدَّتها أعلى من أن تُدركها الأذن
البشرية. وبالطبع، التنشئة الأبوية ليست مقصورة على
الثدييات، بل تنتشِر في مملكة الحيوان، حتى إنها توجَد
لدى بعض أنواع الحشرات. تقوم الخنفساء الدافنة التي
تختزن جُثث القوارض الصغيرة والطيور باجترار الطعام
لإطعام صغارها الجائعين؛ أثناء ذلك يتعرَّض دماغها
لتغيُّرات في العمليات الكيميائية المُرتبطة بالرعاية
الأبوية.
53 بعد فترةٍ قصيرة، سيقوم طائر المُحاكي ذلك
وشريكته بإطعام فرخٍ نما حتى كاد يُماثلهما حجمًا، حتى
إنَّ منظره وهو فاغر منقارَه متوسلًا الطعام يبدو
مُستغرَبًا.
ما إن تطورت البيولوجيا العصبية للمواجدة لتحثَّ على
الرعاية الأبوية، حتى صار بالإمكان تطويعها في علاقاتٍ
أخرى، لا سيما العلاقة بين الشريكين. إنَّ أوثق رباط
يمكن أن يربط فردَين هو المشاعر المشتركة التي يختبرانها
في خضمِّ تقلُّبات الحياة. على بُعد عدة مبانٍ من
البركة، على ممرٍّ للمشي مَبنيٍّ على خط سكة حديد مهجور،
توجَد مُستعمرة لفئران الصنوبر. هي أقاربُ بُنيةُ اللون
سمينةٌ للفئران المنزلية، وقد حازت أبناء عمومتها فئران
البراري بعض الشهرة العلمية في دراساتٍ عن الأوكسيتوسين،
وهو هرمون أساسي في العمليات العقلية المسئولة عن الوفاق
والمودة بين الشريكين.
54 تطوَّر الأوكسيتوسين منذ نحو ٤٥٠ مليون عام،
وله دور في سلوك كل طوائف الفقاريات،
55 ولكن فئران البراري منحتنا منظورًا فريدًا
لتأثيره على اختيار الشريك وتقوية العلاقات والتعبير عن
الاهتمام. يُسمى الأوكسيتوسين أحيانًا «هرمون الحُب»؛
وهو مصطلح مُبسط للغاية، ولكنه يعكس أهميته.
لكن رغم كل ما كشفته لنا الأبحاث على فئران البراري
وغيرها من الحيوانات عن آلية عمل الأوكسيتوسين، فإننا في
الأغلب لا نُقر لها بالقدرة على الحُب. فاللغة التي نصِف
بها العلاقات الرومانسية بين الحيوانات جامدة تمامًا:
فنحن لدَينا شركاء حياة وعشَّاق وأزواج، أما الحيوانات
فلدَيها شركاء تزاوُج. يحلُّ الاقتران التكاثُري وميزات
الصلاحية محلَّ الشغف والرومانسية والشهوة المعهودة.
وغالبًا ما يوصَف اختيار الحيوانات لشركائها كما لو أن
غرَضَها الوحيد منه هو توريث جيناتها.
يزيد الطينَ بلةً أن العلاقات الحيوانية تكون في
الأغلب بعيدة عن أعيُننا. إذ توضع الحيوانات التي تُربى
في المزارع للإنتاج الغذائي غالبًا خلفَ أبوابٍ مُغلقة
ولا تعيش في ظروفٍ طبيعية. أما الحيوانات الأليفة فنأتي
بها من الملاجئ أو مِن مُربين آخرين. أما الحيوانات
البرية فلا نُراقبها على مدار أيام وفصول، إنما نرى فقط
لمحاتٍ من حياتها؛ هذا باستثناء أنواع قليلة منها.
تأتينا الروايات الأكثر تفصيلًا من مقاطع الفيديو
الرائجة أو حفنة من الأشخاص الذين تسمح لهم حياتهم
بمراقبة الحيوانات عن قُرب.
ريتا ماكماهون هي مؤسِّسة مُستشفى «سيتي وايلدلايف»
للطيور البرية المصابة في مدينة نيويورك، وقد حكَت لي
ذات مرةٍ عن رعايتها لأُنثى حمامة انكسرت ساقها. بينما
كانت الحمامة تقضي فترة نقاهتها على وسادةٍ عند النافذة،
كان شريكها يقِف على الجانب الآخر من الزجاج يؤنِسها،
حتى أطلقت سراحها واجتمع شمل الزوجَين. ويصف كيفن
ماكجوان، عالم الأحياء بجامعة كورنيل الذي تتبَّع أكثر
من ٣٠٠٠ غراب على مدار العقود الثلاثة الماضية، مُراقبته
للغراب «إيه بي» وهو يختار من بين أنثيَين؛ أصبحت
الأُنثى التي رفضها ناجحةً للغاية مع ذكرٍ آخر؛ إذ ما
انفكَّت تُنشئ جيلًا وراء جيل، في حين كانت تفشل في ذلك
الشريكة التي اختارها.
يروي ماكجوان أنه رغم أنهما كانا زوجَين مقربَين
مراعِيَين، لم ينجحا في إنتاج أجيالٍ جديدة، ولكنهما
نجحا في علاقتهما معًا، وبقي كلٌّ منهما بجانب الآخر
ثماني سنواتٍ كاملة. كان كلٌّ منهما ينظف الآخر بمنقاره
بانتظام؛ وهو سلوكٌ كتب عنه الباحثون في إحدى المقالات
أنه: «يُفترَض أن له دورًا في تقوية الروابط بين الزوجين
والمحافظة عليها»،
56 مثلما تُعمِّق اللمسات الحانية المتكررة
المشاعر التي تدعم علاقاتنا البشرية. عندما ماتت شريكة
«إيه بي»، تخلَّى عن منطقته وقضى أواخر حياته ينبش عن
الطعام في مصنع سمادٍ محلي. يتساءل ماكجوان إذا كان «إيه
بي»، الذي انفطر قلبه، يُفكر ببساطة: «لقد ماتت زوجتي.
فما الذي قد يَجعلني أُريد الدفاع عن هذه المنطقة بعد الآن؟»
⋆
من الأنواع الأخرى المُخلصة لشريكها الإوز الكندي،
تختار تلك الطيور شركاءها عندما يبلغ عمرها عدة سنوات،
وغالبًا ما يبقى الشريكان معًا طوال حياتهما التي قد
تمتدُّ عقدًا أو عقدَين من الزمن. إنها أحد الزوَّار
المُعتادين لبركة تجميع مياه الأمطار. لا يشجعها على
التعشيش عندها نبات البوط الكثيف الذي يُحيط بها، ولكن
في أواخر الشتاء، في مطلع الربيع، يتجمَّع العشرات منها
عند الماء. وتجِدها تتشقلب لتقفز في الماء، ويؤدي بعضها
طقوس المغازلة المعقدة، حيث يقوم الشريكان بغمس رأسيهما
بشكلٍ مُتكرر وهما يقفان متقابلَين فيصنع عنقاهما، عند
النظر إليهما من الجانب، شكل قلب.
هذه الطقوس التي يصِفها الأكاديميون بأنها «تنسيق بين
الأفراد»، لا تقتصر على الإوز الذي يبحث عن شريكٍ
للتزاوج؛
57 إذ إنها تساعد أيضًا في الحفاظ على العلاقات
القائمة بالفعل. في حين أنه لا توجَد أبحاث كثيرة عن
الحياة العاطفية بين الشريكين لدى الإوز الكندي، فإنه
توجَد كثير من الأبحاث عن الإوز الأربد الذي تربطه بذلك
الأول صِلة قرابة وثيقة، كما أنه أحادي الشريك مِثله.
أفراد الإوز الأربد الذين تربطهم بإناثهم علاقات طويلة
الأمد أقلُّ تعرضًا لإجهاد التنافُس مع الذكور الآخرين
على الشركاء؛
58 إذ يُطمْئنُ الشريكان أحدُهما الآخر ويُصيب
كلَيهما التوترُ إذا انفصلا.
59 لم يكن لدى كونراد لورنز، عالم سلوك الحيوان
الحائز على جائزة نوبل، الذي درس علاقات الإوز الأربد،
أي تحفُّظات بشأن مقارنة حُزن تلك الطيور بِحُزننا. كتب
لورنز: «إن قدرة الإوز على الحُزن تُضاهي قدرة البشر،
ولن أقبل الرأي القائل بأن ذلك يُعَد من قبيل الأنسنة
المرفوضة.»
60 لاحظ لورنز أن الإوزات التي تُوفي عنها
شريكها صارت متبلِّدة، وخمولة، وفقدت شهيَّتها للأكل؛
وتلك مؤشرات واضحة للاكتئاب البشري قد تستمرُّ
شهورًا.
في بعض الأحيان تتخذ الإوزات التي مات شريكها شريكًا
جديدًا. وفي بعض الأحيان لا تفعل ذلك. أصبحت الإوزة
الكندية، التي ظلَّت تعود يوميًّا مدة ثلاثة أشهر إلى
المكان الذي صدمت فيه سيارةٌ شريكَها خارج مركز تسوُّق
في مدينة أتلانتا بين مطعم «بابا جونز بيتزا» ومتجر
«فيرست بايداي»،
61 شخصية محلية مشهورة قبل أن يتبنَّاها مُنقذو
حيوانات محليون. أكثر ما لفت النظر في هذه القصة ليس
حدوثها، إنما المكان الذي حدثت فيه. تزخر منتديات
الإنترنت بقصص عن إوزٍ مكلوم غير قادر أو عازف عن الحُب
من جديد. مرة أخرى، التفسير العلمي لهذه الروابط الوثيقة
بين الشريكَين التي تنكسر بموت أحدهما هو أنها تضمن
تعاونًا أوثق بينهما في تنشئة فراخهما،
62 ومن ثَم نشر جيناتهما؛ ولكن هذا التفسير لا
يُبين شعور تلك الطيور.
بالطبع، تتضمن تلك الأمثلة أنواعًا أحادية الشريك
طويلة العمر نسبيًّا، يُعَد تاريخ حياتها تربةً خصبة
لتطوُّر الانفعالات القوية — إذ تقوي حسَّ الشراكة — وهو
غير شائع نسبيًّا في مملكة الحيوان،
63 وإن كان أكثر شيوعًا بين الطيور. سيكون من
الخاطئ أن ننظر إلى جميع أنواع علاقات الشراكة بين
الحيوانات بهذا المنظور، كما أنه من الخاطئ أيضًا أن
نَعتبر أن الحيوانات المتعددة الشريك لا تُكِنُّ أي
مشاعر لشركائها. ولكن بصرْف النظر عن هذه الاختلافات،
يُمكننا أن ننظر إلى الإوز في البركة بطريقةٍ أخرى؛
باعتباره رمزًا للانفعالات التي توجَد في جميع
الكائنات.
ما الذي يجعل أي ذكرٍ وأنثى من الإوز ينجذبان أحدُهما
إلى الآخر في المقام الأول؟ كيف اختار هذان الشريكان
اللذان يؤدِّيان رقصاتهما المائية في البركة أحدهما
الآخر؟ تتضمَّن التفسيرات الأساسية، بالنسبة للإوز وغيره
من الحيوانات، خصائص جمالية مقترنة بالنجاح التكاثري مثل
الأبدان الكبيرة والريش السليم والأفعال التي تستعرض
مهارات التناسُق البدني. لكن، مثلما ذكرنا عن لذَّة
التذوُّق والتغذية، فإن المكاسب لا تُحسَب عقلانيًّا،
ولكنها تُشكل ردًّا موضوعيًّا على السؤال. فالأرنب
يستحسِن مذاق الأطعمة المُغذية له؛ ويفترض بعض العلماء
الآن أن دينامية مُماثلة تنطبق على السِّمات الجمالية.
أي إن العين تستحسن السِّمات المهمة للبقاء،
64 وهي ظاهرة عاطفية تكمُن في جوهر السمة التي
نُسميها الجمال. الإوزة حين تنظر إلى شريكها، والسنجاب
حين ينظر إلى شجرة مجوفة قديمة، والنحلة الطنَّانة حين
تنظر إلى زهرة قُمعية: ربما تجد تلك الكائنات في تلك
الأشياء ما يسرُّ عينها ويغمرها بالرضا.
الهوامش
⋆
حتى بعد أن تبوَّأت الغرابِيَّات مكانة بارزة في
أبحاث الذكاء الحيواني والعلوم المبسطة، فإن
الاهتمام بالجوانب العاطفية من حياة الغراب لم
يحظَ بعدُ بالاهتمام الكافي. عندما أشارت دراسة
لما يُسمَّى «جنازات الغربان» — حيث يتجمَّع
العشرات أو المئات من الغربان حول غرابٍ ميت —
إلى أن الغربان تستكشف التهديدات المُحتملة من
خلال فحص الجثة، عرضت الصحافة الجماهيرية نتائج
الدراسة كما لو أنها تدحض فكرة أن الغربان تحزَن
لموت رفاقها. غير أن الدراسة لم تدحض تلك
الفكرة.
تقول كايلي سويفت، المُعِدَّة الرئيسية لتلك
الدراسة: «التعلُّم من الخطر هو بالتأكيد أحد
جوانب هذا السلوك، ولكن ليس بالضرورة الجانب
الوحيد له.» عُرِضَت للغربان التي أُجرِيت عليها
الدراسة جُثث لغربان مجهولة لها؛ ربما كانت
ستتفاعل بشكلٍ مختلف مع الغراب النافق إذا كان
من العائلة أو الأصدقاء أو الشركاء. لكن بالطبع
إجراء مثل هذه التجربة على الأرجح غير أخلاقي
مُطلقًا، وذلك الموقف يكشف لنا الصعوبات التي لا
تزال قائمة في دراستنا للانفعال. تقول كايلي:
«أي عالم يدرس الغربان يُفكر كثيرًا في هذا
الأمر. كل ما هنالك أننا لا نملك طرُقًا لطرح
هذه الأسئلة على الغربان.»