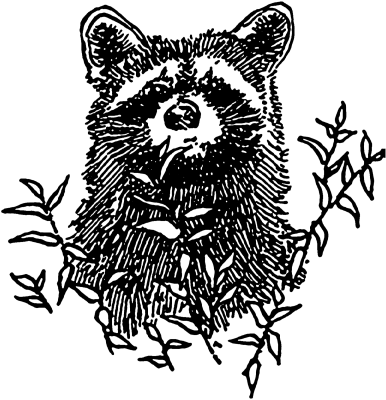الفصل الرابع
منظومة أخلاقية جديدة للتعامُل مع الطبيعة
في لوحة الرسام الفرنسي إميل-إدوارد موشي التي رسمَها
عام ١٨٣٢، «عرض فسيولوجي لتشريح كلب حي»،
1 يتجمَّع ثلاثة عشر رجلًا حول كلبٍ مربوط من
ساقه وعُنقه في طاولة. الغرفة مظلمة، مصدر الإضاءة
الوحيد فيها نافذة علوية يسطع ضوءُها على رَجل يرتدي
معطف طبيب أبيض ويُشمِّر عن ساعديه، يشق صدر الكلب بمشرط
جراحي. يحاول الكلب الإسبانيل ذو الفرو البُني والأبيض
باستماتةٍ التملُّص من الحبال، وقد فغر فاه وراح يعوي
ألمًا. لطَّخت الدماء فروه. يُراقبه الرجال بانتباهٍ
شديد، ويُدوِّنون الملاحظات ويتناقشون وينظرون داخل
الجرح من كثب. يُجاهد كلبٌ آخر مربوط على الأرض للوصول
إلى قريبه المُقيد.
لا نعرف كيف شعر موشي نفسه تجاه هذه اللوحة الدموية.
ربما هالته وروَّعته. لكن الإضاءة المُستخدَمة في اللوحة
تُرجِّح أنه اعتبرها تجسيدًا حَرفيًّا للتقدُّم
التنويري. في كلتا الحالتَين، هي توثق بصدق لمشهدٍ كان
شائعًا في «عصر المنطق»، الذي تعلَّم فيه العلماء
والأطباء علم وظائف الأعضاء من خلال عمليات تشريح
الكائنات وهي حية، التي قد تطول لأيام. كتب واحد ممَّن
شهدوا تلك العمليات: «كانوا يضربون الكلاب بتبلُّدٍ تام،
ويسخرون من أولئك الذين يُشفقون على تلك المخلوقات كأنما
تشعُر بالألم. كانوا يقولون إن الحيوانات آلات زنبركية،
وإن الصيحات التي تُصدرها عند ضربها ليست إلا صوت زنبرك
صغير طالته الضربة.»
2
كان ذلك الشاهد أمين سِرٍّ في الجماعة الجانسينية
المُترهبنة، وهي جزء من حركة كاثوليكية مرتبطة برينيه
ديكارت، الفيلسوف والرياضي والعالم في القرن السابع عشر،
الذي يوصَف أحيانًا بأنه أبو الفلسفة الحديثة. اشتهر عن
ديكارت تشبيهه للحيوانات بالآلات الذاتية
الحركة؛
3 اعتبر ما يبدو لنا وعيًا لدَيها مجرد وهْم،
فوحدهم البشر يملكون أرواحًا ومِن ثَم عقولًا. أما
الكائنات الأخرى فهي في جوهرها ليست إلا دُمًى زنبركية
مصنوعة بدقة. بقدْر ما يبدو ذلك للإنسان المعاصر
عبثيًّا، فإنه كان يستنِد إلى منظومة اعتقادية
راسخة.
قبل ديكارت بوقتٍ طويل، وجَّه الفيلسوف اليوناني أرسطو
— الذي يمكن القول إنه المُفكر الأكثر تأثيرًا في
التاريخ الغربي — اهتمامه إلى الحيوانات.
4 وصف حيوانات سواحل البحر الأبيض المتوسط
بتفصيلٍ دقيق؛ مهَّد مُخططه التصنيفي المنهجي لعِلم
التصنيف الحديث، وفي بعض الجوانب كان يُقدِّر الذكاء
الحيواني.
5 تتضمَّن أعمال أرسطو المتعلقة بعلم الحيوان
مَقاطع تصف تفكيرها؛ فوصف أخطبوطات تُخفي نفسها عن قصدٍ
وسط سحب من الحبر، وأنواعًا مُعينة من الماعز البري
تُداوي جروحها الناجمة عن إصابتها بالأسهم بالأعشاب،
ودلافين رعت طفلًا ميتًا كما لو كانت مدفوعة بالشفقة،
وقارن تواصُل الطيور بالكلام. ووضع البشر على مقياسٍ
تدريجي واحد مع الحيوانات، واعتبرهم مُختلفين في الدرجة
وليس في النوع.
في الوقت نفسه، هذا المقياس التدريجي كان موجودًا على
«سلم الطبيعة»،
6 وهو تسلسل هرمي ليس تصنيفيًّا فحسب، بل
أخلاقي أيضًا، توجَد الكائنات العقلانية — البشر — في
قمَّته. في كتاباته السياسية، وصف أرسطو الحيوانات بأنها
غير قادرة على التفكير العقلاني.
7 وقصر نطاق خبراتها على الجوع والألم. ونظرًا
لافتقار الحيوانات إلى العقل والقُدرة على الكلام، فقد
أقصاها من المدينة الدولة «البولِس» أو من مجتمعه
السياسي المقدس. إذ اعتبر ذلك التواصل بين الطيور ليس
إلا محض ضجيج. كان أرسطو هو من غرس ذلك المفهوم. ومثل
الأجيال العديدة من أشجار الحور التي تنبت من جذور
واحدة، ظلَّت هذه الحجة تتكرَّر في الفكر الغربي على مدى
الألفَي عام التالية؛ وكانت بمثابة حاجزٍ تصنيفي يفصل
البشر عن سائر الحيوانات الأخرى، حاجز قائم على سِمةٍ
إدراكية مُعينة يعتبر غيابها مبررًا لإسقاط حق الحيوانات
في المكانة الأخلاقية.
غير أنه، لو كانت آراء أرسطو بشأن الحيوانات متضاربة،
فإن الرواقيين الذين أتوا بعده كان رأيهم قاطعًا لا لبس
فيه.
8 اعتقدوا أن الحيوانات غير قادرة على
التفكير، وجعلوا العقلانية شرطًا ليس فقط للعضوية
السياسية، ولكن أيضًا للحق في الأرض. يقول الفيلسوف
الرواقي بالبوس متسائلًا: «هب أن أحدَهم سأل لمن أُنشئ
هذا الصرح العظيم (يعني العالم)؟ هل للأشجار والنباتات،
التي رغم افتقارها للوعي تعتمِد على الطبيعة؟ لا، هذا
غير معقول. هل للحيوانات؟ لا، لا يُعقَل أن تكون الآلهة
قد بذلت كل هذا الجهد من أجل الحيوانات البكماء الجاهلة.
إذا سألت أي أحدٍ لأجل من خُلِق العالَم؟ فسيقول لك إنه
خُلِق قطعًا لأجل الكائنات الحية العاقلة؛ أي لأجل
الآلهة والبشر.»
9
على النقيض من الرواقيين، جعل الإبيقوريون — الذين يظل
اسم مذهبهم يُستخدَم حتى اليوم لوصف الذوق الرفيع في
الطعام والشراب — المتعة الحسية، لا العقل، فضيلتهم
العظمى. لكنهم هم أيضًا ازدرَوا الحيوانات،
10 وأضافوا المتعة الحسية باعتبارها سِمة مميزة
للإنسان بجانب العقل. ادَّعى إبيقور أن الحيوانات «لا
تملك القدرة على التعهد بعدم إيذاء بعضها أو عدم
التعرُّض للأذى»؛ لذلك بالنسبة لهم «لا يوجد عدل ولا
ظلم.» بعبارة أخرى، جوهر الأخلاق هو المعاهدات الرسمية،
التي تعجز عن عقدها الحيوانات؛ من ثَم فإنها لا تملك
أخلاقًا ولا تستحق أن نوليها اعتبارًا أخلاقيًّا.
غير أن ذلك لم يكن رأي جميع المفكرين الإغريق. في
كتابَيه «عن ذكاء الحيوانات» و«الحيوانات عقلانية»، يُقر
بلوتارخ أن للحيوانات «غاية وإدراكًا وذاكرة وعواطف»،
ويُقر لها كذلك ﺑ «الشجاعة والنزعة الاجتماعية وضبط
النفس والشهامة.»
11 في الواقع، اعتبر الحيوانات، من ناحية، أكثر
عقلانية من البشر لأنها لا يُغريها ترف ولا إسراف. وبعده
بعدة قرون، ندَّد فرفوريوس بأولئك الذين رفعوا مكانة
البشر بتحقيرهم من شأن الحيوانات، وشبَّه ذلك بإنكار
قدرة طائر على الطيران لمجرد أن طائرًا آخر يستطيع
الطيران إلى ارتفاع أعلى. كتب فرفوريوس مستنكرًا: «لكن
إذا كانت العدالة سِمة مقتصرة على الكائنات العقلانية،
كما يقول خصومنا، فكيف لنا أن ننكر أن علينا أن نكون
عادلين تجاه الحيوانات أيضًا؟»
12
هذه الآراء لم تكن سائدة، لكن يجدُر الإشارة إليها.
فالطريق إلى فهم عقول الحيوانات كان ملتويًا، مبتدؤه
الإنكار الخاطئ، لكن المتفهَّم؛ لأن لها عقولًا من
الأساس، ومُنتهاه الإقرار المعاصر لها بالعقل. وما بين
هذا وذاك، ظلت قدراتها محل جدلٍ لآلاف السنين، وظلت
المفاهيم الخاطئة القديمة تُتوارث من عصر إلى آخر. وظل
هذان المنظوران يُشكلان نظرة الناس للحيوانات؛ فهُم إما
اعتبروها أشياء يجب استغلالها وإما أقارب يجِب مُعاملتها
معاملةً أخلاقية.
كانت التيارات العلمية والفلسفية التي استمرَّت هي تلك
التي تعتبر الذكاء البشري هو الذكاء الوحيد الذي له وزن.
العِلم الآن يقوِّض ذلك الاعتقاد، لكن الاكتشافات
الجديدة لن تمحو تبعاته بسهولة. ساهم إنكار الذكاء
الحيواني في إرساء أُسس مجتمعنا، ولا يزال يشكل أفكارنا
عن الحيوانات، وعلاقاتنا بها وبالطبيعة إجمالًا. هذه
الموروثات الثقافية تظلُّ قائمةً رغم تآكُل الأسس التي
بُنيت عليها، ومن شأن مراجعتها أن تفتح لنا سبلًا مختلفة
للحياة.
•••
رغم أن أرسطو عاش قبل المسيح بعدة قرون، فقد تبنَّى
المفكرون المسيحيون في العصور الوسطى «سلم الطبيعة» الذي
رتَّبه، لكنهم أضافوا إليه الله والملائكة في درجة فوق
البشر وأسمَوه سلسلة الوجود العظمى.
13 كما أنهم احتفظوا بالتقليد الذي يُشدد على
الاختلافات بين البشر والحيوانات، وتَعزو المؤرخة جويس
سالزبري ذلك إلى رغبة المفكرين المسيحيين الأوائل في
تمييز أنفسهم عن الوثنيين.
14
كتبت جويس سالزبري: «لقد أنكروا العديد من المُعتقدات
التقليدية، بما فيها من مواقف تجاه الجنس والترفيه
والاستحمام والمُمارسات الاجتماعية والثقافية الأخرى.
ومِن ضمن ما أنكروه أيضًا كان وجهة النظر التقليدية التي
تعتبِر البشر والحيوانات مُرتبطين برباطٍ وثيق.»
فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلقَه الله على
صورته.
أكد الفيلسوف ألبرت الكبير في القرن الثالث عشر أن
نُطف الحيوانات لا تتأثَّر بالأجرام السماوية.
15 وكتب أن رُباعيات الأرجل تمشي على أربع لأن
«حرارتها الفطرية غير كافية لجعلها تمشي مُنتصبة.» يبدو
أنه اعتبر المشي على قدمَين وظيفة لدرجة حرارة الجسم.
أما بالنسبة للاختلافات العقلية، فإن افتقار الحيوانات
البادي للعقلانية كان هو السِّمة المميزة للحيوانات.
وفسَّر اللاهوتيون السلوكيات المُعقدة في ضوء الغريزة
فقط؛ على سبيل المثال، هروب الأغنام من الذئب ليس فعلًا
واعيًا، إنما هو كفعل شخصٍ يسحب يدَه إذا اقتربت من
اللهب. كتب القديس توما الإكويني، الذي كان أحد تلاميذ
ألبرت الكبير، وشكلت تعاليمه الفكر الكاثوليكي، أن
الحيوانات «تفتقر إلى العقل»، وأن استجاباتها الغريزية
«حتمية مثل تصاعد لهب النار لأعلى.»
16 وكان مفتونًا بالساعات الميكانيكية، فشبَّه
الحيوانات بالآلات، وبذلك كان هو واضع ذلك الاعتقاد الذي
أشهره ديكارت لاحقًا.
كتبت جويس سالزبري أن اعتقاد الفلاسفة في العصور
الوسطى في افتقار الحيوانات للعقل؛ مِن ثَم افتقارها
لروح خالدة «كان هو أساس مُعتقدهم في السيادة «الطبيعية»
للإنسان على الحيوانات»، وقطعًا على الطبيعة وكل ما فيها
من مجتمعات. كتب فرانسيس بيكون، الفيلسوف والسياسي الذي
ابتكر المنهج العلمي، والذي يُعَد مؤسس العلوم الحديثة
إلى جانب جاليليو: «فليستعِدِ الجنس البشري حقَّه في
الطبيعة التي هي ملك له بالأمر الإلهي.»
17 كان بالبوس والرواقيون سيفخرون به.
جاءت الثورة العلمية والتنوير فأزاحا المسيحية من
موقعها السيادي في ساحة المعرفة الغربية، لكن المواقف
اللاهوتية تجاه الحيوانات والطبيعة ظلَّت قائمة، بل إنها
تطوَّرت وصارت مدعومة ظاهريًّا بالموضوعية والإحكام
اللذَين تتَّسم بهما العلوم. جسَّد تشبيه ديكارت
للحيوانات بالآلات الذاتية الحركة إيمانَه بانفصام
المادة والروح؛ إذ اعتبر أن أفعال أجساد الحيوانات لا
علاقة لها بعقولها. ولأن الحيوانات تفتقر إلى القُدرة
على التفكير، فإن عقولها فارغة فعليًّا، حتى من الوعي
بالألَم أو الجوع أو العطش. وكان دليل ديكارت على ذلك هو
افتقار الحيوانات للُّغة.
18 كتب ديكارت: «حتى الحمقى والأغبياء
والمخابيل، قادرون على التعبير عن أفكارهم بطريقةٍ
مفهومة»، ولكن لا يمكن لحيوان أن يفعل ذلك، وهو ما
«يُثبت أن الحيوانات ليست أدنى عقلًا من البشر فحسب، بل
إنها لا تملك أي عقلٍ من الأساس.»
تبع ديكارت مُفكرون — يُعَدون الآن من الثقات — أسهبوا
في ذلك التمييز التصنيفي بين البشر والحيوانات. كان منهم
توماس هوبز، مؤسس العقد الاجتماعي، الذي تبنَّى مزعم
إبيقور بأن الحيوانات لا تستطيع عقد معاهدات رسمية، من
ثَم ليس لها حقوق؛ وجون لوك، الذي اعتقد أنه في حين أن
بعض حقوق الإنسان طبيعية غير قابلة للمصادرة، فإن ذلك لا
ينطبق على الحيوانات؛ وإيمانويل كانط، الذي ورِثنا عنه
المبدأ القائل بأن كل إنسان له قيمة جوهرية، ويجب ألا
يُعامل باعتباره وسيلةً لتحقيق مآرب إنسانٍ
آخر.
19 ولكن كانط كان يرى أنه يمكن للإنسان أن
يعامِل الحيوانات باعتبارها «وسائل وأدوات لتحقيق أي
غاية شاء.»
20
شجَّع كانط الناس على أن يمتنُّوا لحيواناتهم على
خدمتها لهم، وعلى ألا يقتلُوها، وإن كان لا بدَّ لهم من
قتلِها فليفعلوا ذلك بوسيلةٍ رحيمة؛ لكن ليس لأن
الحيوانات تستحق الاعتبار والشفقة. إنما لأن مخالفة ذلك
تمسُّ بالفضيلة الإنسانية. كتب الفيلسوف آرثر شوبنهاور
الذي عاصر كانط مُستنكرًا: «إذَن الغرَض الوحيد من
الرأفة بالحيوانات هو مُمارسة الفضيلة!»
21 وكان شوبنهاور واحدًا من بين العديد من
فلاسفة عصر التنوير الذين عارضوا هذه الفكرة، مثلما عارض
بلوتارخ آراء أرسطو. فقد كان يتَّفق مع أن الحيوانات
تفتقر إلى العقل، ولكنه كان يرى أن هذا ليس أمرًا ذا
بال. فهي تستطيع الشعور بالمُعاناة؛ ومِن ثَم تستحق
الرأفة. عبَّر جيرمي بنثام، مؤسس مذهب النفعية الفلسفي
الحديث، عن هذا في مقولة تتردَّد كثيرًا اليوم: «السؤال
ليس: هل هي قادرة على التفكير؟ ولا هو: هل هي قادرة على
الكلام؟ إنما السؤال هو: هل تحسُّ بالمعاناة؟»
22
مِن أبرز فلاسفة عصر التنوير الذين تعاطفوا مع
الحيوانات أيضًا توماس باين وجون ستيوارت ميل
وفولتير،
23 الذين اعتبروا أنه من غير المنطقي أن تمتلك
الحيوانات الفسيولوجيا المُنتجة للمشاعر البشرية دون أن
تختبِرها.
24 ذلك الجدال إنما يؤكد أمرَين: أولهما أن
إنكار الذكاء الحيواني لم يكن حتميةً فكرية بل هو تفضيل،
وثانيهما أنه كان جزءًا لا يتجزأ من رؤيةٍ أباحت للإنسان
«تملُّك الطبيعة واستغلالها» على حدِّ تعبير عالِمَي
البيئة فريدريك دوكريم ودينيس كوفيت في تأريخهما لفهم
الإنسان للطبيعة.
25 كانت منظومة اعتقادية ملائمة تمامًا للفكر
الاستعماري القائم على المحو الوحشي للمُجتمعات البشرية
واستغلال البشر، وغير البشر كذلك.
بالطبع، كانت ثَمة مذاهب أخرى لفهم الحيوانات
والعلاقات معها. رغم عدم إمكان اختزال الثقافات
المُتنوعة قبل الاستعمارية في كيانٍ واحد، فمِن الإنصاف
القول إنها كانت تَشيع فيها فكرة أن الحيوانات تتشارك في
الخصائص العقلية الأساسية مع البشر،
26 وأن البشر لديهم التزام أخلاقي نحوَها،
وأنهم مجرد جزء من العالم وليسوا مِحوره الميتافيزيقي.
لكن لمَّا ساد الاستعمار، انتصرت وجهات النظر التي
تَعتبر الحيوانات غير عاقلة والطبيعة موردًا، وأبادت
المنظومات القِيَمية للشعوب الأصلية بالمعنى الحرفي. في
الوقت نفسه، حتى العلاقات الاستعمارية الإيجابية مع
الطبيعة عكست التراث الفكري للمُستعمِر.
وردت إحدى الحكايات التي توضح ذلك على لسان جون جيمس
أودوبون، الفنان الكبير وعالم الطيور، الذي سُمِّيت على
اسمِه جمعية أودوبون المَعنية بحماية الطيور، حين كتب عن
صباحٍ قضاه مع مُزارِع أسَر ثلاثة ذئاب في حفرة. روى
أودوبون أن الذئاب «كانت مُستلقية على الأرض، مُرخِيةً
أذنَيها، لا تعكس عيناها الغضب بقدْر ما تعكس الخوف.» لم
تقاوم الذئاب المزارع عندما قفز إلى الحفرة وقطع أوتار
أرجلها الخلفية، وربطها بالحبل. ساعد أودوبون، الذي كان
«سعيدًا بهذه الفرصة»، المُزارع في رفع الذئب الأول من
الحفرة.
كان الذئب «متجمدًا خوفًا كما لو كان ميتًا، تتأرجح
رجلاه المَعطوبتان، فاغرًا فاه، لا يدلُّ على أنه لا
يزال حيًّا إلا الغرغرة التي تدوي في حلقه.» لم يقاوم
الذئب عندما أسقطه المُزارع على الأرض كي تُقطِّعه كلابه
إربًا. لم يقاوم الذئب الثاني أيضًا. لكن الذئب الثالث
«أظهر شيئًا من الهمَّة»؛ إذ «اندفع يعرج على رجلَيه
الأماميتَين بسرعة مفاجئة، وكان يُطبق فكَّيه من حينٍ
لآخر»، وتمكَّن من عض أحد الكلاب قبل أن يُطلق المزارع
النار عليه. عندئذٍ «شفَت منه الكلاب غليلها.»
27
قتلتِ الذئاب العديد من أغنام المُزارع وأحد خيوله.
وكانت رغبته في قتلِها مُتفهَّمة. لكن المُريع في الأمر
هو الوحشية التي فعل بها ذلك وتلذَّذ أودوبون بالمشهد.
تلك الواقعة تُجسد علاقة بالطبيعة يُقدِّر فيها الإنسان
بعض الحيوانات، بل يعتزُّ بها، لكنه يعامل البعض الآخر
باعتباره فرائس يصيدُها على سبيل المُتعة. علاقة تخلو من
الرحمة والاتساق الأخلاقي وحتى التفكير المُتمعن. كان
أودوبون محبًّا للطبيعة وأحد أوائل نشطاء الحفاظ على
البيئة، لكنه نشأ في عالم متطبع على أن الإنسان سيد
الطبيعة.
•••
برز تشارلز داروين بالأخص بسبب وجوده في العصر الذي
عاش فيه. كان متشربًا لعقيدة تفرُّد البشر باعتبارهم
فئةً منفصلة، لكنه وصف الحيوانات وصفًا متعاطفًا؛ إذ قال
عنها إنها «شركاؤنا في الألم والمرَض والموت والمُعاناة
والجوع، وعبيدنا في الأعمال الشاقة، ورفقاؤنا في المرح»،
وتتْبَع أصولها وأصولنا سلفًا مُشتركًا.
28 تبنَّى داروين تداعِيات نظرية التطوُّر؛ إذ
قال «إننا نشترك مع الحيوانات العُليا في أغلب المشاعر
البالِغة التعقيد»، وإن «الفرق بين التفكير لدى
الحيوانات والبشر هو فرق في الدرجة وليس في
الطبيعة.»
29
مهَّدت دراسات داروين لترجيح كفَّة المنظور الذي يعتبر
الحيوانات كائناتٍ تُفكر وتشعر، في أواخر القرن التاسع
عشر. فقد كرَّس تلميذه جورج رومانيس، حياته المِهنية
لدراسة خبراتها العقلية. لكن اليوم، يشتهر عن رومانيس
إهماله؛ إذ كان يقبل القصص الشفهية دون أن يتثبَّت منها،
مثل قصة بلا إثبات رواها له شخص سمِعها من شخصٍ آخر عن
قرد مدَّ كفَّه الدامية لصيَّاد لإشعاره
بالذنب.
30 يزعم الاعتقاد السائد أن هذا التسليم بصحَّة
الروايات دون أدلةٍ كان يُهدد بإشاعة الفوضى في مجال
دراسة سلوك الحيوان.
يمكن القول إن الأساليب العلمية لرومانيس وأقرانه كانت
أكثر إحكامًا ممَّا نعتبرها الآن، وإنهم وقعوا ضحايا لرد
الفعل العنيف والمُتفهم لشيوع توجُّه بحث الظواهر الخفية
والخارقة للطبيعة في مجال علم النفس في تلك
الحقبة.
31 على أي حال، ثار العديد من العلماء على ذلك
التوجُّه؛ وظهر نموذج جديد. وضع لوي مورجان، تلميذ
رومانيس معيارًا إرشاديًّا. إذ قال ناصحًا: «لا يجب على
الإطلاق تفسير نشاط حيواني في ضوء العمليات النفسية
العُليا، إذا كان يمكن تفسيره بالقدر الكافي في ضوء
العمليات ذات الرُّتبة الدنيا على سُلَّم التطور والنمو
النفسي.»
32
بعبارة أخرى: فلنفترِض أن الحيوان آلة ذاتية الحركة.
كان من المتوقَّع أن يُفسِّر العلماء السلوك في ضوء
الغريزة والاستجابة غير العقلانية لحين استبعاد جميع
الاحتمالات الأخرى بشكلٍ قاطع. كان لهذا المبدأ تأثير
عظيم، حتى إنه يُعرَف الآن باسم قانون مورجان، ورغم أنه
لا يُنكر ذكاء الحيوان فعليًّا، وإنما يطلُب دعمه بأدلة
حاسمة، فقد صعَّب على العلماء إثباته أكثر. تبع ذلك قرنٌ
عاد فيه العِلم لاعتبار الحيوانات آلات في الأغلب، وهو
موقف عبَّر عنه عالم السلوك الرائد بوروس فريدريك سكينر
بفصاحة؛ إذ وصف الحيوانات بأنها «واعية بمعنى أنها واقعة
تحت سيطرة المُحفزات.»
33 في أواخر السبعينيَّات، عندما افترض دونالد
جريفين في كتابه «مسألة الوعي الحيواني» أن الحيوانات
يُمكنها التفكير والاستدلال، اعتبرت الأوساط العلمية
ادعاءه ذلك متطرفًا.
34
بينما كان العلماء الذين يؤمنون بالذكاء الحيواني
المعقد يتعرضون للانتقاد، كان علماء الطبيعة البارزين
يتعرضون لهجوم مشابه.
35 في مطلع القرن العشرين، ازدهر اهتمام العوام
بالطبيعة، وبات علماء الطبيعة جزءًا بارزًا من الحياة
العامة. كان من أشهرهم إرنست تومسون سيتون الذي ساهم في
تأسيس منظمة الكشافة الأمريكية، وكتب إن «الحيوانات
مخلوقات لديها رغبات ومشاعر لا تختلف عن مشاعرنا
ورغباتنا إلا في الدرجة»؛
36 والشاعر الكندي تشارلز روبرتس؛ ووليام لونج،
الذي وصف الحيوانات بأنها أفراد تعيش في مجتمعات، وبأنها
تفكر وتشعر، وتعتمد على المنطق والتعلُّم.
37 لاقت كتب هؤلاء رواجًا كبيرًا، وبات
الجماهير يقرءون سِيَر الحيوانات التي أكَّدت على قَرابة
الإنسان والحيوان بدلًا من الأطروحات العلمية والدراسات
التطوُّرية.
لكن بعض ادِّعاءات هؤلاء الطبيعانيين كانت تستعصي على
التصديق، مثل قصة لونج عن ديك الغاب الذي عدل ساقه
المكسورة وغلَّفها بجبيرة من الطمي. أكسبهم ذلك عداوة
جون بوروز، الباحث في التاريخ الطبيعي الذي وصف لونج
ورفاقه بأنهم «صحفيو الصحافة الصفراء للغابات»،
38 ثم عداوة الصديق المُقرَّب لبوروز الرئيس
ثيودور روزفلت، الذي شجبهم علنًا واصفًا إيَّاهم بأنهم
«مدلسو الطبيعة». تصدر ما سُمي بجدل «مدلسي الطبيعة»
عناوين الصحف، ووصفته صحيفة نيويورك تايمز ﺑ «حرب خبراء
الطبيعة»، وظل السجال الكلامي دائرًا بين الفريقين
لسنوات، رغم أن لا أحد يكاد يذكُر ذلك الآن. لم تكن
المسألة مجرد محاولات فهم عقول الحيوانات، إنما الرؤية
الكونية برمَّتها. يروي المؤرخ رالف لوتس، أن الاهتمام
بالطبيعة تزايد حين بدأ المجتمع يُعيد النظر في علاقته
مع الكائنات غير البشرية بعد التوسع العمراني إلى ما
وراء حدود المُستوطنات الأمريكية. كتب لوتس: «كان عشاق
الطبيعة يتعاطفون مع «أقربائهم المساكين»، ويُعيدون
النظر في علاقتهم مع العالم الطبيعي من الناحية
الأخلاقية والبيئية، ويسعون لحماية الحياة
البرية.»
39 وتدريجيًّا، تبنَّوا وجهة نظر تعتبر البشر
والحيوانات «يشتركون في الأساس الأخلاقي، ويتشابهون في
الخبرات الانفعالية والعقلية.»
في هذا السياق، تظهر انتقادات «مُدلسي الطبيعة» أيضًا
باعتبارها موقفًا دفاعيًّا مضادًّا لنظامٍ أخلاقي جديد.
وقد كان بوروز نفسه واضحًا بشأن ذلك. في مقالٍ بعنوان
«آلات ذات فراء وريش»، كتب بوروز: «أنا لا أقبل أن
أُساهم، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، في قتل كائنات أتشارك
معها في هِبة العقل. لكن لحُسن الحظ ذلك رأي يكاد لا
يدعمه أي أدلة.»
40 أما بالنسبة إلى روزفلت الذي كان يهوى الصيد
الترفيهي، وقتل في رحلة استكشافية واحدة في أفريقيا ما
لا يقلُّ عن ١١٤٠٠ حيوان،
41 وكتب عنه لونج أنه «في كل مرة يدنو فيها من
قلب حيوان برِّي لا يسَعه إلا أن يضع فيه
رصاصة»،
42 فلا شكَّ أن العداء كان شخصيًّا.
في نهاية المطاف، كانت الغلبة لبوروز وروزفلت
وأنصارهم، الذين كان منهم فريدريك لوكاس، الذي أصبح فيما
بعدُ مدير المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وكلينتون
هارت ميريام، رئيس مكتب المسح البيولوجي بالولايات
المتَّحدة. واصل معارضوهم الكتابة، لكنهم قصروا كتاباتهم
على فئة الأدب الخيالي. في العقود التي تلت ذلك، باتت
الحيوانات البرية محلَّ اهتمام مؤسسات إدارة الحياة
البرية التي تُركز على صيد الأسماك والقنص ونصب الفخاخ؛
وتبنَّى العلم المذهب السلوكي القائل بأن الحيوانات مجرد
آلاتٍ تستجيب للمُحفزات؛ وتشكَّلت المواقف الجماهيرية
تجاه الطبيعة في بيئةٍ تنبذ معاملة الحيوانات باعتبارها
كائناتٍ تُفكر وتشعر.
لفترة من الزمن، ساد الاعتقاد بتشارُك البشر
والحيوانات في السِّمات العقلية والجسدية، غير أن ذلك
الاعتقاد طواه النسيان لاحقًا. تأمَّل الفهم الحديث لجون
موير، وهو أحد مناصري البيئة وأول رئيس لنادي سييرا،
الذي وصف «إنسانية» الحيوانات التي عرفها في المزرعة
التي نشأ فيها؛
43 وهي رؤية متعاطفة تتعارَض مع «الاعتقاد
البغيض القاسي المُضلل بأن الحيوانات ليس لها عقل ولا
روح، ولا حقوق يجب أن نُراعيها، وأنها خُلقت فقط لخدمة
الإنسان.» وقد عمَّم موقفه هذا على البرية التي عشِقها،
وكتب عن الحيوانات باعتبارها «مواطنين إخوة»، و«أشخاصًا
ذوي ريش»، و«إخوة يشاركوننا الأرض»، وأدان بشدةٍ الصيد
الترفيهي باعتباره «قتلًا».
44
«متى ستتجاوز رغبتك الصبيانية في قتل الحيوانات؟» هكذا
وبَّخ موير روزفلت أثناء رحلتهما الشهيرة للتخييم في
منطقة يوسمايت، التي أوحت إلى روزفلت بفكرة إنشاء منظومة
المُتنزَّهات الوطنية الأمريكية.
45 بصرف النظر عن اشتهار موير بالحفاظ على
البرية، فإنه يُذكَر اليوم باعتباره زاهدًا ملتحيًا كان
يرى الله متجسدًا في جمال الطبيعة.
⋆
أما آراؤه عن الحيوانات، فنادرًا ما يذكرها أحد. في عام
٢٠٠٦، أقام نادي سييرا مسابقة كتابة مُنِح الفائز فيها
رحلة صيد إلى ألاسكا.
•••
مع تقدُّم القرن العشرين، لم تنمحِ وجهة النظر التي
تعتبر الحيوانات كائناتٍ ذكية، إنما سرَت على حيوانات
دون غيرها. في بعض السياقات، استمرَّت وجهة النظر تلك في
الازدهار؛ تأمَّل مثلًا التحوُّل إلى تربية الكلاب
والقطط بغرَض الرفقة بدلًا من الحراسة أو صيد الفئران،
ذلك التحوُّل الذي يُرجَّح أن يكون قد غيَّر نظرة الناس
للحيوانات أكثر من غيره. كما ظهرت الحيوانات المُفكرة
بكثرة في الثقافة الشعبية، مثل حكايات الأطفال والمنوعات
الترفيهية مثل مسلسل «الكلبة لاسي»، وسلسلة قصص الأطفال
«الدكتور دوليتل»، والأعمال الكلاسيكية مثل رواية «لا
تبكِ أيها الذئب».
لكنَّ الخطاب الرسمي كانت تسودُه رؤية قاصرة
للحيوانات. فتصوُّرات الطبيعة التي تؤكد على جمالها
وتعاليها وقيمتها الروحية لم تعتبر الحيوانات «مواطنين
إخوة» كما قال موير. بل إن جهود حماية المناظر الطبيعية
الواسعة النطاق مثل منظومة المُتنزهات الوطنية،
واستراتيجيات الإدارة المُتعددة الاستخدامات التي طبقتها
وكالات مثل مصلحة الغابات في الولايات المتحدة، صورت
الطبيعة على أنها ملاذ بديع أو مستودع للموارد. تعاملت
جهات إدارة الحياة البرية مع الحيوانات جميعًا باعتبارها
وحداتٍ قابلة للتبديل مُمثلة لأنواعها.
صدرت قوانين جديدة، مثل قانون لاسي لعام ١٩٠٠ وقانون
معاهدة الطيور المهاجرة لعام ١٩١٨، حمت بعض الحيوانات،
لكنها كانت مَعنية بها على مستوى الأنواع لا الأفراد. إذ
إن اعتبار المرء الحيوانات مجرد آلات ذات فراء وريش لا
يتعارَض مع رغبته في حمايتها من الانقراض. وهذا إرثٌ
حافظ عليه قانون حماية الثدييات البحرية، وقانون الأنواع
المُهددة بالانقراض الذي فاقه تأثيرًا؛ إذ كانا نتاج
حركة حماية البيئة التي نشطت في منتصف القرن، والتي رغم
تأثيرها البالِغ الأهمية ودورها في الحفاظ على العديد من
الأنواع من الانقراض، فقد جعلت شخصنة الطبيعة الأم أسهل
من شخصنة بطةٍ أُم.
بدأ تناول أعمق لعقول الحيوانات في العصر الحديث على
إثر حركة حقوق الحيوان الآخذة في الازدهار، والتي يُعَد
بيتر سينجر وتوم ريجان من أبرز مؤيديها. كان كتاب سينجر
«تحرير الحيوان» الذي صدر عام ١٩٧٥ عملًا محوريًّا.
46 إذ أدخل مسألة الحيوانات إلى ساحة الفلسفة
الحديثة، واعتبر القدرة على التفكير والشعور تتجاوز في
أهميتها تصنيف النوع؛ وأصرَّ على وجوب مراعاة اللذة
والألم لدى الحيوانات في الاعتبار الأخلاقي للمنافع
والمضار. تناول كتاب ريجان «إثبات حقوق الحيوان»، الذي
نُشر في عام ١٩٨٣،
47 نهجًا مختلفًا عن نهج سينجر النفعي. إذ أكد
على مبدأ الاعتبار الأخلاقي، الذي اعتقد أنه ينبغي أن
يشمل أي مخلوقٍ يمتلك «إدراكًا وذاكرة ورغبة واعتقادًا
ووعيًا ذاتيًّا ونية وإدراكًا للمستقبل.» رأى ريجان أن
أي مخلوقٍ يتمتع بتلك السِّمات لا يجوز معاملته باعتباره
وسيلة لتحقيق غاية، إنما باعتباره غاية في ذاته.
لكن كلًّا من ريجان وسينجر أغفلا بعض النقاط، لا سيما
فيما يتعلق بالمجتمعات البيولوجية — أي الأنواع
والجماعات والأنظمة البيئية — التي استبعدتها فلسفتاهما
من الاعتبار لأن هذه الجماعات في حدِّ ذاتها لا تملك
القدرة على الإحساس.
48 كانت الفيلسوفة البريطانية الراحلة ماري
ميدجلي، التي نُشر كتابها «الحيوانات وأهميتها» أيضًا في
عام ١٩٨٣، تتمتع بنظرة أشمل.
49 رغم أنها لم تحُزْ شهرة سينجر وريجان، فإن
مكانتها لم تنفك تتزايد بمرور الوقت. كانت ترى أن
الأفراد والجماعات كليهما لهما حقوق أخلاقية، غير أنها
لم تُعنَ بوضع القواعد الأخلاقية قدر عنايتها بمساعدة
الناس على التفكُّر فيها بإمعان.
عابت ماري ميدجلي على الفلاسفة انفصالهم عن الحيوانات؛
ليس من الجانب المفاهيمي فحسب، إنما أيضًا من جانب عدم
قضائهم وقتًا معها. وكانت ترى أنه لو كان ثَمة ما يُميز
البشر فسيكون الروابط العميقة التي نشعر بها تجاه
الحيوانات، والتي اعتبرتها مهمةً للتجربة الإنسانية
بقدْر الغناء أو الرقص. وكانت مفتونة بملاحظات جين جودال
عن مجتمعات الشمبانزي ودراسات علماء سلوك الحيوان مثل
كونراد لورنز، الذي سبق أن ذكرنا دراسته على الإوز
الأربد.
50 إذ بدأ هؤلاء ينتزِعون من المذهب السلوكي
هيمنته، ويقدمون معلوماتٍ جديدة عن الحيوانات «تُشعرنا
لا محالة بقرابتنا لها» على حدِّ تعبيرها.
51 انتقدت ماري ميدجلي كذلك تمجيد العقلانية
وعقلية الجشع التي تقِف وراء فكرة تَسيُّد البشر
للطبيعة.
صاغت ماري ميدجلي مفهوم «المجتمع المختلط»، الذي يقر
بأن حياة البشر تتضافر مع حياة الحيوانات والنباتات
والأنظمة البيئية، مما يستدعي تبنِّي أخلاقيات أكثر
ثراءً تعترف بمطالب كلٍّ منها. قد يكون تحقيق ذلك صعبًا،
لكن هذا لا يمنعنا من المحاولة. يُساهم في هذه المهمة
عنصرٌ كثيرًا ما يغيب عن نقاشات الفلاسفة. تقول: «الحُب
شأنه شأن التعاطف، ليس سائلًا نادرًا يجب ترشيد
استخدامه، إنما هو قدرة تزداد كلَّما
استخدمناها.»
52
في السنوات التي تلت نشر ماري ميدجلي وتوم ريجان وبيتر
سينجر لأبرز أعمالهم، ازدهر مجال أخلاقيات الحيوان
بالتزامُن مع الأبحاث العلمية التي تناولت عقول
الحيوانات. اتخذت العلوم الإنسانية ما يُسمَّى «المنعطف
الحيواني»؛
53 إذ ركَّز علماء الجغرافيا والأنثروبولوجيا
والاجتماع والتاريخ انتباههم على العلاقات البشرية مع
الحيوانات، وتساءلوا كيف يُدرك كلٌّ منها العالم. أحدثت
هذه الأبحاث تغيُّرات طفيفة في رؤية الناس للحيوانات
التي يتغذَّون عليها، والتي يستعملونها في الأبحاث،
والتي يستأنسون برفقتها. التقدُّم في هذا المسار لا يسير
بوتيرةٍ منتظمة، لكن النقاشات فيه جارية. ويحاول الناس
استيعاب الأفكار الجديدة.
لكن في سياق الطبيعة، كان التعمُّق في فهم الذكاء
الحيواني أبطأ. حتى حركة حماية البيئة الحديثة، تلك
الثقافة والمُمارسة التي تُحدِّد في العديد من النواحي
علاقاتنا بالحيوانات البرية، تستنِد إلى بيولوجيا حماية
البيئة، وهو تخصُّص علمي استُثنيَ منه صراحةً رفاهية
الحيوان وإحساسيتُه عند تأسيسه في أوائل الثمانينيَّات.
كان يُنظَر إلى المكانة الأخلاقية للحيوانات المنفردة
على أنها تتعارض مع العمليات البيئية التي يُعَد فيها
الافتراس والموت ضروريَّين؛ لذلك كان من الأفضل تجنُّب
الموضوع. واعتبر المستوى الذي يجب التركيز عليه هو مستوى
الجماعات والأنواع. كتب الراحل مايكل سوليه في ورقته
البحثية الرائدة بعنوان «ما علم بيولوجيا حفظ البيئة؟»
التي نُشرَت عام ١٩٨٥: «واجبنا الأخلاقي تجاه الحفاظ على
تنوُّع الأنواع لا صِلة له بأي معايير مجتمعية لقِيمة أو
رفاهية أي حيوان أو نبات فرد.»
54
لم يُنكر سوليه أهمية الأفراد. تُوفي عام ٢٠٢٠، وقبل
وفاته بعامَين ناقشت معه نزوع بعض مناصري حماية البيئة
لتبنِّي التطوُّرات الحاصلة في أخلاقيَّات التعامل مع
الحيوان. في نقاشنا، تحدَّث عن أهمية التعاطُف وتذكَّر
اعتناءه بنورس وجَدَه مصابًا على الشاطئ. تهدَّج صوته
عندما تذكَّر حال ذلك النورس وشعوره بالذنب لتركِه
مكسورَ الجناح على الرمال، يواجِه الموت البطيء. مع ذلك
كان يُصر على أن منح أفراد الحيوانات مكانةً أخلاقية —
أي الإقرار بذكائها، والكفاح من أجل المسائل الأخلاقية
التي تُثار من جرَّاء ذلك — خارج نطاق الحفاظ على
البيئة.
تلك النزعة تتجلَّى في الأفكار التي انتشرت تدريجيًّا
في مجالَي الحفاظ على البيئة وحماية البيئة في العقد
الماضي؛
55 مِن ضرورة مراعاة سلامة الإنسان والبيئة على
حدٍّ سواء، وهدم إرث العنصرية وعدم المساواة، والنظر في
الديناميات الاجتماعية التي شكَّلت معاييرنا عن البرية
البِكر، واحتضان الطبيعة في المناطق الحضرية والمناطق
الطبيعية التي طالها التدخُّل البشري. حتى حركات مثل
«حقوق الطبيعة» التي تدعو إلى اعتبار الأنظمة البيئية
شخصياتٍ قانونية؛ أي معاملة النهر أو الغابة باعتبارها
تمتلك حقوقًا تُنتهك بتدميرها، تتجنَّب التطرُّق إلى
حقوق الحيوانات.
على الرغم من أن المُنظِّرين الآن يُقرُّون بأن
الطبيعة من جانبٍ تُعَد بناءً اجتماعيًّا، تُشكِّله
المواقف الثقافية والموروثات التاريخية، فإن ما يُشكل
مفاهيمنا وتصوُّراتنا عن الحيوانات يظلُّ غير مدروس إلى
حدٍّ كبير. لا يبدو ذلك مقصودًا أو نابعًا من نوايا
سيئة؛ فمجال الحفاظ على البيئة مليء بمُحبي الحيوانات.
لكن يبدو أنَّ تجنُّب التطرُّق إلى عقول الحيوانات بات
توجُّهًا معتادًا إلى حدِّ أنه أصبح يستبعِد طرُق
التفكير الأخرى.
•••
يتدفق التيار الذي يُغذي بركة تجميع مياه الأمطار من
قناة صرف خرسانية كبيرة، ولا يتعدَّى صوته مجرد همهمةٍ
لطيفة، إلا عند نزول المطر. عند الشفَق، ألمحُ أحيانًا
راكونًا أُمًّا وصغارها يخرجون منها.
ما زلتُ أراهم في مخيلتي؛ هيئة الأُم التي تتَّضح أمام
فتحة الأنبوب المُظلمة، تتوقَّف لاستطلاع محيطها. بعد
بضع لحظات، ينضم إليها الصغار. لا بدَّ أنها قادت صغارها
عبر شبكةٍ من الأنابيب والمجاري ذات المداخل التي تمتدُّ
في أرجاء الحي، وتضمن لها المرور بأمان أسفل الشوارع.
تُغادر الأم الأنبوب وتختفي في الغطاء النباتي المُنخفض
على ضفة الجدول، ثم تظهر على مسافةٍ أبعد، تشبُّ على
قائمَيها الخلفِيَّين وتشم. ثم بإشارة صامتة أو غير
مُدرَكة، يندفع صغارها إليها. يتوجَّهون إلى البركة التي
يزخر البوط الذي يحفُّها بالطعام، ويوفر السياج المحيط
بها الأمان. لاحقًا، حين يشتدُّ الظلام وتستحيل الرؤية،
أسمع الصغار يُطارد بعضهم بعضًا عبر فروع شجرة صنوبر
صغيرة. لا تترُك أقدامها أي أثر على الضفة الخرسانية،
ولكن في غيره مِن المواضع ينطبع في الطين أثر كفَّيها،
تكاد تبدو مثل الكف البشرية.
تحتل حيوانات الراكون مكانةً خاصة في التاريخ الثقافي
لأمريكا الشمالية.
56 في ثقافات مجتمعات ما قبل الاستعمار، تؤكد
الحكايات على ذكائها وفضولها؛ على قُدرتها العجيبة على
قطف الفاكهة في ذروة نضجها، وأنامِلها الماهرة التي
تفكُّ بها العقد. هي تعبر الحدود، وتألف العيش في أعماق
البرية وأطراف الضواحي على حدٍّ سواء؛ وفي أوائل القرن
العشرين، بعد عدة قرون استعمارية من صيدها لأجل لحومِها
وفرائها، واضطهادها باعتبارها من الآفات الزراعية، نالت
بعض الحظوة في الثقافة الشعبية.
57 فرَوَت الصحف عن مغامراتها، واقتناها
الكثيرون باعتبارها حيوانات أليفة في فترةٍ كانت نظرة
الناس لاقتناء الحيوانات الأليفة قد بدأت تتغيَّر؛ إذ لم
يعُد اقتناؤها مسألة نفعية بقدْر ما هي عاطفية. من بين
أولئك كان الرئيس كالفين كوليدج، الذي رافقته الراكون
ريبيكا في جولات المَشي اليومية حول البيت
الأبيض.
لفترة وجيزة، كانت حيوانات الراكون موضوع دراسة علماء
النفس التجريبيين، لا سيما لورانس كول من جامعة
أوكلاهوما وهيربرت بيرنهام ديفيس من جامعة
كلارك.
58 أظهرت تجاربهما على قُدرة الراكون على
التعلُّم والذاكرة أنها قادرة على الاستدلال المُعقد
والاستبصار؛ وفي خضمِّ جدل «مُدلسي الطبيعة»، وصف هذان
العالمان قُدرتها على توليد الأفكار والتفكير المُشابه
للتفكير البشري. لكن هذا البحث لم يلقَ اهتمامًا، وهو ما
يرجع جزئيًّا إلى التعصُّب المُتزايد لأنصار مذهب
السلوكية، وصعوبة استخدام حيوانات الراكون المُتهورة في
الدراسات بدلًا من الفئران أو الحمام، رغم أنها ظلَّت
محتفظةً بشعبيتها الجماهيرية.
نعود إلى حيِّي، حيث تقِف الراكون الأم، التي تعكس
عيناها السوداوان الداكنتان لوهلةٍ سماء الغسق، فتبدو
زرقاء لامعة. تُذكرني بمقال ألدو ليوبولد، «التفكير مثل
جبل»،
59 الذي ورد في كتابه «روزنامة المناطق
الرملية» المنشور عام ١٩٤٩، وهو أحد أقوى الأعمال
تأثيرًا في مجال أخلاقيات البيئة. فيه يصِف كيف واجه هو
ورفيقه عائلة من الذئاب تلعب مع أُمِّها على ضفة نهر.
يروي ليوبولد: «في ثانيةٍ واحدة، كنا نُمطر القطيع بوابل
من الرصاص. كنت صغيرًا آنذاك تتحرَّق يدي للضغط على
الزناد؛ اعتقدتُ أنه نظرًا لأن قلَّة عدد الذئاب يعني
زيادة الغزلان، فإن عدم وجود أي ذئاب سيكون بمثابة جنة
للصيادين.» أصابا الذئبة الأُم ووصلا إليها «في الوقت
المناسب لرؤية النار الخضراء الشرسة في عينَيها تنطفئ.»
يستكمل ليوبولد: «شعرت أن الذئبة والجبل لم يُوافقاني في
هذه الرؤية.» كانت تلك الواقعة بداية تقديره للدور
البيئي الذي تؤدِّيه الذئاب في تنظيم أعداد الغزلان التي
لولا ذلك لقضت على موائلها وجاعت.
قبل ذلك بعقود، كتب ليوبولد عن مصادفته لحيوانات راكون
في رحلة صيد في نهر كولورادو.
60 علِق أحدُها عرَضًا في مصيدة لحيوانات الوشق
الكُمَيت أو البوبكات، و«بدا مبتلًّا ووحيدًا للغاية،
لكن فروه بدا جميلًا فسلخناه وأعدْنا نصب المصيدة.»
لاحقًا رأى رفيقه في الصيد جماعة من الحيوانات على
الضفة. كتب ليوبولد: «كنا نأمُل أن تكون بوبكات، لكن
لمَّا دنَونا منها خلسة بالقارب وجدْنا أنها جماعة من
الراكون. أمسكت بالبندقية وقتلتُ أحدَها بالطلقة الأولى،
واعتقدتُ أني نلتُ من ذلك الضخم بالطلقة الثانية.» لكن
تبيَّن أن «ذلك الضخم»، لم يمُت إنما شُلَّت حركته.
وجدَه ليوبولد مختبئًا تحت كومة من الشجيرات الميتة
وقُضي عليه. لم يستتبع ذلك أي تبصُّرات أخلاقية.
وردت هذه القصة في كتابٍ يضم مجموعة مقالات مختارة
بعنوان «النهر الدائري»، كتبَه ليوبولد عام ١٩٢٢، وهو في
الخامسة والثلاثين من عمره، ولكنه نُشر بعد وفاته عام
١٩٥٣، وكان سببًا في انتقاد راشيل كارسون له.
61 كتبت: «لا ينبغي أن نتوقَّع أن يتحسَّن حال
العالم حتى نمتلك الشجاعة لأن نُسمي القسوة باسمها
الحقيقي، سواء كان ضحيتها إنسانًا أو حيوانًا» وهذا لومٌ
استحقَّه عن جدارةٍ ليوبولد الشاب، وإن لم يستحقَّه
بالقدْر نفسه الشخص الذي أصبح عليه فيما بعد. في
«روزنامة المناطق الرملية»، كتب أن «البشر ليسوا إلا
رفاقًا للمخلوقات الأخرى في ملحمة التطور»، ومعرفة ذلك
من شأنها أن تمنحنا «شعورًا بالقرابة التي تربطنا
بالكائنات الحية الأخرى؛ ورغبة في أن نتعايش معها في
سلام.»
62 عرفت مجموعة أفكاره باسم أخلاقيات الأرض،
ومنح فيها الحيوانات مكانة أخلاقية مباشرة؛ وقد كانت تلك
رؤية مؤثرة، لا سيما أنها مُغلفة بمستوًى من الوعي
البيئي كان في عصر ليوبولد ثوريًّا بحق.
غير أن رؤية ليوبولد للإنسان العاقل باعتباره «فردًا
ومواطنًا عاديًّا» في الطبيعة، لم تنظُر إلى الحيوانات
الأخرى باعتبارها أفرادًا لها مُجتمعات خاصة بها، كما
أنها لم تُطالب ذلك «الفرد والمواطن العادي» بالتنازُل
عن سيادته المطلقة. حتى إنه كان يطلق على حيوانات
الراكون التي كانت تعيش في الأرض البور التي اجتهد
عقودًا لاستصلاحها، «مخازن النُّطَف»،
63 وكأن التكاثر وظيفتها الوحيدة. ورغم إقراره
للحيوانات جميعها بالذاتية، حتى فأر الحقل الذي قال عنه
إنه «مواطن رصين يعرف أن العُشب ينمو كي تُخزنه الفئران
تحت الأرض»، فإنه اكتفى بأن يتحدَّث عن أهميتها على
مستوى الجماعات والنظام البيئي؛ وهو المستوى الذي ركَّزت
عليه رؤيته الخاصة.
64
لليوبولد مقولة شهيرة يقول فيها: «أي فعلٍ يكون صحيحًا
إذا كان يحافظ على سلامة المجتمع الحيوي واستقراره
وجماله. ويكون خطأً إذا كان تأثيره خلاف ذلك.»
65 وهذا وصف رائع للوعي البيئي تبنَّته أجيال
تالية من مُحبي الطبيعة. لاحظ الإوز الذي يصِل في الربيع
وحيدًا و«النبرة الحزينة» لصداحِه، والذي ربما يُعزى إلى
كونها «أرامل مكلومة، أو أمَّهات تبحث عن صغارها
المفقودة» التي قنصَها الصيادون الذين ينتشرون في
الأراضي الرطبة التي طارت عبرها في الخريف السابق؛ غير
أن هذا لم يمنع ليوبولد من الانضمام إلى صفوف أولئك
الصيادين.
غرَضي من هذا كله ليس انتقاد ليوبولد لممارسته الصيد.
صحيح أنه يصعُب التصالُح مع قتله للحيوانات على سبيل
التسلية، ولكني أرى أن الإرث الذي تركَه لنا من أخلاقيات
التعامُل مع الأرض والمثال الذي ضربه لنا بإدارته
الحصيفة للصيد يوازِن ذلك. فريادته لعِلم إدارة الفرائس
في وقتٍ كان فيه الصيد يفتقر إلى القواعد التنظيمية،
واعتباره الحيوانات البرية ملكًا للجميع — وليس فقط
للقلة الثرية — ومراعاته البيئة في إدارته لها تُعَد
إنجازات عظيمة. إنما أريد أن أقول إن فكرته عن القرابة
أغفلت بعض الأشياء.
يبدو أن ليوبولد لم يولِ اعتبارًا للعديد من الأمور،
ولم يواكب الدراسات العلمية والتغيُّرات الاجتماعية التي
طرأت في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي
والعشرين، والتي نتجت عنها تغيرات جوهرية في علاقة البشر
مع الحيوانات. ولم يُضطر إلى مجابهة الأبحاث العلمية
التي توضح عُمق القرابة بين البشر والحيوانات؛ ولا
الانتقادات للفكر الاستعماري القائم في تعامُلنا مع
الكائنات غير البشرية؛ ولا الأفكار الجديدة عن منح
الحيوانات حقوقًا قانونية أو تمثيلًا سياسيًّا أو مراعاة
مصالحها عندما تتداخل حيواتها معنا.
من هذا الجانب، يُعَد ليوبولد شخصية رمزية. كان
متأمِّلًا ومحبًّا للطبيعة، لكنه نشأ في ظلال تلك الرؤية
التي بدأها أرسطو وامتدَّت إلى ألبرت الكبير ثم ديكارت
ثم منتقدي مُدلسي الطبيعة، الذين تجاهلوا ذكاء الحيوانات
واستغلوا الاختلافات بيننا وبينها لتسويغ إنكار حقِّهم
في المكانة الأخلاقية الأساسية. كانت مساهمته هائلة
لكنها غير مُكتملة. فمُهمة تضمين الحيوانات في منظومة
أخلاقيات التعامل مع الطبيعة — ليس باعتبارها أنواعًا أو
جماعات أو رموزًا، إنما باعتبارها أشخاصًا مثلنا لكنهم
ليسوا بشرًا — لم تكتمِل بعد. ومسئولية إكمالها تقع على
عاتقنا.
تأتي تلك المهمة في فجر العصر الذي يُطلَق عليه
أحيانًا اسم الأنثروبوسين، يشكل فيه التأثير البشري
الأرض بالمعنى الحرفي، وإن كانت تداعِيات ذلك المصطلح لا
تزال قيد النقاش؛ فهل يشير فقط إلى قوتنا الهائلة؟ أم
إنه يدعونا كذلك إلى التأمُّل، وتبنِّي أخلاقيات مستدامة
ومنصفة، بل رحيمة أيضًا؟ أعتقد أننا إذا أصغَينا إلى صوت
ضميرنا، وإذا أردْنا أن تكون الأرض كوكبًا يستحق العيش
فيه، فسنتبنَّى أخلاقيات رحيمة. وبالنظر إلى ما نعرفه عن
عقول الحيوانات وحيواتها، فإن أي علاقة بالطبيعة لا تأخذ
هذه الأفكار بالاعتبار لن تكون منصفة.
هذا لا يقتصر على مجرد إدانة الصيد ونصب الفخاخ، أو
الإصرار على منح جميع الحيوانات حقوقًا مثلنا، أو غيرها
من الأفعال التي تبدو في ظاهرها مؤثرةً لكنها في حقيقتها
سطحية. إنما يتعلق الأمر بطرح الأسئلة وإعمال الخيال،
وبالتفكير في تبِعات اعتبار الحيوانات البرية أشخاصًا
مثلنا. ذلك الوهج الأزرق الذي ينعكس في عينَي الراكون
الأم — مثل النار الخضراء في عينَي الذئبة التي حثت
ليوبولد الشابَّ على تغيير نظرته للذئاب — يمكن اعتباره
دعوة لمراجعة نظرتنا للحيوانات البرية والطبيعة.
الهوامش
⋆
تُعَد مواقف موير تجاه السكَّان الأصليين محلَّ
جدل كبير. يرى منتقدوه أنه كان عنصريًّا، وأن
رؤيته الحالمة للبرية قائمة ضمنًا على فكرة
الإبادة الجماعية لهم؛ أما مناصروه فيقولون إن
ذلك تصوير لا يَعتبر تكامُل آراء موير وتطوُّرها
على مدار حياته. وهذا جدل لا يمكن تجاهله ولا
الفصل فيه هنا، ولكن بن جالوس، الرئيس السابق
للجمعية الوطنية للنهوض بالمُلوَّنين والمدير
التنفيذي الحالي لنادي سييرا، قدم رأيًا حكيمًا
في هذا الصدد. إذ قال إن الناس يجِب أن يُحكَم
عليهم بناءً على أفضل مواقفهم لا أسوئها.