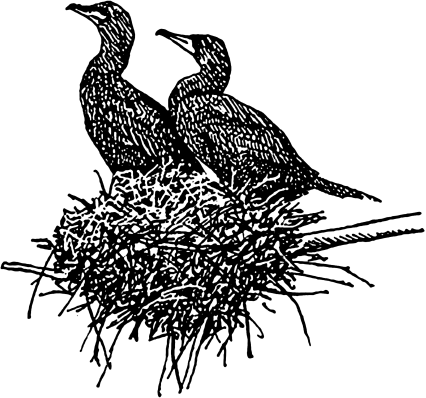الفصل السادس
حيوانات مُواطِنة
قبل عدة سنوات، سافرت إلى تورونتو، أونتاريو، لحضور
مؤتمر لبيولوجيا الحفظ. تقع المدينة على حافة بحيرة
أونتاريو، وفي إحدى الأمسيات، تجوَّلتُ في ليسلي ستريت
سبيت، وهو لسان يمتدُّ في البحيرة مسافة ثلاثة أميال،
ويمتلئ بحطام الأعمال الإنشائية الذي ألقي فيه على مدار
القرن الماضي. على هذه الأنقاض نشأ مكان برِّي حضري غير
عادي، صار الآن موطنًا لواحدةٍ من أكبر المُستعمرات في
أمريكا الشمالية لطيور الغاق المزدوج العَرف (تُسمَّى
أيضًا الغاق الطويل الأذُنَين)؛ وهي طيور مائية كبيرة
تتغذَّى على الأسماك، ولها ريش أسود وعينان زرقاوان
فاتحتان.
وفقًا للمعايير التاريخية، لا تُعَد مستعمرة طيور
الغاق التي تضم ٣٠ ألف طائر في ليسلي ستريت سبيت
استثنائيةً في ضخامتها، لكنها كانت لا تزال رائعة
المنظر.
1 حتى من المسافة التي حافظت عليها لتجنُّب
إزعاج الطيور، كان وجودها المادي محسوسًا. لقد ذكَّرتني
بالأفلام الوثائقية عن الحياة البرية عن هجرة حيوان
النَّو الإفريقي وطائر البطريق الإمبراطوري، أو أفلام
الخيال العلمي التي تُصور سفينة فضائية تهبط في مدينة
خارج كوكب الأرض، شاسعة وزاخرة بالحياة، غريبة ومألوفة
في آنٍ واحد. كانت الشواطئ مُتَّشحة بسواد تلك الطيور؛
كل شجرة قد تحوي عشرات من أعشاشها، التي تبنيها من
عصِيٍّ كبيرة، وتبدو الأعشاش مُهلهلة البناء بحيث لا
تتصوَّر أنها ستتحمل الرياح العاتية التي تهب من فوق
البحيرة. على الأرض، كانت أعشاش الطيور متراصَّة لا يفصل
بينها إلا مسافة عنق طائر. كان المكان ينبض بحركات
بالطيور التي تُنظف ريشها وتعتني بصغارها. وكانت أصواتها
الخافتة تهزُّ جزيئات الهواء.
نشأتُ في ولاية مين كارهًا لطيور الغاق؛ إذ كنتُ
أعتبرها منافسًا شرهًا لي على الأسماك التي أريد صيدها.
في النهاية تركتُ الصيد، ولكن قبل ذلك بكثير، قررتُ أنها
أحق منِّي بتلك الأسماك. فكيف أبخل عليها بالأسماك وهي
غذاؤها الأساسي الذي تعتمد عليه في بقائها، بينما أصيدها
أنا من أجل التسلية فقط؟ ومنذ ذلك الحين، أُكِن لها مودة
كبيرة، كالمودة التي يُكنُّها المرء لعدوٍ انقلب صديقًا.
أدركت أيضًا أن كُرهي الأصلي لها يعكس دون وعيٍ تشويهًا
لصورة تلك الطيور استمرَّ لآلاف السنين.
يذكر الكتاب المقدس أن الرب، وهو يُرشد هارون وموسى
إلى الأطعمة المسموح بأكلها، وصف الغاق بأنه «مكروه»
(سفر اللاويين ١٧:١١). وفي ملحمة «الفردوس المفقود» لجون
ميلتون، يجثُم الشيطان على قمة شجرة الحياة مُتنكرًا في
صورة غاق.
2 غير أن ذلك لم يكن موقف جميع مجتمعات العالم
من تلك الطيور؛ ففي الصين واليابان، كانت أنواع أخرى من
الغاق تُدرَّب قديمًا على صيد الأسماك، وفي ثقافات بعض
الشعوب الأصلية في وسط أمريكا الشمالية، كانت طيور الغاق
من الحيوانات التي اعتبرها الناس مرتبطةً بهم بقرابةٍ
وثيقة. حتى إنه سُميت عشيرة تيمنًا بها، فكما كانت هناك
عشيرة الدب، وعشيرة الحفش، وعشيرة السلحفاة، كانت هناك
عشيرة الغاق.
3 غير أن مجتمع المستوطنين لم يُشاركهم ذلك
الانتماء. إذ اعتبر الغاق خطرًا على الأسماك. وفي ثقافة
تَعتبر السواد «علامة واضحة وقوية على الاختلاف
والغرابة»،
4 كما كتبت عالمة الأحياء المُتخصصة في الطيور
المائية ليندا وايرز، كان يُنظَر إلى تلك الطيور
«بكراهية من نوع خاص». في أغلب القرن العشرين، كان
يُطلَق عليها عادةً «الإوز الزنجي»
5 — وهو وصف مُهين — وحتى إذا لم يكن الأشخاص
الذين يذبحون الغاق مدفوعين بعدائهم العنصري، فإن
المصطلح يعكس الازدراء الذي يُكنُّه الكثير من الناس
لتلك الطيور، ورخص حياتها بالنسبة إليهم.
بلغ اضطهاد تلك الطيور مبلَغَه في أواخر القرن التاسع
عشر وأوائل القرن العشرين. هجرت طيور الغاق مُستعمرات
التكاثر — مجتمعات أسلافها — التي كانت أهدافًا سهلة
للقنَّاصين، الذين كانوا يقتلونها بأعدادٍ
هائلة.
6 وبعد أن كانت شائعة، تقلَّصت أعدادها حتى
صارت نادرة؛ وعندما رُصِد عدد قليل من طيور الغاق تُعشش
في البحيرات العظمى في عشرينيات القرن الماضي، اختلف
العلماء على ما إذا كانت تلك الطيور قد عاشت هناك من
قبل.
7 أُبيدت تلك الطيور إلى حدِّ أنها تلاشت من
ذاكرة المكان. تبع ذلك تزايدٌ قصير الأجل في أعدادها
استمر حتى أوائل الأربعينيات، عندما تسبَّب خلل في
التكاثر ناتج عن مبيد الآفات ثنائي كلورو ثنائي فينيل
ثلاثي كلورو الإيثان («دي دي تي» اختصارًا) في انخفاض
أعدادها مرةً أخرى.
8 حتى في المناطق التي ظلت موجودة فيها، كان
وجودها باهتًا. في أقصى الغرب، على جزيرة سان مارتن
المتاخمة لساحل باجا كاليفورنيا، حيث كان يُعشش أكثر من
نصف مليون غاق في بداية القرن العشرين، لم يتبقَّ سوى ٥
آلاف فقط بحلول أواخر الستينيات.
9 وقُدِّر أنه لن يبقى في منطقة البحيرات
العظمى سوى ١٢٥ زوجًا فقط.
10 في عام ١٩٧٢، أدرجت الولايات المتحدة الغاق
ضمن الأنواع التي يحميها قانون معاهدة الطيور المهاجرة،
ومع وقف استخدام مبيد «دي دي تي»، بدأت أعدادها ترتفع
مرة أخرى.
عند غروب الشمس، حين سكن النسيم وعكست صفحة بحيرة
أونتاريو الشاسعة الشفق الأحمر الصيفي الممتد، ظهر في
الأفق خطٌّ أسود مُتعرج. وعندما دنا مني، تبينتُ أنه
مكوَّن من نحو سبعين طائر غاق حلَّقت على ارتفاعٍ قريب
من الماء على شكل رقم ٧ تقريبًا، وارتفعت عندما بلغت
حافة البحيرة، مارَّةً من فوق رأسي وهي تضرب الهواء
بأجنحتها بقوة فتُصدر حفيفًا مكتومًا. لم تكَد تختفي حتى
ظهر سِرب آخر، ثم آخر، ثم آخر. كان ذلك المشهد مؤثرًا
بقدْر مشهد المُستعمرة. خطر لي أن هذه الطيور عائدة إلى
بيوتها بعدما أنهت مهامَّها لذلك اليوم، ربما برفقة بعضٍ
من جيرانها أو أفراد عائلاتها أو أصدقائها أو معارفها
التي تُشاركها حياتها. لم يكن الموكب قد انتهى حين غادرت
بعد نصف ساعة.
تُرى أي قصص يمكن لتلك الطيور أن ترويها لنا؟ ربما قصص
عن صيد الأسماك؛ فهي تعرف المياه في نطاق أميالٍ مُحيطة
أفضل من أي صيادٍ بشري. تعرف أين تجد أسماك الألوايف —
التي تُعَد عنصرًا أساسيًّا في نظامها الغذائي
11 — وكذلك أسماك الجوبي المُستديرة، وأسماك
الهف العضاض، وأسماك شمس لب اليقطين، في أوقاتٍ مختلفة
من اليوم وفي مواسم مختلفة. تُرى هل لديها أيضًا ذاكرة
متوارثة ثقافيًّا لتلك السنوات الطويلة المظلمة التي
دفعها فيها البشر لهجْر بيوتها، وكان بيضها الذي شوَّهه
التلوُّث يتكسَّر عندما ترقد عليه الأمهات؟ هذه مجرد
تكهنات ربما تكون خيالية، لكن طيور الغاق يمكن أن تعيش
لربع قرن، ولا يفصل بين الطيور التي تعيش في تلك
المستعمرة حاليًّا والطيور التي أسستها سوى بضعة أجيال.
وفقًا للروايات المعاصرة، كان يوجَد في ذلك المكان ستة
أعشاش في عام ١٩٩٠، عند نشأة المستعمرة.
12 وكل عشٍّ كان يحوي طائرَين؛ أي إن عددها
إجمالًا كان ١٢ ناجيًا. تُرى ماذا عنى لها العثور على
الأمان في هذه الصخور الغريبة البارزة، التي لم يُضايقها
فيها البشر رغم وجودهم بكثافة؟
في مقال يحثُّ القراء على تخيُّل كيف «تدرك الحيوانات
الأماكن التي تسكنها وتُضفي عليها المعنى»، يسأل
الفيلسوف البيئي توم فان دورن وعالمة الإثنوجرافيا
الراحلة ديبورا بيرد روز: «مَن تُهم روايته عن نشأة
الأماكن؟»
13 من الجيد تخيُّل هذه القصص، حتى لو لم يمكن
إثباتها تجريبيًّا؛ فهي تُعَد شكلًا مفيدًا من الأنسنة.
إلى أي مدًى كانت المستعمرة في ليسلي ستريت سبيت مُهمة
بالنسبة إلى طيور الغاق التي تتذكَّر كيف كان الحال قبل
نشأتها؟ ربما كانت الطيور تنظر إلى مجتمعها الذي أقيم
فيها بشيء من الفخر. وماذا سيعني أن نضمَّها إلى
مجتمعاتنا؛ ليس فقط باعتبارها أفرادًا لها حقوق، بل لها
أصوات أيضًا؟
•••
قبل ذهابي إلى تورونتو بقليل حضرتُ مؤتمرًا للعلماء
والنشطاء بعنوان «العناية بالحيوانات». بالنسبة إلى شخص
ذي خلفية في الصحافة العلمية، حيث تُعَد الدراسات
الإنسانية مجرد جانبٍ ثانوي لقصص الاكتشافات العلمية
والباحثين الذين قاموا بها، كان حضور ذلك المؤتمر تجربةً
مثيرة. كان ثَمة اهتمام فكري ملموس بما يُسمَّى «المنعطف
الحيواني»؛
14 ذلك الاهتمام المتزايد بالحيوانات، وثَمة
مصطلح جديد أيضًا لم ينفك يتكرَّر في المؤتمر، وهو
«منعطف سياسي»، يَحيد عن مجرد بحث أخلاقيات علاقاتنا مع
الحيوانات، نحو التنظيم السياسي للحيوانات وإشراكها في
صُنع القرارات المؤسسية. نحو فكرة أن عبارة «نحن الشعب»
الواردة في ديباجة الدستور الأمريكي ينبغي أن تشمل
الحيوانات أيضًا.
عدم شمولها الحيوانات قد يبدو جليًّا. فأنَّى للسياسة
ألا تكون مسعًى مقتصرًا على البشر؟ قد نَعتبر الكلاب
فردًا من العائلة، لكنها لا تستطيع التصويت أو كتابة
رسائل إلى المُحرر. ترى الفيلسوفة الهولندية إيفا مايجر،
أن ذلك الموقف مُتجذِّر في التراث الفلسفي الذي يؤمِن
بخصوصية البشر. عرَّف أرسطو البشر بأنهم الحيوان السياسي
الوحيد، الذي ينفرد بقُدرته على اتخاذ قرارات أخلاقية
وشرح الأسباب المَبنية عليها؛
15 من بعد أرسطو، ظلَّ يُنظَر إلى الحيوانات
باعتبارها بَكْماء، غير قادرة حرفيًّا على المشاركة في
التبادل اللغوي للأفكار الذي هو صميم السياسة
البشرية.
هاجمت إيفا مايجر هذه الفكرة، في أطروحتها للدكتوراه
المعنونة ﺑ «الديمقراطيات بين الأنواع». إذ كتبت:
«الحيوانات الأخرى لدَيها لُغات وتُعبر عن نفسها بطرُق
عديدة، لكن أصواتها لا تُسمَع في الخطاب السياسي السائد
لأنها لا تتحدَّث لغة السلطة.»
16 استشهدتُ بالتبصُّرات العلمية التي
استعرضناها سابقًا، عن تواصُل العديد من الحيوانات
بطرُقٍ شبيهة بما نُسميه اللغة وعيشها في مجتمعاتٍ معقدة
تتفاوض فيها، بطرُق ديمقراطية أحيانًا، على قراراتٍ
جماعية. ترى إيفا أنه من هذا المنطلق لا ينبغي النظر
إليها باعتبارها كائنات ذكية فحسب، إنما يجب الاعتراف
بها باعتبارها جماعة سياسية.
يستكشف الفيلسوفان الكنديَّان ويل كيمليكا وسو
دونالدسون ما يَعنيه هذا في كتابٍ بعنوان «دولة
الحيوانات: نظرية سياسية لحقوق الحيوان»،
17 نُشر عام ٢٠١١، واعتبره المَعنيون
بالحيوانات والفلسفة أكثر الأعمال تأثيرًا في ذلك العقد.
الحجَّة التي يقوم عليها الكتاب هي أنه — بالنسبة
للحيوانات وكذلك البشر — المكانة الأخلاقية لا تكفي.
فمِن المُهم أيضًا أن يُنظَر إليك باعتبارك عضوًا في
المجتمع.
قبل تأليف «دولة الحيوانات»، كان كيمليكا قد قضى
عقدَين من الزمن يُنظِّر عن العضوية الاجتماعية لدى
البشر؛ وعلى وجه التحديد، عما يَعنيه الانتماء إلى
مجموعاتٍ مُتعددة في آنٍ واحد، لا سيما في المجتمعات
الليبرالية الديمقراطية. لم يكن كتاباه «المواطَنة
المُتعددة الثقافات: نظرية ليبرالية عن حقوق الأقليات»
و«رحلات في ثقافات مُتعددة: سبر أغوار السياسة الدولية
الجديدة للتعدُّدية» من الكتب التي تُقرأ على سبيل
التسلية، لكنهما حظِيَا بتقديرٍ كبير في مجال النظرية
السياسية.
18 كانت زوجته سو دونالدسون، هي التي عرَّفته
بمجال أخلاقيات التعامُل مع الحيوان عندما أقنعها صديق
في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي بأن تُصبح نباتية.
وبدورها أقنعت كيمليكا بذلك. غير أن الزوجَين لم يُفكرا
في الربط بين الحيوانات وأفكار كيمليكا عن حقوق الإنسان
إلا في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،
وذلك بعد أن حثَّته زوجته على ذلك. وكان نتاج ذلك هو
كتاب «دولة الحيوانات».
في جلسة نقاشية بعنوان «العدالة والوضع السياسي
للحيوانات» بمؤتمر «العناية بالحيوانات» افترش فيها
الحضور الأرض من شدة الزحام، يشرح كيمليكا قائلًا: «يُقر
العديد من الأشخاص بأن الحيوانات تتمتَّع بمكانةٍ
أخلاقية جوهرية، لكننا لم نُحقق التقدم الواجب في تقبُّل
فكرة أن الحيوانات يحقُّ لها أن تُعامَل باعتبارها
أعضاءً في المجتمع ولها حقوق العضوية.»
أوضح أن حقوق العضوية هي تلك التي تكتسبها من كونك
جزءًا من مجتمعٍ مشترك؛ كالحقوق الممنوحة لي باعتباري
مواطنًا أمريكيًّا على سبيل المثال، يلي ذلك الحقوق التي
تكتسِبها من كونك مُقيمًا في ولاية مين، وهي تختلف عن
الحقوق العالمية المكفولة لك باعتبارك إنسانًا. يرى
كيمليكا أن النوعَين الأول والثاني من الحقوق هما الأبرز
في حياتنا. فالحصول على الرعاية الصحية، وشبكة الأمان
الاجتماعي، والسلع والخدمات الأساسية، والتمثيل السياسي،
كلها حقوق تكفُلها لك عضوية الجماعة وليس مجرد كونك
إنسانًا. ومَن المؤهل للعضوية؟ مَن المسموح لهم بأن
يكونوا جزءًا مما أسماه اليونانيون القدماء «الديموس» أو
الشعب؛ وهم المشاركون المُعترَف بهم فيما يُعرَف الآن
بالمجتمع الديمقراطي؟ في أثينا في القرن السادس، كان
المسموح لهم بذلك هم الرجال البالغين الأحرار. في الوقت
الحاضر، على الأقل مِن حيث المبدأ، يُسمح لكل إنسان،
ولكن هذا التوسُّع في نِطاق العضوية لم يخلُ من
خلافات.
ينتقِد بعض مُنظري الإعاقات معايير المواطنة التي
تفترِض ضمنيًّا وجود درجةٍ مُعينة من الإدراك المعرفي
واللغوي لدى المواطن.
19 (وهي مسألة عندما أُفكر فيها تستحضر في ذهني
لوحة نورمان روكويل الشهيرة «حُرية التعبير»، التي تُصور
رجلًا يقف ويتحدَّث داخل مبنى بلدية). هذه المعايير
تُقصي فعليًّا الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات المعرفية.
يقول أولئك المنظرون إن هذا غير منصف؛ إذ يجب اعتبار
جميع أعضاء المجتمع مواطنين، وإذا كان من الصعب حاليًّا
بالنسبة إليهم المشاركة في تشكيل مجتمعهم وقوانينه، فيجب
أن نجد طريقةً تُتيح لهم ذلك. وهذه حُجة لها تبِعات
واضحة على الحيوانات.
إن العديد من الحيوانات بلا شك أعضاء في مجتمعاتنا؛
أبرزها معظم الحيوانات الأليفة، التي نألف وجودها في
المنازل وأماكن العمل، ولكن منها أيضًا جميع الكائنات
الحُرة التي تتأثَّر حياتها بقراراتنا، والتي قد تؤثر
أنشطتها علينا. يُحاجج كيمليكا وسو دونالدسون على أن
الحيوانات تستحق المواطنة أيضًا. تجدُر الإشارة هنا إلى
أن المواطَنة البشرية لا تساوي بين جميع البشر؛ على سبيل
المثال، يمكن أن تختلف الحقوق والامتيازات الممنوحة
للشخص حسب ما إذا كان مولودًا في البلد أو مهاجرًا، كما
أن حقوق المهاجرين في حدِّ ذاتها تختلف بين المُجنَّسين
واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. غالبًا ما يتشارك
أعضاء العديد من الدول والمجتمعات مساحةً واحدة؛ إذ قد
يضم شارعٌ مُزدحم مزيجًا من المواطنين الأصليين
والمواطنين المُجنسين، بالإضافة إلى زوَّار من دول أخرى
وأبناء شعوب أصلية يحملون جنسيات دولٍ مختلفة. من ذلك
المزيج الثري، يستخلِص الفيلسوفان دروسًا عن وضع
الحيوانات.
في نموذج ويل كيمليكا وسو دونالدسون، تُمنَح المواطنة
التابعة الشاملة للحيوانات المنزلية
20 التي تؤثر عليها رغباتنا واحتياجاتنا بشكلٍ
وثيق، والتي نتحمَّل مسئولية فريدة تجاهها. وتُولَى
مصالحها عنايةً خاصة؛ إذ سيكون وضعها مشابهًا لوضع
الأطفال القُصَّر أو الأشخاص ذوي الإعاقات المعرفية
الذين قد لا يكونون قادرين على المشاركة السياسية
التقليدية، ولكن يُمثلهم أشخاص موثوق بهم مُلزَمون
بالتصرُّف نيابةً عنهم. أما الحيوانات البرية التي تعيش
في مناطق برية، وتتجنَّب البشر ومستوطناتهم عن قصد،
فتُعتبَر مواطنين أجانب.
21 سيكون مجالها هو المناطق البرية؛ وهو مفهوم
ينتقده المؤرخون البيئيون باعتباره مفهومًا تشكَّل
اجتماعيًّا، ورغم إشكالية تجاهله للتأثير البشري، فإنه
يظل مرجعًا مفيدًا. وتحكم العلاقات بيننا وبين المجتمعات
البرية قواعد راسخة للتعاون، والوساطة في النزاعات،
والتدخُّل المحدود. هنا أيضًا سيمثل البشر مصالح
الحيوانات لكن وفق مبدأ أن تلك المخلوقات البرية وبيوتها
يجب أن تأمَن من أي استغلالٍ أو غزو. وقد يتدخَّل البشر،
ولكن فقط لتحقيق مصالحها، على غرار إرسال المساعدات
الإنسانية.
بالطبع، كثيرًا ما يدخل أعضاء من المجتمعات البرية إلى
مجتمعاتنا. أوضح مثال لذلك هو الطيور المهاجرة، مثل طيور
الطيطوي المُنفردة التي تتوقَّف عند بركة تجميع مياه
الأمطار في بيثيسدا لاستعادة نشاطها قبل أن تطير إلى
الغابات الشمالية الكندية الشاسعة. يُشبِّهها كيمليكا
ودونالدسون بالبدو الرحَّالة، الذين تحترم استقلاليتهم
عند عبورهم الحدود الدولية، ولا يُطلَب منهم سوى احترام
قوانين مُضيفيهم. هذه الطيور المهاجرة أيضًا، سيمثلها
البشر ويراعون مصالحها عند اتخاذ القرارات المؤسسية
والسياسية. غير أننا نصادف في مُحيطنا حيوانات برية ليست
مهاجرة. منها على سبيل المثال، طيور نقَّار الخشب ذي
العرف وحيوانات القيوط، التي تعيش في أقرب المساحات إلى
البرية من المناطق الحضرية؛ وكذلك الأنواع الكثيرة من
الحيوانات التي تزدهر في النُّظم البيئية الحضرية، مثل
الغزلان البيضاء الذَّيل وعصافير دوري المنازل والحمام؛
وكذلك ما يُسمَّى بالحيوانات الوحشية، وهي مُنحدرة من
سلالات حيواناتٍ كان البشر يستأنسونها ويُربونها.
هذه المليارات من الكائنات العتبية أو الحدية يُوليها
كيمليكا ودونالدسون اهتمامًا خاصًّا. كَتبا في «دولة
الحيوانات»: «هي تتأثر في كل مرة نقطع فيها شجرة، أو
نحوِّل مسار مجرى مائي، أو نبني طريقًا أو مشروعًا
سكنيًّا، أو نُشيد برجًا، لكنها أقل الحيوانات مكانةً
وحماية من الناحية القانونية والأخلاقية.»
22 غالبًا ما يتجاهلها دُعاة الحفاظ على البيئة
والمدافعون عن حقوق الحيوان، ربما لأنها لا هي تدخُل في
مفهوم المُدن باعتبارها مساحاتٍ بشرية، ولا مفهوم
الكائنات البرية التي لا تنتمي حقًّا إلى المساحات
البشرية. في نموذج كيمليكا ودونالدسون، هي لا تُعَد
مواطن بالمعنى الكامل؛ مما يستلزم مستوًى من التفاعل
البشري الذي لا تنشده، ولا هي أعضاء في أُمم مستقلة، وهو
وضع يعكس مدى تشابك حيواتها مع حيواتنا. إنما تعتبر هذه
الكائنات — الزرازير والأرانب القطنية الذيل عند بركة
مياه الأمطار، وطيور الغاق في ليسلي ستريت سبيت —
مُقيمة،
23 على غرار المهاجرين الذين ليسوا مواطنين
لكنهم مُنحوا حق الإقامة وقَبِلهم المجتمع أعضاءً فيه.
هي لا تستوفي معايير الحصول على المزايا الكاملة
للمواطنة، لكنها تستحق مراعاة مصالحها ونيل درجة من
التمثيل في المداولات المجتمعية.
كل هذه المسائل قد تبدو متطرفةً إلى الحدِّ الذي يجعل
تطبيقها صعبًا، وتبدو أكاديمية بحتة أيضًا؛ مسائل يبحثها
المنظرون الذين يرَون العالم من البرج العاجي غير
مُدركين للخلافات العميقة بشأن تمثيل البشر لغيرهم من
البشر، فما بالك بالحيوانات؟ لكن، يظلُّ من الضروري أن
نُفكر في تبِعات اعتبار الحيوانات أعضاءً مثلنا في
المجتمع.
مِن المقبول الآن على نطاقٍ واسع في أوساط حماية
البيئة والحفاظ عليها أنه لا ينبغي اعتبار البشر
والطبيعة فئتَين متنافيتَين ومتعارضتَين جوهريًّا، كما
لا ينبغي اعتبار الوجود البشري مفسدًا للطبيعة لا محالة،
وأنها لن تزدهر إلا في غيابنا. والكتابات المُعاصرة عن
الطبيعة تزخر بتصوُّرات لعلاقاتٍ جديدة تزدهر فيها
الفئتان معًا؛ غير أن الحيوانات تظلُّ غير مُعتبرة في
نظم السياسة والحكم، حتى من الناحية النظرية. عندما تكتب
روبن وول كيمرير في كتابها الرائج «تضفير العشب» عن
«ديمقراطية الأنواع»،
24 فإن كامل معاني تلك العبارة البديعة تظلُّ
غير مُستكشفة. هكذا يظل الفصل بين الإنسان والطبيعة
قائمًا.
لن يكون من الصعب إدراج الحيوانات البرية في النموذج
الذي يقترحه كيمليكا ودونالدسون، على عكس صعوبة تصور ذلك
بالنسبة إلى بعض الحيوانات المُستأنسة في الوقت الحالي،
ربما ليس الحيوانات الأليفة، إنما قطعًا تلك التي
تُستخدَم من أجل الغذاء والخدمة والأبحاث، وهي صناعات
يُهددها منح المواطنة للحيوانات. إن قتل الحيوانات
البرية بغرَض التسلية أو الرياضة أمر مُجحف؛ وكذلك
الأضرار الناتجة عن التلوث وحوادث المركبات وتغير
المناخ. واحترام مصالح تلك الحيوانات وتمثيلها ليس
بالأمر المعقد، وأعتقد أن العديد من الأشخاص المُحبين
للطبيعة والحيوانات يرغبون في أن يتحقق. لا نحتاج إلا أن
تتطابق الممارسات العملية مع الأفكار النظرية؛ كما أن
تلك الأفكار والمُثل ليست راديكالية على الإطلاق؛ إذ
إنها مُتحققة بالفعل، على الأقل في بعض الأماكن.
•••
في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أراد
بعض سكان تورونتو طرد طيور الغاق. إذ اتَّهموها بقتل
الأشجار التي تجثُم فوقها بفضلاتها الحمضية الغنية
بالمُغذيات.
25 كان هذا صحيحًا بلا شك، وإن كان تأثيره
التدميري لا يُقارَن بتأثير تقسيم الأراضي وإنشاء مراكز
تسوُّق جديدة في المنطقة. لكن الناس يعتزُّون كثيرًا
بليسلي ستريت سبيت، الذي يضم مُتنزَّه تومي طومسون
الشهير ذا ممرات المشي البرية التي تمتد مسافة ١١ ميلًا
في تلك المنطقة الحضرية، كما أن قتل طيور الغاق أسهل
بكثير من الوقوف في وجه المطورين العقاريين.
فطيور الغاق لا تُثير عادة في نفوس الناس التعاطف الذي
تُثيره طيور مالك الحزين الزرقاء أو النسور الصلعاء؛ فهي
لا تتمتع بالقدر الكافي من الجمال أو الهيبة الذي يجعل
الناس يكترثون لأمرها دون أن يعرفوها حق المعرفة. لكي
أعرف عنها أكثر، سألت جايل فريزر، عالمة الأحياء في
جامعة يورك التي قضت سنواتٍ في دراسة المستعمرة، عن
الحياة اليومية لتلك الطيور.
تقول جايل إن أكثر ما يلفت نظرها في تلك الطيور هو
تفانيها في رعاية صغارها. مثل العديد من أنواع الطيور،
تفقس الصغار عاريةً من الريش وغير مكتملة النمو، وتتطلب
عناية مُستمرة، لكن هذا التفاني يستمر لأكثر من المدة
التي توقَّعتها. في نهاية الصيف، من الشائع أن ترى
الوالدَين ماكثَين في عشهما ينتظران أن يزورهما فراخهما
المُستقلة. تقول جايل: «يظل الطائر البالغ منتظرًا في
عشِّه حتى يرجع إليه الفرخ» الذي عادة ما لا يكون
متمكنًا من الطيران فيرتطم بالأغصان «لأنه لا يزال
يتعلَّم الطيران والملاحة. لكنه يصل، وما إن يصل حتى
يفغر منقاره متوسلًا، لكنه يكاد لا يحتاج لأن يتوسَّل.»
إذ يكون الأب أو الأم قد جهَّز له وجبة.
لكن حتى معرفة جايل بتلك الطيور ليست وثيقة. سألتها
عما إذا كانت طيور الغاق تستخدِم العشَّ نفسه كل عام؛ هي
تظن أنها تفعل، لكنها ليست واثقة. حرصًا على عدم إزعاج
الطيور، وضعت جايل الحلقات الملوَّنة التي يستخدمها
علماء الأحياء للتعرُّف على الطيور في ساق عدد قليل من
الطيور فقط وليس كلها. يبدو ذلك تمثيلًا لمعرفتنا
الضئيلة بهذه الطيور على المستوى الفردي، فما بالك
بالمستوى الشخصي؟
غير أني وجدتُ شخصًا يعرف الغاق معرفةً وثيقة: عالم
بيئة يُدعى جيمس لودفيج، صاحب كتاب «ولاية البُحيرات
العظمى الموحشة»،
26 الذي يُزين غلافَه صورةٌ لأنثى غاق قال لي
إنه عثر عليها في صيف عام ١٩٨٨ أثناء دراسته للآثار
البعيدة المدى للملوِّثات على الطيور المائية. كان في
جزيرة نوبينواي، الواقعة في الطرف الشمالي لبحيرة
ميشيجان، يُنهي موسمًا ميدانيًّا مُحبِطًا آخر سجَّل فيه
العيوب الخلقية والاضطرابات التكاثرية التي تُعاني منها
تلك الطيور. احتوى ثلث العينات التي جمعها من البيض على
أجنَّة مشوَّهة. عندما كان يجد فراخًا من الواضح أنها لن
تعيش، كان يقتُلها رحمةً بها ويُحللها بدقة أكبر.
كان قد قتل بالفعل ٢٨ من صغار الغاق والخرشنة
القزوينية؛ يتذكر ذلك لاحقًا فيقول: «كانت تموت في يدي
وبيدي، يوميًّا على مدى شهرين»، كان قد وجد فرخ أنثى غاق
منقارها العلوي مقوَّس على شكل دائرة شِبه مكتملة، مثل
ناب خنزير برِّي في رسم كاريكاتوري. لم يرَ لودفيج قَطُّ
طائرًا مشوهًا بتلك الدرجة المُريعة. قال لي: «شيء ما في
هذا الفرخ أثَّر فيَّ بشدة.» كان يعلم أنه من واجبه
قتلها، ووبَّخ نفسه على لين قلبه المُخالف للسمت العلمي،
لكنه نظر في عينَيها فقرَّر إبقاءها على قيد الحياة
بدلًا من ذلك. أطلق عليها اسم كوزموس.
آنذاك اعتقد أن الفجوة بين نوعِه ونوعها تحوَّل دون
نشأة علاقة من أي نوع بينهما؛ غير أن علاقته بها بدأت —
مثل أي طفل — بالجوع المتواصِل، وطلب الاهتمام،
والتبرُّز بكميات هائلة. نمَت كوزموس بسرعة، وسرعان ما
بدأ لودفيج يصحبها معه وهو يُدلي بشهادته أمام الهيئات
التشريعية أو يُلقي خطاباتٍ عن التلوُّث في البُحيرات
العظمى. في إحدى الأمسيات، أثناء عودتهما إلى المنزل من
اجتماع في شيكاغو رُفض فيه طلبه للحصول على تمويل بحثي،
قفزت كوزموس إلى كتف لودفيج المُغتم وبدأت تنقر أذنَه.
لم يكن فِعلها ذلك يختلف عما يفعله كلب أو قط أليف عندما
يستشعر من صاحبه ضيقًا، أو يختلف عن تهذيب الغاق لريش
شريكه. بدلًا من الريش، كانت كوزموس تُهذب سوالف
لودفيج.
بات ذلك طقسًا مُعتادًا أثناء قيادته للسيارة، ولا
يزال يعتز بذكرياته عن رحلاتهما الطويلة عبر أعالي الغرب
الأوسط. على مدار تسعة أشهر، ظهرت كوزموس في ٢٧ لقاءً
تلفزيونيًّا على حدِّ قول لودفيج، من ضِمنها لقاءٌ أجراه
فريق إخباري من اليابان، حيث زيَّنت صورتها غلاف كتاب
مدرسي للمرحلة المتوسطة؛ وانضمَّت إليه في نحو اثنتَي
عشرة حصة دراسية وتسعة وعشرين اجتماعًا للجماعات البيئية
المحلية؛ ورافقته إلى المقرَّات الإدارية لولاية ميشيجان
وويسكونسن، وكذلك إلى مجلس النواب الأمريكي. كانت تقف
لالْتقاط صورها، ويبدو أنها كانت تستمتع بالاهتمام الذي
تتلقَّاه، والذي يليق بنوعها الاجتماعي. وكلما انتاب
لودفيج القلق أو الغم، كانت دائمًا تهذب شعره وتنقُر ما
وراء شحمة أذنه. كانت كوزموس نفسها تحب أن يُدلِّكَ
قدمَيها ويُمسِّدَ عنقَها. وفي بعض الأحيان كانت تنام
على كتفه.
في المنزل، كانت تنضم إلى لودفيج على المقعد الموجود
في الفناء الخلفي لمنزله حيث يُحب أن يقرأ، وتُقلِّب
صفحات الدوريات العلمية بمنقارها. وأحيانًا كانت تشعر
بالغيرة أيضًا، وتتضايق إذا حاول شخص آخر الجلوس معهما.
قال: «أعتقد أنها كانت تعتبرني والدها.» كثيرًا ما كانت
تقصد المسبح لتستحمَّ فيه؛ يقول لودفيج إنها في تلك
اللحظات، كانت تتحول تمامًا. هذا رغم أنها كانت طائرًا
مريضًا كُتب عليها أن تُعاني آثار إرثٍ من التخلص من
مادة الديوكسين، ليس فقط على الجينات المُنظمة لنموِّ
المنقار، إنما أيضًا في تثبيط نظام مناعتها، وهو ما
تركها عرضةً للعدوى طوال الوقت، حتى إن لودفيج وزوجته
كاي كانا يجدان صعوبةً في تنظيم الدورات المتكررة من
المُضادات الحيوية. لكنها في الماء، تتحوَّل إلى رصاصة
لامعة، تظل تمرق من جانبٍ إلى آخر أسرع مما يستطيع
لودفيج الركض.
غير أن أثر إرثها من الملوِّثات الكيميائية لا يمكن
تجاهله. بحلول الصيف التالي، وبينما كان لودفيج يتجهَّز
لموسم آخر من العمل الميداني، كانت كوزموس تتعافى من
عدوى صدرية وقُرَح في القدمَين. وما إن غادر حتى عادت
إليها عدوى متكررة في العين. بحلول منتصف الصيف، تدهورت
صحتها حتى صارت في أضعف حالاتها. وفي إجازة من العمل عاد
لودفيج، فبدا أنها استعادت شيئًا من عافيتها، لكن صحتها
ما لبثت أن تدهورت مرةً أخرى عندما رجع إلى عمله
الميداني. إذ أعرضت تمامًا عن الأكل. وذات يوم في مطلع
شهر أغسطس، وجدت كاي كوزموس في البقعة التي تُحب أن
تتشمس فيها بجانب المسبح، يلامس منقارها سطح الماء وقد
غادرت الحياة.
يتحدث لودفيج بلكنة سكان أعالي الغرب الأوسط، وهو رجل
ودود ولكنه متحفظ، نشأ في وقتٍ لم يكن مقبولًا فيه أن
يُعبر الرجال عن انكسارهم العاطفي. ورغم ذلك، سمعت
تهدُّجًا في صوته وهو يحكي لي ذلك. قال: «انتابني الشعور
الذي اختبرته عندما فقدت كلب بوردر تيرير كان يبلغ من
العمر ١٥ عامًا ونصف. شعرت كأني فقدت جزءًا أساسيًّا من
حياتي. واستغرق تقبلُّي للأمر وقتًا طويلًا.»
لأن لودفيج كان بعيدًا عن المنزل عندما ماتت كوزموس،
وضعت كاي جُثتها في مُجمِّد، وعندما عاد تركها فيه.
وبدلًا من مواجهة مشاعره، هرب منها بالاستغراق في العمل؛
حاول أن يُقنع نفسه بأن كوزموس كانت مجرد طائر
عادي.
استغرق عامَين ليقرِّر ما سيفعله بجثمان صديقته.
وأخيرًا أخذها هو وكاي إلى هاي آيلاند، إلى مرتفع
يَعتبرانه أجمل بقعةٍ في بحيرة ميشيجان. وهناك، كما فعل
سكان المنطقة في العصر الحجري من قبل، وجَّها جسدها صوب
الشرق لتستقبل شروق الشمس.
أسفل المُرتفع الذي أرقداها فيه كانت توجَد مستعمرة
للنوارس والخرشنات، ولأن كوزموس لم يكن لديها عشٌّ خاص
بها، فقد بَنَيا لها عشًّا من حشيشة الكثبان. وبدلًا من
البيض، وضعا فيه أحجارًا. ومن الأزهار البرية القريبة،
جمع لودفيج لها جذورًا وبذورًا: كانت كوزموس قد ماتت قبل
أن تظهر ألوانها، لكن هذه البذور والجذور ستُحيطها
بالألوان كل ربيع. وأمام جثمانها، قرآ مقطعًا بارزًا من
كتاب «البيت الأبعد» لعالِم الطبيعة هنري بيستون:
«نحن بحاجةٍ إلى مفهوم آخر أكثر حكمة، وربما
أكثر صوفية للحيوانات. نحن نتعالى عليها لما
فيها من نقص، ولقدرها المأساوي الذي كتب عليها
أن توجَد على صورةٍ أدنى من صورتنا بمراتب
كثيرة. ونحن في ذلك خاطئون. لأن الحيوان لا
ينبغي أن يُقارَن بالإنسان. ففي عالَمٍ أقدم
وأكمل من عالَمنا البشري، تعيش الحيوانات كاملة
مكتملة، وقد حُبيت بقدراتٍ حسِّية فقدناها أو لم
توجَد لدينا من الأساس، تتحدَّث بأصوات لن
نسمعها قط. إنها ليست بإخوة لنا ولا هي تابعة،
إنما هي أُمم أمثالنا، عالقة معنا في شبكة
الحياة والزمان، رفيقة لنا في ذلك السجن البديع
الباهر الذي هو كوكب الأرض.»
27
كانت كوزموس مُتفردة؛ لكنها، بطريقةٍ
أو بأخرى، لا تختلف عن غيرها من طيور الغاق. جمعتها
الظروف بلودفيج، ولكن لو أنها وُلدت معافاة وما لفتت
نظرَه، لما نقص ذلك من تفرُّدها شيئًا. ورغم أني لا
أستطيع تمييز طيور الغاق، في ليسلي ستريت سبيت، من
بعضها، ورغم أن علماء الأحياء الذين يدرسونها يجدون
صعوبة في التعرُّف على الأفراد، فما بالك بمعرفة التاريخ
الشخصي لكل فرد، فإن كل طائر من تلك الطيور، أو أولئك
المُقيمين على حدِّ تعبير كيمليكا ودونالدسون، متفرد
أيضًا.
تذكَّر ذلك وأنت تنظر في دعوات التخلص من طيور الغاق؛
التي تعني في الحقيقة قتلها. مع تزايد تلك الدعوات،
تدخَّل تحالف الحيوان في كندا، وهي جماعة لحماية الحيوان
شاركت في تأسيسها عام ١٩٩٠ ليز وايت،
28 وهي مُمرضة متقاعدة عملت في السابق لصالح
جمعية الرفق بالحيوان. في عام ٢٠٠٥، ساعدت أيضًا في
تأسيس حزب سياسي يُعرَف الآن باسم حزب حماية الحيوان في
كندا.
29 لم تتوقَّع ليز وشركاؤها الفوز بالانتخابات،
أو حتى الاقتراب من الفوز، ولكن مجرد خوض مرشَّحين من
الحزب الانتخابات قد يُساهم في تشكيل النقاش العام. كان
أولئك المرشحون قد «خاضوا الانتخابات بغرَض الدفاع عن
حقوق الحيوانات وجعل الناس يدركون أن الأرض كوكب محدود
الموارد، وأننا جميعًا نتشارك فيه»، كما أخبرتني وايت
عندما زرتُ مقرَّ الحزب الذي يُعَد أيضًا مأوًى للقطط
والكلاب المُنقَذة. كانت تُزين الجدرانَ صورُ الحيوانات
التي ساعدوها: فقمات، وطيور غاق، وأبقار، وأغنام،
وسلحفاة ظلت تعيش في دلو لمدة ٢٠ عامًا حتى وجدوا لها
مكانًا في ملجأ.
قدمَت لي ليز، التي لا تزال محتفظةً بحضور الذهن
والكفاءة التي تميز المُمرضات، شريحةً من كعكة نباتية،
وشرحت كيف كانت هيئة الحفاظ على البيئة في تورونتو
والمناطق المُحيطة بها على استعداد للبدء في قنص طيور
الغاق التي تستعمِر ليسلي ستريت سبيت. كان هذا متوقعًا؛
حتى في عصرٍ تحظى فيه طيور الغاق بحمايةٍ نسبية، كان
يقتل منها نحو ٤٠ ألفًا بإذنٍ من الحكومة كلَّ عام في
الولايات المتحدة،
30 كما قُتل منها نحو ٣٢ ألفًا في منطقة
البحيرات العُظمى في أونتاريو.
31 كان مُبرر ذلك في الولايات المتحدة هو أنه
لازم لحماية مصائد الأسماك؛ وهو مُبرر ثبت خطؤه بعد ما
يقرُب من عقدٍ من الزمان عندما طُعن فيه أمام
المحكمة؛
32 أما في أونتاريو فتُقتَل طيور الغاق في
الغالب بحجة حماية الغطاء النباتي المحيط
بمجاثِمها.
ربما لم ترُقْ تلك الحجة لجماعات الحفاظ على البيئة
المحلية، غير أن ذلك النوع لم يكن مهددًا. فكان مجتمع
حماية الحيوانات هو الذي اعترض. تقول ليز إنه بعد تهديد
جماعة تحالف الحيوان وأنصارها بالاحتجاجات ورفع دعوى
قضائية، وافقت هيئة الحفاظ على البيئة بتورونتو والمناطق
المحيطة على إنشاء فريق إدارة يضم المعارضين لوجود طيور
الغاق والمناصرين له.
33 بعبارة أخرى، أصبح لدى طيور الغاق الموجودة
في ليسلي ستريت سبيت كيان يُمثلها. وفي النهاية، توصل
الطرفان إلى حلٍّ وسط؛ إذ اتُّفق على تخصيص ثلاث مناطق
من اللسان مُرحَّب فيها بوجود الغاق. خارج تلك المناطق،
يزيل مديرو المُتنزَّه الأعشاش المَبنية حديثًا في
الشتاء، بعدما تكون الطيور قد طارت جنوبًا، وكذلك في
الربيع مع بداية موسم التعشيش، يُستثنى من ذلك الأعشاش
التي تكون بها بيض أو فراخ. أما في المناطق المسموح فيها
بوجود الغاق، فيشجعونها على التعشيش على الأرض بدلًا من
الأشجار، في البداية عن طريق وضع نماذج مُصنعة للغاق في
أعشاش مُصنعة على الساحل، ووضع مواد التعشيش، وترتيب
أشجار مقطوعة لتوفير الحماية، وتشغيل تسجيلات لأصوات
الغاق عبر مُكبرات الصوت. على مدى السنوات الثماني
التالية، انخفض عدد طيور الغاق التي تُعشش في الأشجار
إلى النصف تقريبًا في حين ارتفع عدد الطيور التي تعشش
على الأرض تسعة أمثال.
34
تقول ليز: «ذلك هو أسلوب الإدارة التدريجي الوحيد
للتعامُل مع الغاق الذي شهِدتُه في حياتي. إذا قرَّرتَ
أن تركز على إيجاد حل للمشكلة غير الحل الأسهل الذي هو
قنص الطيور، فستخطر لك أفكار مبتكرة.» في عام ٢٠١٨، منحت
عالمة الأحياء جايل فريزر وزملاؤها موافقتهم العِلمية
على تلك الخطة، وكتبوا في دورية «ووتربيردز» العلمية
أنها «سمحت بالوجود المُستدام لمُستعمرة
مزدهرة.»
35
قد لا يبدو هذا إنجازًا فريدًا؛ فهذا هو الدور الطبيعي
لجماعات التأييد. غير أنه لا ينبغي أن يُعَد من
المُسلَّمات. فما حدث هو أن أولئك الناس تحدَّثوا نيابة
عن طيور الغاق في النقاشات التي تُعَد — إلى جانب
التصويت على القرارات — أساس الحياة السياسية، ثم
مثَّلوها في عمليات صُنع القرار. وهذا مثال قوي ومؤثِّر
يوضح أن اعتبار الحيوانات مواطنين ليس فكرةً ثورية
للغاية؛ فهو نتيجة طبيعية لأشياء نقوم بها بالفعل،
ولكنها عادة لا تصاغ بهذه اللغة. وثَمَّة إمكانية لتحقيق
إنجازات أكبر بكثير.
•••
قد يكون تمثيل طيور الغاق الموجودة في ليسلي ستريت
سبيت وليد ظرفه، لكن المبدأ يمكن تطبيقه بطرُق أكثر
منهجية. ورغم أن السياسة أوسع من مجرد التصويت على
القرارات، فإن التصويت يظلُّ جوهر التمثيل
الديمقراطي.
في حين أن حزب حماية الحيوان في كندا لم يفُز منه أي
مرشح في الانتخابات — إذ كانت أعلى نسبة تصويت للحزب هي
التي حصل عليها في انتخابات مجلس العموم عام ٢٠٠٨، وكانت
تساوي ٠٫٥٢ في المائة من الأصوات
36 — فقد حققت أحزاب مناصِرة للحيوانات نجاحًا
أكبر في غرب أوروبا. ففي عام ٢٠٢١، حصل حزب الحيوانات
الهولندي على ٣٫٨ في المائة من الأصوات في الانتخابات
العامة،
37 وفاز بتسعة مقاعد في الهيئات التشريعية
الوطنية للبلاد ومقعد واحد من بين ٢٦ مقعدًا للبلاد في
البرلمان الأوروبي. وفي البرتغال، فاز حزب الشعب
والحيوان والطبيعة بمقعدٍ في البرلمان الأوروبي عام ٢٠١٩
وأربعة مقاعد في الجمعية الوطنية.
38 ويوجَد في الوقت الحالي أكثر من اثني عشر
حزبًا من هذا النوع في جميع أنحاء العالم.
من موقعي في بلدٍ يُهيمن عليه حزبان سياسيان، ويبدو
فيه مستقبل الديمقراطية الليبرالية غير مؤكَّد، أُتابع
هذه التطورات كأنها رسائل من كوكب آخر؛ غير أن ثَمَّة
طرقًا لتحقيق ذلك في إطار منظومتنا هذه أيضًا. أحد
الأمثلة على ذلك تُقدِّمه منظمة «ناخبون من أجل حقوق
الحيوان»، وهي مجموعة في مدينة نيويورك تنظم الأشخاص
المُهتمين بقضايا الحيوانات في كتلةٍ تصويتية يمكنها
التأثير على السياسة ومساعدة المرشحين المتعاطفين في
الفوز بالانتخابات. تشمل انتصارات ناخبين من أجل حقوق
الحيوان التشريعية حظرًا لاستخدام الحيوانات البرية في
السيرك على مستوى المدينة، وحظر بيع كبد الإوز الدسم أو
«الفوا جرا»، الذي ينتج عن طريق الإطعام القسري للبط
والإوز؛ وفرض عقوبات أشد على اصطياد الطيور البرية، وهي
مبادرة أُطلقت لمواجهة صيد الحمام في المدينة بالشِّباك
لاستخدامه أهدافًا حيَّةً في نوادي الرماية.
39
غير أن أهم إنجازاتهم كان الضغط من أجل إنشاء منصبٍ
مُخصص لرفاه الحيوان داخل مكتب العمدة. أُنشئ ذلك المنصب
في عام ٢٠١٥ باعتباره حلقة وصلٍ بين أقسام وحدة شئون
المجتمع بالمدينة، وهي واحدة من العديد من الوحدات
المُكلفة بربط البلدية بالمجموعات المُهمة أو
المُستضعفة.
40 (كان هناك أيضًا روابط مع المجتمعات
اليهودية والمسلمة والمِثلية في نيويورك.) في عام ٢٠١٩
أصبح منصبًا دائمًا، لا يتأثر بالتقلُّبات في الميزانيات
التقديرية وتغيُّر الإدارات. إنه المنصب الأول من نوعه
في الولايات المتحدة، وربما في أي مكانٍ آخر: مسئول
حكومي مُهمته رعاية رفاهية الحيوانات وتمثيل مصالحها
داخل الحكومة.
41
قالت كريستين كيم، التي رأست ما يُعرَف الآن بمكتب
رفاه الحيوان التابع للعمدة، في عهد عمدة مدينة نيويورك
السابق بيل دي بلاسيو: «أنا هنا لأُدافع عن حقوق ناخبيَّ
— الحيوانات — داخليًّا؛ وإن كانت الحيوانات لا تنتخِب.»
قالت لي كريستين كيم إن مكتب رفاه الحيوان ليس وكالةً
مستقلة بذاتها. إنما يتعاون مع وكالاتٍ أخرى عندما
تتعارض واجباتها مع مصالح الحيوانات؛ على سبيل المثال،
تعاون مع إدارة المُتنزَّهات في برنامج لتعقيم الغزلان،
ومع إدارة الصحة والخدمات الإنسانية لبناء ملاجئ جديدة
للحيوانات.
مكتب رفاه الحيوان صغير للغاية. كانت كيم الموظفة
الوحيدة فيه. ومع ذلك، فقد حقَّقت الكثير هي وراشيل
آتشيسون التي سبقتها في ذلك المنصب. ذكرتا لي في مقابلة
معهما أنه بالإضافة إلى الإنجازات التي تَقدَّم ذكرها،
فقد روَّج المكتب لأيام الإثنين الخالية من اللحوم؛ وضغط
لإيقاف مشاريع فقس البيض المدرسية؛ ووضع استراتيجية
لإدارة إوز كندا في المُتنزَّهات الحضرية دون الإضرار
به؛ ووسَّع شبكة ملاجئ الحيوانات في المدينة، التي يضمُّ
أحدُها مركزًا لإعادة تأهيل الحيوانات البرية؛ وأثناء
جائحة كوفيد-١٩، أنشأ خدمة لمساعدة الناس على رعاية
حيواناتهم الأليفة أثناء وجودهم في الحجر الصحي أو
المُستشفيات. يتشاور مكتب رفاه الحيوان أيضًا مع مسئولين
وأقسام أخرى، ويتواصل معه أيضًا المدافعون عن حقوق
الحيوان. قالت لي آلي فيلدمان تايلور، مؤسِّسة منظمة
«ناخبون من أجل حقوق الحيوان»: «إنه يمنحنا خط اتصالٍ
مباشرًا مع حكومة المدينة»، كما أنه متاح للمواطنين
أيضًا. وتقول كيم إنه إذا ساوَر شخصًا ما القلقُ بشأن
أمرٍ ما ولو بسيطًا مثل صيد السلاحف في المُتنزَّه
المحلي، فبإمكانه الاتصال بمكتب رفاه الحيوان.
يُمثل دور مكتب رفاه الحيوان مجرد لمحةٍ عما هو مُمكن.
اقترحت جانيك فينك، أستاذة القانون في الجامعة المفتوحة
في هولندا، أدوارًا سياسية أخرى لتحسين رفاهية الحيوان،
مثل إنشاء مؤسسات للدفاع عن حقوقها وأمناء مظالم خاصِّين
بالحيوانات، وإنشاء مجالس استشارية سياسية لقضايا
الحيوان، ومتطلبات الدستورية تُلزم المُشرِّعين بمراعاة
مصالح الكائنات غير البشرية، وتخصيص مُحامين مموَّلين من
الدولة للدفاع عن حقوق الحيوان.
42 يمكن أيضًا تعيين مُمثلين عن الحيوانات في
المجالس المجتمعية، ولجان التخطيط العمراني، وحتى مجالس
البلدية. ويرى محمد شاكر بيه، سفير الأمم المتحدة السابق
ووكيل محكمة العدل الدولية، أن الأمم المتحدة ينبغي أن
يكون لديها سفير للحيوان.
43
توجَد إمكانيات مؤسسية أيضًا. تريد لورا بريدجمان،
مؤسِّسة مجموعة سونار للدفاع عن حقوق الحيتانيات، تعيين
مُمثلين عن الحيتان والدلافين في اللجنة الدولية لصيد
الحيتان وضمهم إلى المَعنيين بالمحميات البحرية، جنبًا
إلى جنبٍ مع مُمثلي مصالح المجتمعات البشرية.
44 تتخيَّل عالمة القانون كارين برادشو كيف
يمكن تخصيص أراضٍ نشترك في ملكيتها مع الحيوانات يُديرها
أمناء مُكلفون بتمثيل مصالحها.
45 كما يمكن أن تضمَّ كل مؤسسة كبيرة — مثل
المتاجر أو الجامعات أو الشركات — مناصرًا لحقوق الحيوان
في مجلس أمنائها.
نجد أمثلةً على تمثيل الحيوانات سياسيًّا في تقاليد
الشعوب الأصلية. تكتب ليان سيمبسون عن تقاليد شعب
أوجيبوا الأول، وتقول إنها «كانت تُكِن احترامًا كبيرًا
لعشائر الحيوانات وتعتبرها «أُممًا» ذات سيادة وصاحبة
قرار (على الأقل بمفهوم الشعوب الأصلية) أجرى معها شعب
النيشنابيج علاقات تفاوضية رسمية، كان يحتاج إلى صيانتها
من خلال التواصُل المستمر.»
46 كما أُجريت معاهدات مع الحيوانات؛ أفضل
طريقة لفهمها هي اعتبارها مجموعةً من العلاقات
والمسئوليات المتبادلة، وليس اتفاقات قانونية رسمية.
وكانت مجتمعات أوجيبوا تجتمع لمناقشة القضايا المُتعلقة
بعشائر الحيوانات، وكل عشيرة كان لدَيها مُمثلون لحماية
مصالح أفرادها. كان تواصُلهم مع الحيوانات عميقًا. تقول
إيمي كرافت، الخبيرة في شعب الأنيشينابة وقانون الشعوب
الأصلية الكندي بجامعة أوتاوا: «جميع أمم الحيوانات
والأسماك والطيور تكون مُمثلة في هيكل العشيرة. وقد قيل
لنا إننا ننحدِر من سلالة تلك الكائنات. وباعتبارنا
أقرباءها، فإننا نُمثلها. وإن كنا لا ندعو الأسماك إلى
مائدة المفاوضات فعليًّا، فإن لدينا أقرباء لها
يُمثلونها في الحكومة.»
جميع الأمثلة التي ذكرَتها إيمي تتضمن حيوانات اعتمدت
عليها الشعوب الأصلية في غذائها، وكانت المسئوليات
تجاهها وعلاقات تبادل المنافع معها تُراعي الأفعال التي
تجعل موئلها وأعدادها تزدهر على المدى الطويل. قد يقول
قائل إن هذا النوع من التمثيل موجود بالفعل في هيئات
الحياة البرية على مستوى الولايات، غير أن ثَمَّة
اختلافات مُهمة. فقرارات إدارة الحياة البرية تُركز على
نوعٍ معين؛ فحين يُتخذ قرار بشأن الغزال، لا يراعى فيه
مصالح حيوانات القيوط، ويُستبعد منه عادةً مُمثلوها. كما
تُعَد الحيوانات البرية ملكية للولاية، وليست مُنتمية
لها. كما أن نقاشات القرابة الجدية لا تدخُل في حسابات
الإدارة. ورغم أن تطبيق هذه المبادئ في بعض السياقات
المُعاصرة مثل المدن والضواحي، أو تطبيقها على الأنواع
التي لا يعتمد عليها البشر قد يبدو صعبًا — إذ تقول
إيمي: «أنا عن نفسي أحاول أن أفهم ما يَعنيه ذلك» — فإن
إيمي تعتقِد أن تمثيل مصالح الحيوانات هو القرار الصحيح.
وتقول: «أحد الأشياء التي أطالب بها هو منحها مقعدًا على
طاولة المفاوضات.»
من المُمتع تخيُّل كيف سيُدار اجتماع رسمي يضم مُمثلين
لأنواع متعددة؛ يمكن أن تُعين لجنة إدارة بركة تجميع
مياه الأمطار مُمثلين عن سمامات المداخن والسنونوات
وطيور أبي الحناء، والضفادع والجرذان والراكون والأرانب.
قد يكون مُمثلو الضفادع حسَّاسين خصوصًا تجاه قضايا
استخدام المبيدات في الحي، وكذلك مُمثلو السمامات
والسنونوات. ومن المؤكد أن مُمثلي السمامات سيطالبون
بمعرفة الجدول الزمني لصيانة المداخن. وسيتحدَّث مُمثلو
الأرانب باستفاضة عن جذِّ العشب. وقد يقبل مُمثلو أبي
الحناء إزالة اللبلاب الإنجليزي غير المحلي قبل أن يزيد
طولها عن طول الأشجار، ولكنهم سيُطالبون بقطْعها
تدريجيًّا حتى لا تجوع المخلوقات التي تقتات على توتها
الغني بالدهون طوال الشتاء. قد يكون ذلك تصوُّرًا
خياليًّا بعض الشيء، لكن الغرَض من الاستشهاد بهذه
التقاليد هو توسيع حيز الخيال، وتذكيرنا بأن منح
الحيوانات صوتًا سياسيًّا ليس بالأمر غير المسبوق. هناك
عصور كانت فيها هذه الأمور طبيعية تمامًا. ومن منظور
آخر، فإن عدم تمثيل الحيوانات مُخالف للعادة.
تجسد السياسات التي طُبقت في مدينة نيويورك أيضًا
مثالًا بسيطًا لما يمكن فعله. كما طُوِّرت العديد من
الابتكارات والممارسات المُثلى المتعلقة بالحيوان
والحفاظ على البيئة؛ لكننا لا نحتاج سوى أن تُصبح هي
المعيار وليس مجرد نقاطٍ مضيئة استثنائية. أحد الأمثلة
المُفضلة عرفتُه من جايل فريزر في مقابلة معها، حيث قالت
لي إنها تشارك في الأوقات التي لا تدرس فيها الغاق في
برنامج «أونتاريو سويفتواتش»، أو مراقبة سمامات
أونتاريو، وهو برنامج نظمته جماعة «طيور كندا» للحفاظ
على البيئة، يسجل فيه المواطنون، من مُحبي الطيور،
المداخن التي تعشش فيها السمامات. يتابع تقاريرهم قسم
التخطيط العمراني في تورونتو، وعندما يتقدَّم مالك عقار
بطلبٍ لتطوير أحد هذه المواقع، يتم تمييز طلبه. وتتعاون
معه المدينة لتجنُّب إجراء أعمال التطوير في موسم
التعشيش، بل تعمل على الحفاظ على المدخنة القائمة أو
بناء مدخنة جديدة. يحدث شيء مُشابه في لندن بإنجلترا،
حيث يفحص مراقبو الخفافيش المُرخَّصون أعمال التجديد
والبناء الجديدة لحصر الخفافيش، التي تُعَد جميع أنواعها
محمية في أوروبا. ويوصي مراقبو الخفافيش بطرُق مُعينة
لتجنُّب إزعاجها وجعل كل مبنًى بيتًا جيدًا لها مثل ذي
قبل، أو حتى أفضل.
غير أن سمامات المداخن والخفافيش تُعَد الاستثناء. أما
الحيوانات غير المُعرَّضة للانقراض أو غير المُهدَّدة به
فلا توضع في الاعتبار عادةً أثناء التخطيط والتطوير. كيف
لو أننا طبقنا مثال الخفافيش في كل مكان، وليس فقط على
الأنواع المحمية، إنما على الكائنات الشائعة أيضًا؟ في
الوقت الراهن، غالبًا ما لا ترد الأنواع الشائعة في
بيانات التأثير البيئي، إلا ليُقال إن التأثيرات الواقعة
عليها ليست مُهمة.
وإذا كان ذلك الاحتمال يُثير مخاوف من زيادة الإجراءات
الرسمية والبيروقراطية، فلا حاجةَ لأن يكون تطبيقه
معقدًا. عندما انضممتُ إلى اللجنة المحلية التي تُساعد
في تنظيم أعمال التطوير في محيط هور بينجاجاووك بولاية
مين، ضغطنا من أجل استخدام أساليب تسييج وجداول تشذيب
للعُشب ملائمة للحيوانات البرية في مزرعة طاقة شمسية كان
من المُقترح بناؤها. واستندنا في مطالبنا إلى أدبيات
جديدة عن التصميم الصديق للحيوانات شملت أيضًا نوافذ
صديقة للطيور، وإضاءة آمنة للحيوانات، ومعابر آمنة
للحيوانات البرية على الطرق، والاهتمام بإنشاء ممرَّات
تربط المناطق الزاخرة بالحياة الطبيعية. استشهدت ليزلي
فوكس، المديرة التنفيذية لجماعة ذوات الفراء المناصرة
لحقوق الحيوان، بما حدث في مدينة أوكفيل، بمقاطعة
أونتاريو، حيث تعاوَن دُعاة الحفاظ على البيئة ومناصرو
حقوق الحيوان لوضع استراتيجيات إدارة الحياة
البرية
47 والتنوُّع البيولوجي
48 في المدينة. تتضمَّن هذه الاستراتيجيات كل
شيء بدايةً من إيكولوجيا الطرق وإدارة السهول وانتهاءً
إلى مناقشة مُستعمرات قنادس بعينها، ووضع خططٍ لتقليل
الصراع مع أُمهات الإوز العدوانية من خلال إحاطة أعشاشها
بسياج مؤقت.
باختصار، توجَد طرق عديدة لدعم مصالح الحيوانات
المواطِنة والمُقيمة وأعضاء الأمم البرية عندما يتَّخذ
المجتمع قرارًا يؤثر عليها. هذا لا يَعني أن التمثيل هو
الحل الجذري لجميع المشكلات؛ إذ يمكن نظريًّا تحويله إلى
عملية تخدم المصالح الذاتية. ولنا عبرة في لجان رعاية
واستخدام الحيوانات المؤسسية، التي يُفترَض أنها تُمثل
مصالح الحيوانات المُستخدمة في الأبحاث بالجامعات،
ولكنها غالبًا ما تُوافق على مقترحات غير إنسانية أو غير
ضرورية.
49 غير أن هذه التحفظات تنطبق في السياقات
البشرية أيضًا. فقد يكون الوصي على طفل أنانيًّا، لكن
توجَد آليات تضمن أن يكون تصرُّفه في صالح الموصى عليه.
كذلك، قد توجَد خلافات بين الحيوانات؛ ألا يمكن أن يكون
للدببة والسلمون وجهتا نظر مختلفتان بشأن إدارة السلمون؟
وماذا سيحدث عندما يضرُّ تطوير الموئل أو حتى تغير
المناخ ببعض الحيوانات ولكنه يفيد البعض الآخر؟ هل يجب
التعبير عن مصالح الحيوانات التي قد تزدهِر نتيجة ارتفاع
درجة الحرارة مؤخرًا في منطقة القطب الشمالي؟ لكن تلك
كلها ليست مبررات للاستسلام.
عندما سألتُ إيمي كرافت عن تضارب المصالح بين
الحيوانات قالت: «لا بد من وضع جميع الأصوات في
الاعتبار، مع إدراك أنه لتحقيق الأفضل لجميع الأطراف،
ستحتاج إلى أن تراعي المصلحة العامة.» ينطبق ذلك أيضًا
على الحالات التي تتضارَب فيها مصالح البشر مع مصالح
الحيوانات. ليس من السهل دائمًا المفاضلة بين العديد من
المصالح والقِيَم، ولكن هذا هو الدور الذي صُنعت لأجله
المؤسسات الديمقراطية. فنحن نحاول أن نضع في اعتبارنا
عددًا أكبر من وجهات النظر، ونُشجع المزيد من المناقشات،
وأن نكون منصفين. وعدم تمثيل الحيوانات ليس هو الحل
أبدًا.
•••
في بعض الأحيان، يتساءل الناس إذا كان من الممكن أن
نعرف ما هو الأفضل للحيوانات فعلًا أو ما تريده
الحيوانات. وهذا في رأيي تخوُّفٌ مبالَغ فيه. من المؤكد
أنه من المُهم التدقيق في الادعاءات المقدمة نيابة عن
الحيوانات، كما أنه توجَد حالات يصعب فيها الاختيار؛
فإذا مُنحَت أنثى بيسون في يلوستون الفرصة لأن تختار بين
تنظيمِ حجم قطيعها عن طريق وسائل منْع الحمل أو عن طريق
القتل رميًا بالرصاص، فأيُّهما ستختار، مع الوضع في
الاعتبار أن اختيار الحياة الطويلة سيأتي على حساب
التكاثُر؟ لكن في العادة تكون الأمور واضحة. فمِن الأفضل
للهوازج ألا تبتلِع مبيدات. ومن الأفضل للسلاحف ألا
تدهسها السيارات. كما أنه لا أحد يُحب أن يفقد
بيتَه.
يسهل تخيُّل موقفٍ أكثر إنصافًا ومراعاة مما يحدُث
الآن للغاق. ففي أواخر عام ٢٠٢٠، أعلنت وزارة الأسماك
والحياة البرية الأمريكية أنها ستسمح بقتل ما يصِل إلى
١٢١٫٥٠٤ — أي ما يقرب من ١٣ في المائة من عددها — كل
عام، وستُسهل الحصول على التصاريح اللازمة.
50 علاوة على ذلك، سيُسمح الآن بقتلِها لمجرد
أن لها تأثيرًا على أعداد الأسماك البرية، أو مجرد
اعتقاد ذلك.
51 في تعليقٍ لها على تلك الخطة شاركته معي،
كتبت ليندا وايرز، عالمة الأحياء المُتخصصة في الطيور
المائية، تقول إن هذه الخطة ستُضفي «شرعية على المواقف
غير العقلانية، وتسمح بتدمير الطيور بناءً على خرافات
ومفاهيم خاطئة.»
وقالت لي: «لقد أجريتُ مئات الدراسات التي تبحث
الحميات الغذائية للغاق وتحاول تحديد تأثيرها على أعداد
الأسماك، لكن تحديد ذلك ليس سهلًا.»
52 قد «يبدو» الأمر واضحًا — فهي تأكل الأسماك
الصغيرة قطعًا! — غير أنه يصعب معرفة ما إذا كان
افتراسها لتلك الأسماك يقلل عددها فعليًّا، أم إنه في
الواقع يخلق فرصًا بيئية لأسماك أخرى، بحيث تكون
تأثيراتها على مستوى الجماعات ضئيلة. وتقول ليندا إن
معظم الدراسات تُشير إلى أن انخفاض أعداد الأسماك
المفترَسة يرجع إلى أسبابٍ أخرى. في البحيرات العظمى،
تشمل هذه الأسباب التلوث، والتغيرات في مستويات
المُغذيات، وضغوط الصيد البشري. وفي غرب الولايات
المتحدة، منعت السدود أسماك السلمون من الوصول إلى
الجداول والأنهار التي تضع فيها بيضَها. يقول جيمس
لودفيج: «لكن الحل سهل للغاية. وُجِّه اللوم للطائر
الأسود. فلا بد أن تُبين لناخبيك أنك تفعل شيئًا
لهم.»
هذا لا يعني أن طيور الغاق لا تتسبَّب على الإطلاق في
انخفاض أعداد الأسماك؛ فهي تكون مسئولة عن ذلك في بعض
الأحيان. ولكن هل يمكن لطيور الغاق أن تُعزز إنتاجية
النظام البيئي بطرُق أخرى؛ مما يساعد الأنواع الأخرى على
الازدهار؟ إحدى حِيَل الصيد هي نصب الشباك تحت
مُستعمراتها، في المياه التي تُغذي فيها فضلاتها الغنية
بالمُغذيات اللافقاريات التي تأكلها الأسماك الأخرى. غير
أننا عندما ننظر إلى طيور الغاق — وبالتبعية الأراضي
والمياه التي تعيش فيها — فقط من حيث إنتاج الأسماك لأجل
البشر، فإننا نغضُّ الطرف عن هذه التعقيدات. حتى إذا
كانت تأثيرات الطيور هي الأوضح، فهل يعني ذلك أنه يجب أن
نقتُلها بسبب ذلك؟ إذا كنا نسمح لنوعٍ بأن يعيش فقط على
هامش الطبيعة التي وضعنا يدنا عليها، فماذا يقول ذلك
عنا؟
من ضمن عشرات المشاركين في الاجتماعات الإقليمية
السابقة لقرار هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية
النهائي، لم يكن هناك مُمثل واحد عن جماعة حفاظ على
البيئة أو مناصرة لحقوق الحيوان.
53 كما لم يكن ضمنهم عالِم أخلاق يتحدَّث في
القضايا التي غابت بوضوح عن استراتيجية إدارة الغاق، كما
كتب عالِما الأخلاق البيئية تشيلسي باتافيا ومايكل بول
نيلسون في مقالٍ في مجلة «ووتربيردز». كتبا: «لو أن طيور
الغاق اعتُبرت غايةً بحد ذاتها، لا مجرد وسيلة، فلم يكن
من الممكن قَط التغاضي عن مصالحها بهذا الشكل.»
54 لم يكن النوع مهددًا بعد؛ لكن، على حدِّ
قولهما، المسألة الأكثر إلحاحًا هي: «إذا كنا نقتل الغاق
للقضاء على المنافسة (أو المنافسة المُفترَضة) مع البشر،
فهل نحن بذلك نتحرى الإنصاف في تقاسُمنا للموارد
المشتركة؟» لكن أحدًا لم يسأل عما يَعنيه التقاسُم أو
المشاركة.
غير أن ذلك كان أقلَّ فظاعةً مما حدث في كندا، حيث
اقترحت حكومة أونتاريو في عام ٢٠١٨ موسمًا مفتوحًا لصيد
الغاق دون قيد؛ إذ سمحت لكل صيادٍ بصيد حتى ٥٠ طائرًا
يوميًّا من بداية موسم التعشيش وحتى بعد هجرتها بفترة
طويلة.
55 كانت تلك خطة صريحة للإبادة، حتى إنها لم
تُثِر غضب مناصري حقوق الحيوان فقط، بل أيضًا دُعاة
الحفاظ على البيئة
56 وعلماء الحكومة.
57 بعد تسويفٍ دامَ عامًا، تم تعديل
الخطة.
58 أصبحت تمنع قتْل طيور الغاق خلال موسم
التعشيش، لكنها تسمح باستئناف قتلِها ابتداءً من منتصف
سبتمبر. وخُفِّض العدد اليومي المسموح لكل صيَّاد إلى
١٥، ولكن بخلاف الطيور الأخرى المسموح بصيدها، لا يلزم
الإبلاغ عن الطيور المقتولة من الغاق، ويمكن إلقاؤها في
مكبِّ النفايات. تظل تلك خطة إبادة.
لعل أيامًا مظلمة تنتظر تلك الطيور السوداء مجددًا؛
لكن ليز وايت أكدت لي أن تحالف الحيوان وغيره من
الجماعات المحتجة سيواصلون احتجاجاتهم. وأن طيور الغاق
ستظل آمنة في مستعمرة ليسلي ستريت سبيت، آخر مجتمع كبير
للغاق في أمريكا الشمالية. فهناك من يدافعون
عنها؟