إنقاذ الآفات
من حين لآخر، يُقابل المرء طفلًا يعامل الحيوانات برقة استثنائية. ربما كنتَ واحدًا من أولئك الأطفال. كان براد جيتس واحدًا منهم؛ فكلما وجد أحدٌ في حي سكاربورو الذي يسكنه في ضواحي تورونتو فرخًا يتيمًا، كان جيتس هو الطفل الذي يعتني به. كان يربي الأرانب والسناجب والحمام، وكان يقضي أيام الصيف البديعة الطويلة في استكشاف الأخوار التي تتخلَّل البلدة كأصابع اليد، والتي تجعل طوبوغرافيتها عصية على التطويع البشري.
في شهر أبريل من السنة الأخيرة لجيتس في المدرسة الثانوية، رأى إعلانًا في إحدى الصحف لشركة محلية مُتخصصة في طرد الحيوانات البرية من المنازل تعرِض فيه حيوانات راكون رضيعة للتبنِّي. كان ذلك عام ١٩٧٩، قبل أن يصبح امتلاك الحيوانات البرية غير قانوني، وسرعان ما أصبح جيتس متبنِّيًا فخورًا لكرة الفراء اللحوحة البالغة من العمر ثلاثة أسابيع، والتي أطلق عليها اسم ماندي. قضى آخر صيف في مراهقته يعتني بماندي حتى بلغت سِن المراهقة. أصبحت رفيقته الدائمة، ورافقته في جولاته في الأخوار، ومباريات كرة القدم في المُتنزَّه؛ بذل قصارى جهده في تعريفها على العالم الذي ستحتاج أن تعيش فيه قريبًا. في نهاية الصيف، مع اقتراب موعد بدء الدراسة الجامعية، بدأ يترُك باب قفصها الموضوع في الفناء الخلفي مفتوحًا بالليل. ومع بدء الدراسة، انقطعت ماندي عن العودة إلى قفصها.
ذات ليلة بعد عامَين، بينما كان يركن سيارته في ممر السيارات بمنزله بعد يومٍ دراسي، اندفع راكون من أمام أضواء سيارته الأمامية. ورغم أنه لم يرَ ماندي منذ أن سمح لها بالرحيل، فإنه خرج من السيارة وصفَّر اللحن الذي كان يستدعيها به عندما يحين وقت إطعامها. كانت هي بالفعل الراكون ماندي. اندفعت عبر العشب، وتسلَّقت ساقه، ووقفت على كتفِه، وأغارا معًا على ثلاجته وتقاسما عشاءه على العشب. كانت تلك آخر مرة يراها فيها.
يتذكَّر جيتس الآن ذلك الحدث باعتباره لحظةً فارقة في حياته. إذ قرَّر بعدها أنه يُريد أن يعمل مع الحيوانات البرية، لا سيما الراكون، وحصل بالفعل على وظيفة في شركةٍ لطرد الحيوانات البرية. غير أن ذلك العمل خالف توقُّعاته. إذ وجد أن حيوانات الراكون تعامل باعتبارها آفات. عندما يُبلِّغ شخص ما عن وجود حيوان بري في عليَّته، تضخ الشركة مادة الفورمالديهايد من خلال آلة تبخير لطرده. وكثيرًا ما كانت تلك الطريقة تفشل في تحقيق النتيجة المرجوة، فكان الحيوان المسكين يختبئ في زاوية وقد التهبت عيناه ورئتاه. كانت العديد من تلك الحيوانات أُمهات تتمكَّن من الهرب بينما تعجز عن ذلك صغارها، فتُترك وحيدة؛ وكان ذلك هو المصير الذي أدى إلى وضع ماندي في قفص وعرضها للتبنِّي.
لم تكن الشركة التي عمل بها جيتس فريدة في ممارساتها؛ إنما كانت تلك هي الممارسات السائدة في تلك الصناعة. يتذكر جيتس الآن فيقول: «كان ذلك غير إنساني بالمرة. وكان دافعًا لي لتطوير تقنيات إنسانية تمامًا.» وهكذا، بعد ٤١ عامًا، ذات صباح يوم شديد البرودة من أيام مارس، كان يقف فوق منزلٍ من طابقين في ضواحي ماركام، أونتاريو، حيث وصل هو وابنته كاسندرا في شاحنة بيضاء تحمل اسم شركته «إيه إيه إيه جيتس وايلدلايف كونترول»، ورمز الراكون، وشعار الشركة: «الاختيار الأول للحيوانات».
كان أصحاب المنزل يسمعون ضوضاء؛ ووقع اختيارهم على شركة جيتس، ليس بسبب اختياره لأول حرف في الأبجدية مكررًا ثلاث مرات اسمًا لشركته، وهي حيلة قديمة ليتصدَّر اسم الشركة دليل الهاتف، ولكن بسبب سُمعته. لقد ذاع صِيته باعتباره رائدًا، بل ثوريًّا في التعامُل السلمي مع مشكلات تعدي الحيوانات البرية على المنازل في المناطق الحضرية؛ وهو ما يمكن أيضًا تسميتُه بمكافحة الآفات، وإن كان جيتس لا يستخدم المصطلح كثيرًا. يضم أسطوله ما لا يقلُّ عن إحدى عشرة شاحنة، بالإضافة إلى رخصة ممارسة نشاطه في فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كل ذلك يشهد على نجاحه، وعلى تزايد التعاطف العام مع الحيوانات. فبالنسبة إلى الكثيرين، حتى ما يُسمى بالآفة، وهو حيوان يتعدى على منزل المرء وقد يُشكل تهديدًا للممتلكات والسلامة الشخصية، يظل كائنًا حيًّا ينبغي معاملته برفق.
قد يسأل سائل: هل هذا مُهم حقًّا؟ وهو تساؤل مفهوم؛ والإجابة هي بالتأكيد، فذلك أفضل قطعًا من أن يحدث العكس، ولكن عندما يتعلق الأمر باعتبار الحيوانات البرية أشخاصًا مثلنا، ألن تأتي حيوانات مثل الفئران والراكون والحمام في ذيل القائمة؟ ففي النهاية، الحيوانات التي يكترث لأمرها أمثال جيتس لا تعتبر دائمًا حيوانات برية فعليًّا أو حتى جزءًا من الطبيعة. ومع اختفاء العديد من الأنواع، مثل النجوم في ليلة ضبابية تضيئها أنوار الشوارع، هل رفاهية هذه الحيوانات الشائعة في المدن مهمة إلى هذا الحد؟ فهي ليست مُعرضة لخطر الانقراض. ومع ذلك، تمثل هذه الحيوانات نقطة الْتقاء بين الحياة البرية والبيئات الحضرية؛ مما يتحدَّى أفكارنا عن الطبيعة. وكيفية تعامُلنا معها تعكس فهمنا للعالم الطبيعي في الأماكن التي يُهيمن عليها البشر.
تتأثر الكثير من الأرواح بالطريقة التي نتعامل بها مع الحيوانات التي تُزعجنا. وبغضِّ النظر عن أعدادها الهائلة، يمكن اعتبار محنة الكائنات التي نعيش معها في مواطننا الحضرية تُجسد العيش على كوكب يسود البشر أرجاءه. إن أخلاقيات التعامُل مع المدن وما يُسمى الآفات والحيوانات البرية غير المرغوب فيها لهي أمرٌ ضروري في عصر الأنثروبوسين. هل سيكون عصرًا لا تُقبَل فيه الحيوانات البرية إلا إذا لم تُسبِّب أي إزعاج؟ عصرًا تكون فيه مُرحَّبًا بها ما بقِيَت في المساحات المُخصصة لها، دون أي اتصال بالبشر أو مطالبات أخلاقية منهم؟ عصرًا تكون فيه قيمة الأرواح من عدمِها خاضعة لتقدير البشر؟ في المدن، نواجِه تحديًا تصِفه إيرين لوثر أستاذة الدراسات البيئية بجامعة دالهاوزي بأنه لا يقلُّ صعوبةً عن «ما يعنيه حقًّا العيش مع الآخر في العالم.»
•••
لا بد أن دخول جيتس وكاسندرا إلى العلية، مُرتدِيَين بذلة العمل والقناع الواقي، سيكون صادمًا للراكون الأم التي تعيش بالداخل مع صغارها. ربما تكون هذه هي المرة الأولى في حياتها التي يدخل فيها أي شخصٍ عليها، وتخترق أضواء الكشافات شرنقة الظلام المُحيطة بها. ينوح الصغار الذين باغتَهم الإزعاج المفاجئ في حين تتراجع الأم إلى متاهة الألواح الخشبية المُتقاطعة والعوارض التي يرتكز عليها السقف المائل على الأرضية.
يُحييها جيتس بصوتٍ هادئ رزين قائلًا: «أهلًا أيتها الأم»؛ في مُقابلتي معه كان أيضًا الهدوء والرزانة يطغَيان على صوته وحركته. الهدوء هو شعور يريد أن ينقله إلى الحيوانات، وهو أحد متطلبات وظيفته؛ فعندما تكون واقفًا على سُلم على ارتفاع ١٥ قدمًا من الأرض، لا يبعد جُحر سنجابةٍ أُمٍّ عن وجهك إلا بضع بوصات، تحتاج إلى رَباطة جأشك وهدوئك. لكن الموقف الحالي ليس فيه ما يُثير القلق. بالطبع يمكن لحيوانات الراكون أن تُدافع عن نفسها بشراسة، لكن هنا الأم اختبأت ببساطة.
قبل أن تطلُب صاحبة المنزل المساعدة، بحثت عن منافذ يمكن أن تكون الراكون الأم قد دخلت منها، لكنها لم تجد شيئًا. وعندما وصل جيتس وكاسندرا، نصبا سُلَّمهما، وصعدا إلى السطح، وتوجَّها إلى أنبوب التهوية. غالبًا ما يصنع البناءون فتحة أكبر من اللازم لأنبوب التهوية؛ مما يترك فراغًا بسيطًا بعد تركيب الأنبوب، يسدُّونه بشريحةٍ من المطاط. تكون تلك البقعة نقطة ضعيفة في السقف المصنوع من الخشب واللباد العازل والألواح التي تستعصي على الاختراق. فإذا استطاعت الراكون إدخال يدَيها تحت شريحة المطاط وخلخلة بعض المسامير، فستتمكن من النفاذ إلى العلَّيَّة.
يصف جيتس حيوانات الراكون بأنها مُفتشة منازل صغيرة. ينطبق ذلك الوصف أيضًا على السناجب، التي تتخصَّص في النفاذ من أنابيب الصرف والسطح التحتاني للسقف، تلك الألواح الصغيرة من البلاستيك أو الألومنيوم التي تُغطي بروز السقف من أسفل. (اعتراف: لم أكن أعرف شيئًا عن تلك الألواح حتى شرح جيتس عن السناجب. من المُثير للاهتمام التفكير في أن العديد من الحيوانات التي تعيش في الحضر تعرف عن المباني أكثر من ساكنيها من البشر.) لا تحتاج إلا إلى العثور على ثغرة تكفي لإدخال فمِها وعندئذٍ تبدأ المضغ؛ وبعد ساعات أو أيام، ستتمكن من تمرير جسدِها كله من خلال هذه الثغرة.
يقول جيتس: «ستُبيِّن لك مواطن العيب.» غالبًا ما يجد علامات، مثل قطعة مُقشرة من المعدن، ناتجة عن جولات الراكون الاستكشافية. تنشر حيوانات الراكون ما تتعلَّمه فيما بينها؛ ففي الحي الذي تتعلم فيه إحداها اختراق نوعٍ مُعين من فتحات التهوية، سرعان ما يقلدها غيرها. يعتقد جيتس أنه توجَد اختلافات ثقافية بين حيوانات الراكون في كل منطقة؛ إذ يتخصَّص بعضها في تلك المنازل المتينة الأنيقة المبنية في بداية القرن العشرين، والبعض الآخر في المنازل المبنية على طرز البناء الحديثة. كانت فتحات التهوية البلاستيكية المُستخدمة في الأسطح مفيدة لشركته.
تعرف حيوانات الراكون في مدينة ماركام أيضًا الكثير عن مواد العزل. معظم أرضيات العليَّات مكسو بمسحوق السليلوز الناعم، المصنوع من ورق الجرائد المطحون، والذي يترك فراغاتٍ أقل من الألياف الزجاجية. لا بد أنه يُلهب عينيها وأنفها؛ يقول جيتس إنه عندما يدخل الراكون إلى علية، فإنه يبحث عن الأجزاء المائلة المخلوط فيها السليلوز بالألياف الزجاجية كي لا ينزلق عليها مثل الجليد. في إحدى تلك المساحات المائلة على وجه التحديد، وفي زاوية خلفية تُوفر بعض الحماية، صنعت الأم عشًّا. داخل العش توجَد الصغار، عددها ستة، وهي مكسوة بالزغب، وعيونها مغلقة، ولها رءوس كبيرة، وتتجمَّع كلها في كتلةٍ دافئة كالكرة، تُصدر أصواتًا حادة عالية النبرات استجابةً لذلك الغزو لمَكمنها الآمن الذي يُمثل لها العالم بأسره حتى الآن.
يقول جيتس إنه عندما بدأ في ذلك العمل، كان معظم الناس يعتبرون قتل الحيوانات هو الحل الأمثل للمشكلات. وفق تلك المعايير، تُعَد أجهزة التبخير بالفورمالديهايد تقدُّمًا فعليًّا. حتى الشركات التي وعدت بتبنِّي طرق رحيمة لم تلتزم بها دائمًا. فهي قد تضع مصيدة ولا تُتابعها، إنما تعتمد على أن يُتابعها العملاء الذين ينسون ذلك في كثيرٍ من الأحيان بسبب انشغالهم، فتترك الحيوانات التي تعلق فيها لتموت ببطء. وحتى إذا تابعوا المصيدة، فمن الشائع أن تؤخَذ الأم ويترك صغارها يتضوَّرون جوعًا دون قصد.
تضع كاسندرا برفقٍ صغار الراكون في كيس قماشي. ستضعها في صندوق معزول تتركه على السطح. أما الأم فستُغادر العلية عندما تكون مستعدة، وإذا سار كل شيءٍ كما هو مخطط له، فستجد صغارها وتنقلها إلى عشٍّ جديد، بعد ذلك سيسدُّ الثقب الذي دخلت منه. لن يُربكها ذلك كثيرًا. فعلى الأرجح لدَيها عشرات المواضع التي تعرفها ويُمكنها الاختباء فيها. أخبرَني جون هاديديان بأنه عندما وضع أجهزة إرسال بالراديو على حيوانات الراكون التي تعيش على أطراف مُتنزَّه روك كريك، ذلك الشريط من الغابة القديمة الذي يمرُّ عبر قلب واشنطن العاصمة، وجد أن أُنثى واحدة تجوَّلت بين نحو ٢٠٠ جُحر، ما بين تجاويف في الأشجار، وأكمات صغيرة، وألواح خشبية موضوعة في ترتيبٍ موائم، والمجاري، وبضعة عليَّات.
ينزل جيتس وكاسندرا بصغار الراكون إلى الطابق السُّفلي لفترة وجيزة ليُصوروها ويسمعوا هتافات الإعجاب بلطافتها. ثم يُوصِّل جيتس سلكًا كهربائيًّا طويلًا جدًّا بمِقبس خارجي ويتسلق السطح مرة أخرى. ذلك السلك موصول بوسادة تدفئة موضوعة، مع سترة قديمة وبعض الألواح العازلة من مادة الستايروفوم، داخل صندوق ذي باب منزلق صنعَه هو وكاسندرا. الصندوق بمشتملاته هو أحد ابتكاراته. بدونه سيتجمَّد الصغار على الأرجح. بعد أن جهز الصندوق، وضع فيه الصغار الذين كانوا يرتجِفون ويتشبَّثون بعضهم ببعض. إنه مشهد مؤثر، لكن الخبرة الطويلة علَّمت جيتس أن هذا هو الحل الأفضل. تندسُّ الصغار في السترة في حين يُغلق الصندوق ويُثبته في السطح بإحكام بمسامير.
بعد أن يُتم جيتس مهمته، يقف برهة ليتأمَّل مشهد أسطح المنازل وأشجار الأفنية الخلفية التي تمتدُّ في جميع الاتجاهات؛ وهو منظر يشترك في رؤيته سكان تلك المنازل، الذين نادرًا ما يكون لديهم سبب للصعود إلى أسطحها، وكذلك الطيور والسناجب وسائر الكائنات الأخرى التي تسكن الحي. (تتضمن تلك القائمة حيوانات الراكون أيضًا، لكن قِصر نظرها يمنعها من رؤية المنظر.) يقول جيتس إن العملاء يعتقدون غالبًا أن انتشار الحيوانات البرية في الحضر ناتج عن تدمير موائلها مما دفعها إلى اللجوء إلى المدن. قطعًا قُطعت غابات لبناء هذه المنطقة الحضرية، ولم تعُد ملائمة للسكنى لكثير من الأنواع التي كانت تسكن هنا من قبل، لكن بالنسبة إلى الأنواع التي أمكنها التكيُّف على ذلك التغيير، فقد باتت موطنها. أصبح هذا موئلها الآن.
يقول جيتس: «تستحق الحيوانات أن تعيش في بيئاتنا الحضرية بقدر ما نستحقُّ نحن ذلك.» كلماته بسيطة لكنها عميقة: المدينة ليست مجرد موئل لها، إنما هي موطنها؛ إنها تنتمي إلى المكان. وذلك حكم اجتماعي بقدْر ما هو حكم بيئي.
يرى جيتس أن عمليات الفحص تتعلَّق أيضًا بنشر ثقافة التعايش. إذا ترك فتحات التهوية دون أن يسدَّها وعاد راكون، فإن الموقف الذي انتهى اليوم بالهتافات السعيدة وسماحة النفس يُمكن أن يتفاقم. فالتسامح مع المُشكلات يتضاءل بتكرُّرها. يقول: «إذا كان بإمكاني أن أوفِّر للناس حلًّا يَقيهم من الحيوانات بنسبة ١٠٠٪ مستقبلًا، فلن تُزعجهم الحيوانات بعد الآن. وسيُعلمهم ذلك أنه يُمكننا التعايش معها في وئام.»
•••
أما الحكاية المُفضَّلة لجيتس فهي عن أنثى راكون تعيش في مرأب. كشف فحصُه أن المبنى سليم لا ثغرات فيه من الناحية البنائية. لم يتمكن من معرفة كيف تَدخُل إلى المرأب فصعد إلى ألواح السقف، فرآها تنزل من على عمودٍ مُثبت عليه زرار فتح باب المرأب الكهربائي، وتتمهَّل، ثم تضغط على الزر، وتتبختر خارجة. كان لديها عش فيه صغار؛ مما يعني أنها ظلَّت تدخل وتخرج من المرأب شهورًا. يخمن جيتس أنها كانت تخرج في الليل أثناء نوم صاحب المنزل، ثم تُغلق الباب عند عودتها في الساعات المبكرة من الصباح، فلا يراها البشر وهي تفعل ذلك.
لكننا حتى في عداوتنا لحيوانات الراكون نُكنُّ لها قدرًا من الاحترام. فماذا عن تلك الحيوانات التي لا نُكنُّ لها أي قدرٍ من الحب؛ وأنا أقصد القوارض، لا سيما الفئران والجرذان؟ الخط الفاصل بين التخلُّص من الحيوانات البرية ومكافحة الآفات غير واضح، ولكن من المؤكد أن العديد من الناس سيُصنفون الفئران والجرذان في فئة مختلفة تمامًا عن الراكون. بالطبع، لا يزال الناس يُعاملونها بلُطف في بعض الأحيان؛ إذ تَلقى مصائد الفئران الرحيمة آلاف التقييمات على متجر «أمازون» الإلكتروني. عندما سألتُ مارجريت روبنسون، عالِمة الاجتماع التي تدرس شعب الميكماك، كيف تُطبِّق القيم الموروثة كالاحترام والمعاملة بالمِثل والقرابة على ما يُسمى بالآفات في حياتها، فحكت لي عن مرةٍ اصطادت فيها فئرانًا في شقَّتها ووضعتها في قفصٍ لحيوانات الهامستر الأليفة. لكنها قرضت فيه ثغرة خرجت منها وأخفتها بقطعةٍ من الفرش. (تقول: «كان الأمر أشبه بفيلم «الهروب من سجن ألكاتراز» (إسكيب فروم ألكاتراز). وخلصت إلى أن تلك الفئران أشخاص مُستقلون.») قررت مارجريت ألا تقلق وتترك المشكلة تحلُّ نفسها بنفسها، لكنها تُدرك أن موقفها ذلك لن يجدي في حالة غزو فعلي.
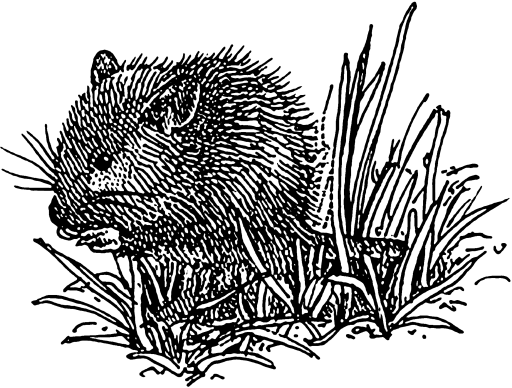
تقول ماريا تشين إن بيستي اجتماعي أكثر بكثير من ماجي، التي توفيت عام ٢٠١٩، بعد ثلاث سنوات من تبنِّيها هي وشريكها لهما. ثلاث سنوات هي سِن كبيرة بالنسبة إلى الجرذان، وربما كانت ماجي أكبر عمرًا من ذلك، فقد كانت بالغة بالفعل عندما وجداها في الملجأ. ارتبطت ماجي بسرعةٍ ببودنج كلب ماريا، لكنها لم تتسلق كتفها وتنَمْ عليه، في علامة على الثقة التامة، إلا بعد بضعة أشهُر. كانت تشين تأخذها معها إلى المدرسة وتصحبها في مشاويرها. كانت تُحب رؤية رد فعل الناس. تقول: «في بعض الأحيان ينظر الناس إلى جرذٍ ولا يخافون منه. كانوا يسألون: «أهذا فأر؟ أهو هامستر؟» ثم ما إن يُدركون أنهم ينظرون إلى جرذٍ حتى يتملَّكهم الهلع.» فالسُّمعة تسبق الحقيقة.
الجرذان نوعٌ مُثير للاهتمام، يمكن أن نتأمَّل من خلاله في النقاشات الدائرة عن أوجه التشابُه والاختلاف بين البشر والحيوانات الأخرى، ونبحث ما إذا كان لهذه الاختلافات والتشابُهات معنًى أخلاقي. ربما تكون المتعة التي تنالها الجرذان من حكِّ بطنها وجه تشابه أثقل وزنًا من أي اختلافات. وفي حين أن الحماية الواسعة النطاق مطلب غير واقعي، فإن اتخاذ الخطوات اللازمة لعدم جذب الجرذان؛ ومِن ثَم تجنُّب معضلة قتلِها من الأساس، يبدو حلًّا معقولًا. لكن حتى ذلك يُعَد صعبًا. قال بوبي كوريجان الذي ربما يكون أشهر مُتخصص في مكافحة القوارض في العالم، والذي كان يعمل على الطبعة الثانية من كتابه «مكافحة القوارض: دليل عملي لمُتخصِّصي إدارة الآفات»، عندما اتصلت به: «إن ما يُدهشني بحقٍّ هو أن هذه أمور بسيطة وبديهية للغاية. لكن أغلب الناس يتجاهلونها عندما يتعلق الأمر بالآفات. وكأنهم يقولون في أنفسهم: «من يهتم؟»» لا ينفك يطلب من عملائه إحكام غلق نفاياتهم. لكنه يعود بعد بضعة أشهر ليجد أن شيئًا لم يتغير. وصف ذلك بأنه «مفارقة الإنسان العاقل. نحن لسنا عاقلين على الإطلاق.»
•••
لم أتفاجأ بتعليق كوريجان. فقد سمعتُه مرات عديدة من قبل. لكن ما فاجأني هو الإحباط الدفين الذي تحدث به. إنه صائد جرذان لا يريد صيد الجرذان. يتذكَّر كوريجان جرذًا ظلَّ يتملَّص منه أسابيع في قاعة تداول السلع في مركز التجارة العالمي السابق، حيث كان يخرج بجرأة وقت الغداء ليلتقِط شرائح البيتزا التي لا ينتبِه إليها أحد، ولكن بطريقةٍ ما ظل موقع جُحره سرًّا. أبدى كوريجان احترامه له قبل أن يقتله — وهو أمر شعرَ أنه مدفوع له دفعًا بتوقُّعات عملائه منه والأجواء العامة المُفعمة بالحماسة الذكورية لقاعة التداول — لكنه الآن يندم على قتله. في النهاية، تمنَّى لو أنه لم يجد الجرذ. يقول: «كيف للمرء ألا يحترم حيوانًا بهذا الذكاء؟» باعتبار مِهنته، قد يبدو هذا متناقضًا، لكن كوريجان لديه مبادئ أخلاقية.
يرى أن بعض القتل لا بد منه. إذا غزَت مئات من الجرذان متنزهًا مزدحمًا، أو حدث تَفشٍّ للفئران في مطعم، فلن ينفع صيدها حية. فهذا مُستنفد للوقت ومُكلف وصعب من الناحية اللوجستية. وهو أمر مُحزن، لكن الطبيعة مكان قاسٍ. يقول: «أودُّ أن أسأل أي شخصٍ يقول إنك لا يجب أن تقتُل أي كائن حي: كيف ستفعل ذلك؟ أعطني بعض الأمثلة العملية الحقيقية.» لكنه يرى أن القتل يجب ألا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة، يقول: «إذا سنحت لي فرصة إنقاذ حيوان دون قتله، فأنا أختار أن أفعل ذلك كل مرة.» هو يكره عقلية الأشخاص الذين يتناولون بُندقيتهم كلما رأوا جرذًا أرضيًّا، وتُثير غضبَه فكرةُ الصيد من أجل التسلية. وعندما يُضطر إلى القتل، فإنه يتحرى أقل الطرق ألمًا؛ فهو لا يستخدِم السم، إنما يبث غاز ثاني أكسيد الكربون في جُحر الجرذ، حتى يأتيه الموت كالنوم. وبعدها يحين وقت نصائحه عن إحكام غلق القمامة.
مثل براد جيتس، الذي تُسمِّيه ريبيكا «جدَّنا الروحي»، تُشدد ريبيكا على أهمية منع الحيوانات من الدخول إلى المنازل في المقام الأول. تُجري هي وتيتوس عمليات تفتيش دقيقة للأجزاء الخارجية من المبنى، ويسدَّان كل ثغرة، قبل أن يصيدا القوارض حيةً ويطلقاها في الخارج؛ ليس فقط لأن ذلك أخلاقي، ولكن لأنه أفضل اختبار لعملهما. ويضعان كاميرات الرؤية الليلية لمراقبة محاولات الحيوانات إعادة الدخول؛ وإذا نجحت في الدخول، فإنهما يستخدِمان صبغات فلورية غير سامة تطؤها أقدام القوارض، فتترك آثارًا داخل المنزل تتوهَّج تحت الضوء فوق البنفسجي، وكاميرات المراقبة، التي يُتحكَّم بها بواسطة الهواتف الذكية، لتحديد نقاط الدخول. غالبًا ما يبدأ عملاؤها في إرسال صورٍ لطيفة. تقول: «إنهم يتفاعلون مع الحيوانات التي كانوا من قبلُ يعتبرونها مريعةً وشريرة. أُومن حقًّا أن الناس إذا أُتيح لهم الخيار، فسيُفضِّلون عدم قتل الحيوان. هم لا يريدون سوى أن تُحَلَّ مشكلاتهم.»
وتابعت ريبيكا: «هذه تبِعات وجهة النظر التي ترتكز على الإنسان ولا ترتكز على البيئة»؛ أي لا تحترم القيمة الجوهرية للأنظمة البيئية للأرض. هكذا ترى ريبيكا ما تفعله؛ فالرحمة تجاه كل فأرٍ وثعلب هي جزء مما يَعنيه أن تكون وصيًّا صالحًا على هذا الكوكب. تعتقد أن الانهيار البيئي وشيك الوقوع، وتقول: «وهذا أمر تقبَّلتُه إلى حدٍّ ما. أما الآن فقد بدأتُ أركز على التعامل بإنسانية مع الكائنات الأخرى.» قد يبدو من كلامها أنها مؤمنة بمبدأ الجبرية، بل بمبدأ العدمية، غير أنها أتمَّت مؤخرًا اختبارها لنظام سياج مقاوم للقوارض ابتكرته. بعد حديثنا، أرسلتْ لي مقطع فيديو لفأر يحاول القفز فوقه دون جدوى. قالت: «نحن نصعد إلى القمر. ونطوف حول المريخ. إننا نستطيع بناء حاجز مقاوم للقوارض. تحمَّل المسئولية. وكن وصيًّا صالحًا.»
قالت ريبيكا إن القانون يجب أن يفرِض على المزارعين ومربي الماشية حماية حقولهم ومواشيهم قبل السماح لهم بقتل الحيوانات البرية. لا يجب استخدام السُّم قبل وضع السياج. بالنسبة إليها، ذلك مبدأ أساسي، شأنه شأن عدم تلويث مياه الشرب بالمبيدات. إنها رؤية حكيمة ومُتسقة أخلاقيًّا؛ لكن يكاد يستحيل تخيُّل تطبيقها في الوقت الحاضر. فهي ستثير رد فعلٍ معارضًا سريعًا؛ إذ يمكن تخيُّل تداعيات حرب ثقافية تُتَّهَم فيها النخبة التي تعيش في الحضر بإفلاس المزارعين نتيجة مُطالبتها بحماية الجرذان. يتطلب إحداث مثل هذا التغيير دعمًا جماهيريًّا واسعًا وتغييرًا جذريًّا في المواقف الثقافية تجاه القوارض.
•••
قد يبدو كل هذا عبئًا مفاهيميًّا كبيرًا على الأطفال الذين لا يزالون يشاهدون مسلسل الرسوم المُتحركة «سبونجبوب سكويربانتس». لكن ناردا نيلسون توضح أن الموضوع أبسط بكثيرٍ في الواقع. فهو يعني تشجيع الأطفال على الانتباه إلى الحيوانات التي يُقابلونها في الحياة اليومية والتعاطف معها: الديدان في سلَّة النفايات العضوية داخل الفصول الدراسية، والغزلان والحلزونات التي يُصادفونها في جولاتهم في الغابة، والعفن الغروي، والأشجار التي على وشك القَطع لإفساح المجال لمحطة صرْف صحي. يُشجع المعلمون الأطفال على تخيُّل خبرتهم بالعالم والعلاقات الموجودة في حياتهم. الهدف ليس تعلُّم أسماء الأنواع أو تعزيز النمو المعرفي، إنما هو تغذية الحس والإدراك. تقول ناردا: «الأطفال لا يتحدَّثون عن الأشياء باعتبارها غير عاقل، ولكنهم يعتبرونها عاقلة.»
وهكذا، حدث في صباح أحد أيام مارس أن صادفت مجموعة من الأطفال الملتحِقين بمركز تعليم الطفولة المبكرة التابع لجامعة فيكتوريا، بكولومبيا البريطانية، جرذًا. لم يكن هذا مُخططًا له. كانوا يتجهون مع مُعلميهم إلى بقعة كثيفة الأشجار في الحرم الجامعي للبحث عن آثار حيوانات. لكنهم وجدوا أُنثى جرذ على الرصيف، مُستلقية على جنبها تتشنَّج. كان ما يحدث لها واضحًا، رأت ناردا أن من الأفضل حث الأطفال على المُضي قُدمًا بدلًا من أن يقفوا ليشهدوا ذلك الموقف المُريع. قالت: «لكن الأطفال هم من رفضوا أن يتركوا الأمر يمر مرور الكرام.» تساءل أحدهم إذا كان بإمكانه وضع ضمَّادة عليها. وفسَّر آخر ارتعاش الجرذ بأنه برد؛ ربما يُمكنهم تغطيتها بأوراق الشجر لتدفئتها. وقال أحدهم إنها جدة تحاول العودة إلى بيتها. وأخيرًا قال أحد الأطفال إنها ربما تكون قد تسمَّمت.
في الأشهر التالية، ظلَّت سيرة الحديث عن الجرذ. بعد الواقعة بفترة قصيرة، أحضرت طفلة جرةً بها رفات قطَّتها الحبيبة المتوفَّاة روزي كي تُريها لزملائها وتُحدِّثهم عنها؛ تحدثت عن حياة روزي وكيف أنهم اضطُرُّوا، عندما مرضت، إلى اصطحابها إلى الطبيب البيطري حتى ماتت. ذكر أحد الطلاب أن جدَّه تُوفي مؤخرًا أيضًا، وحُرقت جثته؛ وتساءل الطلاب إذا كان ينبغي أن يفعلوا ذلك لأُنثى الجرذ التي وجدوها على الرصيف. وسأل طفل آخر: لماذا لا نفعل ذلك في كل مخلوق يموت؟
تقول ناردا إنه حتى مجرد تخيُّل إمكان العناية بالجرذان المحتضرة كان له عميق الأثر. فهو يضرب بالمنظور الذي يرى أن جميع الأرواح ليست سواءً، وأن بعض الوفيات لا تستحق أن نحزن عليها، عرض الحائط. كما أنه يُخالف تصنيفَي الحيوانات الضارَّة والآفات اللذَين تُدرَج تحتهما الجرذان تلقائيًّا، وعرَّف التلاميذ على التسميم الواسع النطاق للجرذان الذي يؤثر على حياتهم؛ سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوه. لقد شكَّك في الفصل الأخلاقي بين البشر والقوارض. تقول ناردا: «نحن نعيش مع القوارض طوال الوقت. وهي ليست كائنات جذابة. وليست كائنات نُحب أن نراها بالضرورة. ولكن كيف نتعايش معها؟ لأننا مُضطرون إلى ذلك لا محالة.»
لم يُنظِّم الأطفال احتجاجاتٍ للمطالبة بالتغيير في المدرسة، ولم يشجعهم أحد على ذلك. قالت ناردا نيلسون إن هذا ليس المَغزى من منهج العوالم المشتركة. دور المُعلمين هو تعزيز الحوار والتعاطف والخيال. على الأقل، هناك من شهد على محنة الجرذ. لاحقًا، تمنَّت ناردا نيلسون لو أنها أنهت معاناة أنثى الجرذ المِسكينة، وتحدثت إلى أحد حرَّاس أراضي المدرسة، الذي قال ببساطة إنه لا يسَعُه أن يتحكم في مواضع موت الجرذان. ولكن مجرد تفكير المُعلمين في هذه الأمور كان مذهلًا؛ أن يسألوا عن معنى التعليم في عالمٍ أكثر من بشري، وعن معنى التشكيك في سرديات تفوُّق الإنسان، وأن يُكرموا أنثى جرذ مُحتضرة من خلال السؤال عمَّن يستحق حياةً كريمة وموتًا كريمًا في العالم الذي صنعناه. من يدري ماذا سينمو من البذور التي زرعها هذا الفعل البسيط المُخالف للمألوف.
بعد سنوات، عندما دفع مشروع إنشائي قريب الجرذان للهروب من جحورها، مما نشر الذُّعر قليلًا في بعض أجزاء مركز التعليم، ناقش التلاميذ في فصل ناردا نيلسون الأمر وقرَّروا عدم محاولة اصطيادها ونقلها إلى مكانٍ آخر. إذ سيؤدي ذلك إلى تفكيك الأُسر، وسيكون بمثابة حُكم بالإعدام على بعضها. بدلًا من ذلك، قرروا السماح بأن يكون فناؤهم ممرًّا آمنًا. اتفقوا أن يتجنَّبوا الجرذان إذا صادفوا أيًّا منها، وأن ينتبِهوا أكثر إلى طعامهم، وينتبهوا لنفايات الطعام الخاصة بهم. كانوا يرَون الجرذان من حينٍ لآخر. وكان أحدها أُنثى ذات فروٍ بُني فاتح كانوا يُميزونها بمجرد رؤيتها، وأطلقوا عليها اسم روزي.
•••
في تورونتو، بعد أن ترك جيتس صغار الراكون على السطح، انتقل إلى مكالمات اليوم الأخرى. كان موسم صغار الراكون في أوْجِه؛ وهو يتزامن مع موسم صغار السناجب، ويليه موسم صغار الظربان، وبعد ذلك يأتي موسم صغار الطيور، ثم موجة ثانية من السناجب في الصيف. تعمل شاحنات شركته الإحدى عشرة على مدار العام. الفترة الوحيدة التي يسود فيها الهدوء بحقٍّ هي فصول الشتاء الشديدة البرودة التي يهطل فيها الجليد، عندما تُقرر حيوانات الراكون حفظ طاقتها فتدخل في سباتٍ خفيف — وهي حالة ينخفض فيها النشاط الأيضي لكنها لا تصِل إلى السبات الكامل الذي يحدث في البيات الشتوي، تُشبه نوعًا ما قيلولةً تدوم شهرًا — وحتى السناجب التي تكون نشطةً على مدار السنة، تستكين في أعشاشها تلك الفترة.
منذ أسابيع قليلة، أزال جيتس عائلة من السناجب من فوق مدخل، حيث استغلَّت الأم رداءة الألواح الخشبية المحيطة بأنبوب صرف. واضطُرت كاسندرا إلى قطع جزءٍ من الهيكل بمنشار للوصول إلى الصغار. في أثناء قطعها ذلك الجزء وإنزال الصغار على الأرض، ظلت الأم واقفة بعيدًا، تقرض ثمرة جوز أسود. لم يسبق لجيتس أن رأى هذا السلوك من قبل. رأى أن فعلها ذلك ليس نابعًا من الجوع. إنما بدا له سلوكًا نابعًا من التوتُّر، تُعبر به الأم المذعورة عن هلعِها وهي تُراقب عملاقين يأخذان أطفالها وتقف عاجزة. لحُسن الحظ، أخذت الأم جميع صغارها عندما ابتعد جيتس وكاسندرا، إذ التقطت كلًّا منها من إحدى رجليه الخلفيتَين — وهي حيلة تجعل الصغار تتكوَّر فيسهل عليها نقلها — واندفعت به عبر قمَّة السياج إلى عرينٍ آخر قبل أن تعود لتأخذ واحدًا آخر.
كثيرًا ما يُجانب الحظ صغار الراكون. عندما عاد جيتس وكاسندرا في صباح اليوم التالي، وجدوا أن الأمَّ لم ترجع لتأخُذ إلا واحدًا منها فقط. أما باقي الصغار فتصيح من الخوف والجوع، لكن الخبرة علَّمته أن محاولة إطعامها ستؤذي معِدتها التي اعتادت فقط على العناصر الغذائية والميكروبات الموجودة في حليب أُمها. في صباح اليوم التالي، كان الصغار لا يزالون موجودين. لا يعتقد جيتس أن سبب ذلك أن الأم لا تريد صغارها. إنما يظن أن الحادث كان صادمًا للغاية لها. وهذا نادر الحدوث، لكنه وارد. هو يبذل غاية وسعه لتجنُّب إيذاء الحيوانات، غير أنه ليس بوسعه، أو بوسع أي شخصٍ في هذا العالم، أن يمنع كل جرح. لا يسعه إلا أن يُحاول جاهدًا مُداواته، لكن لن تُشفى كل الجروح تمامًا.
لا يقتصر الحنان الأمومي لأُمهات الراكون على صغارها. إذ تتبنَّى الأمهات بسهولة أي صغارٍ عمرها متقارب مع عمر ذُريتها. يفتح جيتس وكاسندرا الصندوق ويأخذان الصغار إلى شاحنتهما. لحُسن الحظ، لديهما مهمة أخرى لإزالة عش راكون في مكانٍ قريب لاحقًا ذلك اليوم، وبعد أن أخذا منه الصغار، ضمَّا المجموعتَين. وعندما عادا في اليوم التالي، لم يجدا أيًّا من الصغار.



