المدينة الرحيمة
ذات مساء ربيعي رطب، لمحتُ على ممرٍّ مزدحمٍ بالقرب من واشنطن العاصمة جرذَين أرضيَّين صغيرَين؛ كرتَين هشتَين من الفرو، أحدهما كان مصابًا وعاجزًا عن السير، والآخر يترنَّح بين العشب القصير على جانب الممر. كان مكانهما جُحر أمهما، حيث يحجب عنهما مشكلات العالم حنانها وبضع أقدامٍ من التربة، لكن لم يكن ثَمة أثر لأُمهما. ربما افترسها قيوط أو بومة أو حتى كلبٌ أطلق صاحبه رسنَه. كان مصير الصغيرَين بين يدي. هل أُتابع طريقي وأتركهما يموتان، أم أحاول مساعدتهما؟
يرى البعض أنه ينبغي ترك الطبيعة تأخذ مجراها. سيكون جرذا الأرض الصغيران وجبةً لحيوانٍ آخر، ورغم أن دورات الحياة قاسية، فإن الكوكب من دونها سيكون قاحلًا. أعرف ذلك نظريًّا وأتقبَّله؛ ولا أخفيكم سرًّا أني استثقلتُ المسئولية التي أُلقيت على كاهلي والاحتمالات المبهمة التي أفسدت عليَّ خُططي الهادئة لتلك الليلة. غير أنه يصعب على المرء غضُّ الطرف عن المعاناة حينما يراها ماثلة أمامه، ويصعُب عليه أكثر غضُّ الطرف عن العجز وقلَّة الحيلة.
أتذكَّر أني قرأتُ عن مستشفًى محلي للحيوانات البرية، فاستخدمت هاتفي للبحث عن رقمِه. كان قد أغلق أبوابه لليوم، لكن شخصًا ما رد عليَّ وعرض المساعدة إذا استطعت إحضار جرذَي الأرض إلى المستشفى. لم يكن معي ما أحملهما فيه — إذ كنت خارجًا للركض — لكن توقفت لي راكبة دراجة مارَّة، ولحُسن الحظ تبيَّن أنها أخصائية علاج طبيعي عائدة من عملها. أخرجَت من حقيبة ظهرها زيَّها الطبي؛ ووضعت في قميصها الجرذَين الأرضيَّيْن اللذين كانا في حالة من الضعف لا تسمح لهما بالهرب، ثم استدعيتُ سيارة أجرة. تساءلت هل سيسمح لي سائقها بالركوب وهما معي؟ لكن لم يكن ثَمة داعٍ للقلق. إذ كانت السائقة امرأة تُدعى فانتازيا، تحمَّسَت للمساعدة، وأثناء اختراقها الزحام المروري لساعة الذروة، حدَّثتني عن حُبها وحُب ابنتها لغزالٍ يقطن غابةً مصغرة خلف مجمعها السكني.
هكذا وصلنا إلى مستشفى «سيتي وايلدلايف» الذي افتُتح عام ٢٠١٣ لرعاية المرضى والمُصابين من سكان مقاطعة كولومبيا من غير البشر، حيث أخذ مُتطوعٌ الصغيرَين ووعد بالاتصال بي لطمأنتي. تلك الليلة اتصلَت بي بولا جولدبرج المديرة التنفيذية للمستشفى. قالت إن الجرذين الأرضيين حالتهما سيئة للغاية. فهما لم يرضعا منذ أيام، وأنهكت العدوى نظامَهما المناعي الهش. أحدهما ضربته دراجة على الأرجح، وصار عاجزًا عن تحريك ساقَيه الخلفيتَين؛ واضطُروا إلى إخضاعه للقتل الرحيم. أما الآخر فكان أُنثى أخذتها بولا معها إلى منزلها واعتنت بها طوال الليل. ظلَّت على قيد الحياة لبضعة أيام قبل أن تستسلم للموت. مثل أي حيوان، كان موتها لحظةً كاشفة وعصيبة لدرجة لم أتوقَّعها.
أنا رجل مُحب للطبيعة لديَّ عقلية المحافظ على البيئة؛ علمني الحفاظ على البيئة أن أُقدِّر التنوع البيولوجي، وأحمي الموائل، وأدرك المنافع التي تُدرُّها علينا الأنظمة البيئية، وأعرف طبيعة جرذان الأرض وتاريخ حياتها. لكني في تلك اللحظة كنتُ أحتاج إلى المساعدة لإنقاذ حيوانَين برِّيَّين فحسب — ليس جماعات ولا أنواعًا، إنما كائنان يرجفان في راحتي — ولم يكن بمقدور أي منظمةٍ مساعدتي. حتى العيادات البيطرية لم يكن بإمكانها مساعدتي؛ لأن تلك العيادات تعتني فقط بالحيوانات المنزلية. تلك هي الفجوة التي أُنشئَ مستشفى «سيتي وايلدلايف» ليسدَّها. استأذنتُ بولا جولدبرج في قضاء يوم فيه.
بعدها بعدة أسابيع، وبعد انقضاء ذروة موسم صغار السناجب، دعتني إلى المستشفى. وصلتُ في نحو التاسعة صباح يومٍ شديد الحرارة لدرجة أنه يكتم أنفاس الطيور التي كانت تُرفرف في أرجاء الحدائق العامة وبين نباتات الزينة المُتشابكة في ممر السكك الحديدية بجوار المستشفى، الذي يقع في مُجمَّع تجاري غير مُميز في القسم الشمالي الشرقي من المدينة. كان في موقف السيارات أقفاص مُغطَّاة بملاءات لتحجب عنها الشمس، بها ثلاثة عصافير دوري، وزرزوران، وحمامتان هدَّالتان، وزوجان من الأبوسوم، وسنجاب اسمه هوديني. في غرفة فحص داخل المستشفى، بدأت بولا جولدبرج وإليزا بربانك الطبيبة البيطرية المساعِدة تفحصان أول المرضى لذلك اليوم: غراب يافع مُصاب بالجفاف عُثر عليه عاجزًا عن الطيران في مُتنزَّه للكلاب، وطائر مُحاكٍ شرس النظرات وقدمه ملتفَّة بخيط.
كانت إحدى أصابع الطائر المحاكي مكسورة. وكان في ساقه جروح غائرة، وكان بعض ريش ذيلِه مقصوفًا. على الأرجح هاجمَتْه قطة، كان يَصيح معترضًا في حين تُعطيه إليزا مجموعة جرعات من المضادات الحيوية والمسكنات. أما الغراب فحُقِن بالسوائل ووُضِع في حضانة مع غرابٍ صغير آخر يتعافى. بدآ ينعقان في تناغُم كأنهما يقصدان مزامنة نعيقهما. حاولتُ أن أتذكَّر ما أعرفه عن تواصُل الغربان، ذلك النوع المعروف بذكائه واجتماعيته. كان كيفن مكجوان، عالم الطيور بجامعة كورنيل الذي يدرس الغربان، قد أخبَرَني ذات مرةٍ أنه على مدار العقود الثلاثة التي قضاها في دراسة الغربان، تعلم أن يترجم أصواتها — أو لُغتها كما يقول بعض العلماء — ترجمة تقريبية، ويبدو أنها تتمحور في الأغلب حول الطعام والمُفترسين ومُحيطها. غير أنه يصعب متابعة أحاديثها لأن التغيُّرات الطفيفة في النبرة تُغير معاني النداءات. وقد شبَّه مكجوان الصعوبة التي يواجهها في متابعة أحاديثها بشخصٍ لغته الأم الإنجليزية يُصغي إلى حديث باللغة الصينية. ذكر لي أيضًا أنه كثيرًا ما يجد الغربان اليافعة تُكرر النداءات لنفسها، وكأنما تتدرب.
تُرى ماذا يقول هذان الطائران ذوَيا الذكاء الاستثنائي، اللذان انتُزعا من موطنهما ويُحيط بهما عمالقة غرباء؟ تعرف إليزا بربانك شيئًا يسيرًا عن أساليب تواصُلهما. فقالت موضحة: «عندما يفغران منقارهما على هذا النحو، فإنهما يطلبان إطعامهما.»
•••
أدركت إيرين أن خِبراتها التي تتمثَّل في آلاف المكالمات التي تلقَّتها، هي جزء من قضية أكبر: في خِضمِّ زمنٍ يسوده الاضطراب البيئي والثقافي والعلمي، يحاول الناس تبيُّن علاقاتهم الأخلاقية بالحيوانات. قالت لي: «كان الناس ينشدون التوجيه. ما شكل العلاقات السليمة مع الطبيعة في المدينة؟ وما الْتزاماتنا وواجباتنا تجاه العناية بها؟ بينما ندخل حقبة التأثير البشري أو الأنثروبوسين المعرَّفة حديثًا، بدأنا نُفكر أكثر في الطريقة التي نتعايش بها مع الحيوانات البرية؛ فلم نعُد مُهتمِّين فقط بحفظ جماعاتها، وإنما بطبيعة علاقاتنا معها أيضًا.»
المنهجيات المُتعاطفة الرحيمة لحل النزاعات مع الحيوانات برية وما يُسمَّى بالآفات هي جزء من ذلك. جوهرها هو ما يُسميه علماء الأخلاق الواجبات السلبية: الأشياء التي لا ينبغي لنا أن نفعلها. إذا اعتبرنا الحيوانات الأخرى كائناتٍ تُفكر وتشعر ولها وعي بذاتها، ولها أصدقاء وعائلات وعلاقات، أي اعتبرناها أشخاصًا مثلنا وجيرانًا لنا في مدينة ليست حكرًا على البشر، إذن فعلينا ألا نقتُلها إلا لضرورة قصوى. فأكلُها طماطم أحدهم أو تسللها إلى علية أحدِهم ليس مُبررًا لنفيها. لكن ماذا عن الواجبات الإيجابية، أو ما يجب علينا أن نفعله لغيرنا؟ ليس لأن القانون يُلزمنا به بالضرورة، إنما لأننا في قرارة أنفسنا نعلم أنه الصواب؟
بل إنه يمكن اعتبار المستشفى تجسيدًا للمفاهيم التي طرحها ويل كيمليكا وسو دونالدسون في كتابهما «دولة الحيوانات»؛ قد لا يكون للحيوانات المواطنة والمُقيمة الحق في كامل خدمات الرعاية الصحية التي تكفلها المدينة لسكانها البشريين، لكنها تستحقُّ ولو جزءًا منها. تقريبًا نصف عدد المرضى الذين يستقبلهم المُستشفى يأتون من قسم رعاية الحيوانات بالمدينة ومُراقبتها. في العديد من المدن الأخرى، يُرشَد الأشخاص الذين يواجهون مشكلات مع حيوانات برية إلى شركات التخلص من الآفات، أو لا يتلقَّون أي مساعدة على الإطلاق. لكن المعايير الأساسية أكثر تعاطفًا في واشنطن.
بينما كانت إليزا بربانك تُنهي عملها مع الغرابَين، توجَّهت بولا جولدبرج إلى غرفة خلفية وأرشدت المُتدربين إلى تفاصيل التعامل مع عشرات من صغار البط الخضيري المُفرطي النشاط. كانت بولا في السابق مساعِدة طبيب بشري، لكنها تعرَّفت على تأهيل الحيوانات البرية عندما تطوَّعت في متحف سميثونيان الوطني للتاريخ الطبيعي؛ إذ هرَّبت إحدى زميلاتها خلسةً إلى مقر العمل ثلاثةً من صغار الأبوسوم اليتيمة اعتنت بها بولا حتى استعادت عافيتها. لا تزال بولا محتفظة بالسمت التقليدي لمساعدات الأطباء؛ إذ تبدو عليها مسحة من الإنهاك، وتنزع إلى السخرية من شرود ذهنها، ويُهدد رباط حذائها المفكوك بتعثُّرها فيه، غير أنها لا تتعثَّر فيه أبدًا. تحتفظ بهدوئها تحت الضغط وتُنجز المهام المطلوبة. بعد أن تُوزَن صغار البط، تؤخَذ إلى مسبح للأطفال بالخارج. تمرح فيه مثل أطفالٍ في مُتنزَّه ألعاب مائية.
بالداخل، وصل المزيد من المرضى للمُستشفى: ثلاثة حيوانات أبوسوم صغيرة جدًّا جاءت بها امرأة شاهدت سيارة تصدم أُمَّها وهي تُنزِّه كلبها بالقُرب من حي كابيتول هيل، وكانت تملك من حضور الذهن ما دفعها لتفقد جرابها. (الأبوسوم هو الحيوان الوحيد في أمريكا الذي ينتمي إلى رتبة الثدييات الجرابية التي يُعَد الكنغر أشهر حيوان فيها.) كانت صغارها الرضَّع عاريةً من الفراء ووردية اللون، ولا تزال أعينها مُغلقة، وكانت ضئيلةً بدرجة تستبعِد احتمال بقائها على قيد الحياة. كانت أيضًا تُعاني من الجفاف، ولم يستجب أحدُها للقرْص؛ ومِن ثَم يبدو أنه كان يُعاني من إصابةٍ في العمود الفقري. على الأرجح سيخضع للقتل الرحيم على الفور. لهذا الغرَض، توجَد بالمُستشفى حُجيرة يُضَخ فيها غاز مُخدِّر. يُفترَض أن تكون الوفاة سريعة وغير مؤلمة. قالت إليزا بربانك: «إنه موت أقل فظاعةً من الموت جوعًا ببطء. لعل الموت في بعض الحالات هو العلاج المناسب الذي يُمكننا تقديمه.»
الأبوسوم حيوان هادئ وبطيء الحركة، ونادرًا ما يُهاجم البشر. عندما يتعرَّض للتهديد، قد يُهسهس أو يكشر عن أنيابه، وإن لم يُجدِ ذلك فإنه قد يتظاهر بالموت. ومع ذلك، غالبًا ما يعامل الناس الأبوسوم بقسوةٍ شديدة، ربما بسبب مظهره الذي يُشبه الجرذان الضخمة للعين غير الخبيرة، وهو من الرواد المُنتظمين لمستشفى «سيتي وايلدلايف». في الربيع السابق، استقبل المستشفى أُمًّا رشَّها أحدُهم برذاذ الفلفل الأحمر. ومنذ عدة أشهر، عثر أحدُهم على أبوسوم يُنضَح بمُبيض للأقمشة. تذكُر بولا جولدبرج أن قسًّا سألها إذا كان بإمكانهم استقبال عائلة أبوسوم أسرَها في مرأبه. قالت: «قبل أن يجد مكانًا يأخذها إليه، كان ينوي وضعها في كيسٍ بلاستيكي ورجمها بالحجارة حتى تموت. لكنه أحضرها إلينا. وأراحه ذلك. وقال: «سأخبر رعيتي».»
في المطبخ، أعطت بيجي هاموند، مساعدة رعاية الحيوانات البرية بالمُستشفى، وجبة إفطارٍ لسنجاب رضيع. كان منهمكًا في الرضاعة بجسده كله؛ إذ تمدَّد في راحتها مثل سوبرمان أثناء طيرانه يمصُّ الحليب من أنبوب. استدعى المشهد في ذهني مقطعًا كتبَتْه عالمة الأنثروبولوجيا باربرا سموتس تصف فيه كيف غيَّرت مُعايشتها لقرود البابون وجهة نظرها عن الحيوانات، وحوَّلت كلًّا منها إلى فردٍ مميز بعد أن كان مجرد مثال لنوعه؛ وهو إدراك تجلَّى في لقائها بسنجاب. كتبت عن مصادفتها لسنجابٍ في الغابة: «الآن، بتُّ أرى كل سنجابٍ أصادفه مخلوقًا صغيرًا ذا ذيل منفوش، يُشبه الإنسان. رغم أني عادةً لا أميز هذا السنجاب من ذاك، فإني أعرف أني لو حاولتُ فسأفعل، وما إن أفعل، حتى يكشف هذا السنجاب عن نفسه باعتباره كائنًا فريدًا تمامًا.» بطريقةٍ ما، يُغذِّي فعل الإرضاع هذا الشعور. السنجاب المُستلقي في راحة بيجي، وكلٌّ من الحيوانات الأخرى في المستشفى، لم يعُد في نظري مجرد واحد من ضمن العديد أمثاله، إنما شخص. ربما لا أعرفه جيدًا ولكني مع الوقت قد أفعل.
على أي حال، لم يأتِ ماكول ببطٍّ غياض من الملجأ، إنما أحضر خمس بطَّات برية صغيرة دهست سيارةٌ أُمَّهم. فحصت إليزا بربانك وبيجي هاموند البط، في حين كانت بولا جولدبرج تشرح لزائرةٍ أخرى وجدت في فنائها فرخ زرياب أزرق نبَت ريشه، أن فراخ الزرياب الأزرق لا تحتاج إلى الإنقاذ. شرحت لها قائلة: «لن تفهم الأُم لِمَ أخَذ أحدٌ صغيرها. سوف يُصيبها الهلع.» لكنها وافقت أن تأخذ الطائر تلك المرة. فجيران المرأة جميعًا لديهم كلاب وقد يفترسه أحدُها.
أثار الحوار في ذهني تساؤلات عن الآثار البيئية لتلك التدخُّلات الحسنة النية. بقدْر ما قد يبدو ذلك قاسيًا، فإن الفراخ وغيرها من الحيوانات المُصابة مثل صغيرَي جرذ الأرض اللذين وجدتهما، تُعَد مصدرًا مُهمًّا للغذاء في الطبيعة. فهي، في غياب البشر، تُعَد جزءًا من عمليات تدعم مُجتمعاتٍ أكثر وفرة وقوة من أي مجتمعات يُمكننا تصميمها. لكن في صورته المُتطرفة، ما تبعات التدخُّل على البيئات المحلية؟ هل قد يؤدي إلى تقلص شبكات الحياة الحضرية، فتدعم عددًا أقل من الحيوانات المفترسة والقمَّامة، وبمرور الوقت، يتقلَّص دور التنوع البيولوجي في تنظيم النظم البيئية؟ هذا سؤال نظري مُثير للاهتمام. أما جولات إطعام السلاحف التي كانت على وشك البدء، فهي مسألة أكثر عملية.
كان بالمستشفى ثلاث سلاحف مائية: ذكر سلحفاة نهَّاشة كبير ضخم صدمته سيارة، وسلحفاة نهَّاشة صغيرة صِيدت خلافًا للقانون بجانب نهر أناكوستيا ثم صُودِرت لاحقًا، وأنثى سلحفاة صندوقية عُثر عليها الجمعة الماضية بعد أن سقطت من حافة مرتفعة بالقرب من متحف بيت الرئيس الراحل وودرو ويلسون. كان ذكر السلحفاة النهاشة الكبير في حالة سيئة؛ إذ انتشرت على الجلد الأخضر السميك لوجهِه وساقَيه خدوش لا تزال حديثة. أمسكت به بيجي هاموند ورفعته بعناية، من مَوضع تكون أصابعها فيه بمأمَن من عضَّته الشهيرة، في حين حقنت إليزا بربانك المُضادات الحيوية في ساقه الخلفية.
على الأقل، كانت أنثى السلحفاة الصندوقية تتعافى جيدًا. كانت الضمَّادات تُغطي الصدع في صدفتها، المرقشة باللونَين البرتقالي الفاقع والأخضر الداكن مثل سائر جسدها. بدت كأنها تمد ذراعها لإليزا كي تُعطيها الحقنة. قالت بولا إنه في الخريف الماضي، اعتنى المستشفى بذَكر سلحفاة صندوقية تعرَّض لحادث سقوط مُشابه عند المتحف. قالت: «أعدناه إلى هناك في أكتوبر. دخل في سبات السلاحف — وهو نسخة السلاحف من البيات الشتوي — وهو بخير الآن.»
حكت لي بولا قصةً سمعتها عن إديث زوجة الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون التي لم تكن شغوفةً بالأطفال، وعندما كان يأتيها زوَّار لتناول الشاي، كانت تُرسِل الأطفال للحديقة للبحث عن سلحفاة. يمكن أن تعيش السلاحف الصندوقية لأكثر من قرن. قالت: «قد يكون الذكر الذي اعتنَينا به العام الماضي قد قابل الرئيس ويلسون. ربما كان هو السلحفاة التي سكنت حديقته.»
•••
جاء وقت الغداء وساد الهدوء. في حرِّ الظهيرة بالخارج، كان طائر مُوَّاء نال قسطه اليومي من التريُّض يتأهَّب للرحيل. وكان السنجاب هوديني ينام فترة القيلولة. واحتشدت صغار البط التي هدَّأتها السباحة في زاوية بخيمتها وقد غمرَها الرضا. وبينما كانت بيجي هاموند والمتدربون يُقطِّعون الخضار ويمزجون الحليب الصناعي لوجبة الظهيرة، ورد اتصال هاتفي: سلحفاة أخرى، عُثر عليها داخل مرأب ورشة سيارات بالقُرب من مُتنزَّه روك كريك.
كان ذلك النقاش نظريًّا، على الأقل يومَها. وردت صورة عبر البريد الإلكتروني لسلحفاة صندوقية. قالت بولا جولدبرج: «لقد بدأت الإناث تتجوَّل بحثًا عن أماكن لوضع البيض»، وتركت رسالة تطلب من الشخص الذي وجد السلحفاة الاتصال بها حتى تتمكن من إرشاده إلى المكان المناسب لإطلاقها. غريزة التوجيه لدى السلاحف قوية جدًّا. إذا لم تُعَدْ إلى حيها، فستظل تحاول العودة، وتعبُر الطرق للوصول إليه.
في غرفة الحضانة، تلقَّى صفٌّ من الفراخ الموضوعة في الحضَّانات — خمسة من طيور أبي الحناء، وزرزور، وثلاثة عصافير دوري — وجباتٍ مناسبة من متطوِّعة تُدعى لوري سميث. لوري مُتخصصة في علم الأحياء، تعمل في حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية، حيث ظلَّت حتى بضع سنوات ماضية ترعى طيور حديقة الحيوان. هي الآن تعمل في اللجنة المشرفة على إعداد وجباتها الغذائية، وتُشبع رغبتها في رعاية الطيور بنفسها بالتطوُّع في مستشفى «سيتي وايلدلايف». كانت الفراخ الصغيرة ذات وجوه جميلة بعين الأمومة فقط كما يقولون؛ إذ كانت رءوسها ضخمة وعيونها جاحظة وريشها لم يكتمِل نموُّه بعد. كانت سميث تهمس بحنان أمومي وهي تضع الديدان في مناقيرها الممدودة بمِلقاط. قالت وهي تتحرك ببطء حتى نهاية الصف ثم تبدأ مجددًا من أوله: «لا أملُّ الاعتناء بالطيور الصغيرة طوال اليوم.»
عندما سئلت إيرين لوثر عن مفارقة الحمام، قالت إن العناية بتلك المخلوقات لا يجِب أن تُعَد مجرد وسيلة لتحقيق غاية أهم. فهي كائنات مُهمة بحدِّ ذاتها. غير أن العناية بها لها تأثير قوي، وحكت لي إيرين قصةً حدثت أثناء عملِها في مركز تورونتو للحيوانات البرية. اتصلت بها امرأة عثرَت على طائر مُصاب وهي في طريقها إلى العمل. قالت المرأة لإيرين: «كنتُ أنوي أن أُتابع طريقي، لكنه نظر إليَّ. تواصلنا بالنظرات. وشعرتُ أني يجِب أن أفعل له شيئًا.» كانت الخطوة الأولى هي معرفة نوعه، فطلبَت إيرين من المُتصلة أن تصِفه لها: لونه رمادي فاتح، يُحيط برقبته ريش لامع قزحي لونه أخضر مائل للأرجواني. سألت إيرين: «أهي حمامة؟» جاءها الرد: «كلَّا، إنه طائر مُميز للغاية.» إنه أصغر وأرق من الحمام؛ ربما يكون من نوعٍ نادر.
تُتابع إيرين: «قلت: «حسنًا، لماذا لا تَجلبيه إلى المستشفى ونفحصه؟» أحضرته فعلًا، وأخذتُ منها الصندوق وفتحتُه فإذا به حمامة. إنها حمامة عادية لا يُميزها شيء على الإطلاق.» ضحكتُ، لكن إيرين تابعت قصتها. قالت: «لقد تأثرتُ كثيرًا. حدث شيءٌ في تلك اللحظة التي التقت فيها عيناها بعينَي الطائر جعلَها ترى هذا الطائر العادي فريدًا وجميلًا. لطالما أحببتُ أن أستخدِم هذه القصة باعتبارها مجازًا لما يحدُث عندما ننتبِه للحياة من حولنا والاحتمالات الموجودة فيها.»
حكت لي بولا عن نصيحة صديق يعمل في إعادة تأهيل الحيوانات البرية. تقول: «هو يعتبر الدقائق التي نقضيها في التعامُل مع الأشخاص الذين يجلبون الحيوانات دقائق قليلة من شأنها أن تُغير العالم. عندما يجلب شخصٌ ما حيوانًا، تتكوَّن صِلة بينه وبين ذلك الحيوان.»
•••
ترى آن لويس أن المباني في المنطقة تُشكل خطورة بالنسبة إلى الطيور. في مبنًى مكتبي، حاصل على شهادة نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (ليد) الذهبية بسبب بنائه الصديق للبيئة، تآمرت إضاءة البهو مع الإضاءة الحمراء المُتوهِّجة للافتات الخروج — وهو لون الزهور المُفضل لطيور الطنان — لجذب تلك المعجزات الصغيرة إلى حيث تُلاقي حتفها أثناء تحليقها. (أبلغ طاقم الصيانة في هذا المبنى آن عن المشكلة؛ وتقول إنه غالبًا ما يكون القائمون على النظافة وغيرهم من العمال الذين يبدءون عملهم في الصباح الباكر مُفيدين للغاية.) وفي موقع آخر، كان يوجَد ممر مشاة زجاجي يقطع الشارع بين المباني، ويبدو أنه صُمِّم لترتطم به الطيور غير المُنتبهة.
عندما أضاءت السماء، عكسها بوضوح تام مبنًى ذو تصميم عصري حائز على جوائز، من الواضح أن المهندس المعماري الذي صمَّمه لم يُدرك أن أعدادًا هائلة من الطيور سترتطم بتلك المرايا العملاقة الموجودة فيه. وتلك زلَّة كانت مقبولة لو أنها وقعت منذ بضعة عقود، قبل أن تشيع المعرفة بالأخطار التي تُشكلها النوافذ على الطيور. لكن كيف لأحدٍ أن يقع فيها الآن؟ وقالت آن، وهي مهندسة معمارية متقاعدة: «هذا أكثر شيء مُحبِط في العالم.»
كل أفعال العناية الفردية تلك تراكمت لتُحدِث تغييرًا أكبر. لم يكتفِ القائمون على مستشفى «سيتي وايلدلايف» بمساعدة الحيوانات التي يُحضرها الناس إلى باب المستشفى، وإنما خرجوا إلى المدينة ولفتوا الانتباه إلى مشكلة. قالت لي آن: «عندما انخرطتُ في هذا الأمر لم أكن أعتبر نفسي ناشطة. إنما أردتُ فقط إنقاذ بضعة طيور.» غير أن ذلك الدافع أدَّى إلى إحداث تغيير من شأنه أن يُنقذ حياة الآلاف من الطيور.
بعد المرور بعدة مبانٍ أخرى كنَّا شاكرين لأننا لم نجد عندها أي طيور ساقطة، أخذتني آن إلى مقر ناشيونال جيوجرافيك. هناك، يُعشش زوجان من الإوز الكندي على الحافة المُعشبة التي تحيط بالطابق الثالث. برز رأساهما بزهوٍ من فوق السور. كانت آن وأبريل لينتون، مؤسِّسة برنامج مراقبة البط التابع لمستشفى «سيتي وايلدلايف»، الذي يضم شبكة من المتطوِّعين الذين يراقبون البط البري الذي يُعشش في مواضع غير آمنة وقد يحتاج إلى مساعدة لاحقًا، تساعدان الموظفين في ملاحظة الإوزَّتَين. فقس البيض أمس؛ وكانت الخطة هي الانتظار حتى تقفز الفراخ إلى الأرض، ثم أخذ الأسرة كلها إلى بركةٍ في حدائق «كونستيتيوشن» القريبة.
في الوقت الحالي، لم يكن ثَمة ما يحدث؛ لذا أخذتني أبريل لينتون — وهي عالمة اجتماع في وزارة الخارجية الأمريكية، كانت ذلك اليوم في إجازة من عملها بخلاف آن المتقاعدة — في جولة لزيارة أعشاش البط الخضيري القريبة. أرَتْني ثلاثة أعشاش: الأول في رقعة من الأزهار تحت شجرة على جانب الطريق، والثاني في صندوق شجرة خرساني، والأخير في مجموعة شجيرات في فناءٍ مرصوف أدنى من مستوى الرصيف. باستثناء العش الأخير، كانت حركة المُشاة تتدفَّق حولها، وعلى بعد بضع أقدام منها كان هناك زحام مروري. أوضحت أبريل أن البط يحب إقامة أعشاشه في تلك المواضع على جانبَي الطرق رغم أنها تبدو خطرة. هي ليست بجودة إقامتها بجوار البركة أو على ضفة نهر بوتوماك، ولكنها تظل خالية تقريبًا من الحيوانات المفترسة، كما أن لا أحد يُزعجها فيها. توقفت لتصوير الأم التي تُعشش في صندوق الشجرة. كان عشها دقيقًا لدرجة مذهلة، مُبطنًا بريشٍ نزعَتْه من صدرها، مخلفًا رقعةً مكشوفة من الجلد تلامس البيض لتدفئته بشكلٍ أفضل. ظلَّت تُراقبنا بعينَيها البنيتَين الداكنتَين، لكنها لم تحرك ساكنًا.
إن حدوث هذا الفعل الهادئ والملحمي المُعبر عن الأمومة المُتفانية في هذا المكان المزدحم دون إزعاجٍ لهو أمر استثنائي، من شأنه أن يُعيد للمرء إيمانه بالإنسانية. مرت سيارة إسعاف تُدوي بصوت صفارتها العالي. ولم تُبدِ الأُم أي ردِّ فعل. في النهاية، ستقود هي والأمهات الأخريات صغارها عبر الشوارع إلى الماء، حيث قد تجِد أزواجها. (يشاع عن ذكور البط الخضيري أنها تترك للأمهات مهمة تربية الصغار، لكن أبريل تقول إن هذا لا يحدُث في كل الحالات. في الواقع، يبدو أن احتمال مساهمة ذكور البط الخضيري في الحضر في تربية الصغار تكون أعلى من نظرائها في الريف.) إذا حدثت هذه الهجرة القصيرة أثناء مناوبة أحد متطوعي برنامج مراقبة البط، فإنه سيرافقها، وسيوقف حركة المرور أثناء عبورها الطرق.
سألتُ أبريل أين تشعر أن دورها في التدخُّل ينتهي. أخبرتني أنها لا تحاول منع الافتراس، وقالت: «الغربان أيضًا بحاجةٍ إلى أن تأكل»، لكنها تبذل قصارى جهدها لمنع صغار الإوز من التعرُّض للدهس أو الغرق في النوافير ذات الحواف المُرتفعة التي تعجز الصغار التي لا تستطيع الطيران بعدُ عن اجتيازها. خطر لي أن هذه المساعدة الحسنة النية قد تؤدي إلى عادات تعشيش غير مُتكيفة بشكلٍ ملائم، وأنه ربما ترْك البط يموت سيكون حلًّا أفضل على المدى البعيد؛ لكن من المُحتمل أن يحل محلَّه بط آخر، وستظلُّ المشكلة قائمة. وذلك أيضًا يبدو لي قسوة غير مبررة. إذا أراد الناس المساعدة، فلماذا لا نرحِّب بها؟ ماذا سيحدث إذا تشكلت مجموعات لرعاية العديد من الأنواع، وتشكلت شبكات من الناس المتعاطفين مع السلاحف الحضرية أو البوم أو الأبوسوم أو الفراشات أو أي نوعٍ آخر لمراقبة تلك الحيوانات، والحول بينها وبين المخاطر التي يصنعها الإنسان وتتعرَّض لها في البيئة التي تعيش فيها معه؟ هذا جدير بالتفكير.
عُدنا إلى مقر ناشيونال جيوجرافيك حيث انضمَّت إلينا بولا جولدبرج. كانت الخطط قد تغيَّرت؛ كان زوجا الإوز يستكشفان الحافة المحيطة بالمبنى، ويبدو أنهما ينويان القفز على الخرسانة بدلًا من المهاد الأنعم الذي يكسو الفناء. لكن سيحاول فريق «سيتي وايلدلايف» الإمساك بالإوز الصغير وحث والدَيها على الدخول إلى المبنى والخروج في الطابق الأرضي. دبَّت الحماسة في المكتب مع انتشار الخبر. خرجت بولا جولدبرج وآن لويس إلى الشرفة، تحمل كلٌّ منهما مظلةً تأهُّبًا لحماية نفسها من الهجوم. قالت آن مُحذرة: «نحن في منطقة عُنف يمكن أن يُكسَر فيها أنفك.» قالت بولا مازحة: «أنا لا أُحب أنفي على أي حال.» لكن مخاوفهما لم تتحقَّق؛ كما قالت بولا لاحقًا، يبدو أن زوجَي الإوز أدركا أنهما لا ينويان سوءًا. ساقتا الإوز الصغير إلى قفصٍ ثم تراجعت آن حاملةً القفص على ارتفاعٍ منخفض إلى داخل المبنى، يتبعها موكب الأبوَين الصادح.
سارتا مع الإوز في ممرٍّ قصير — توقف فيه الأبوان للتبرُّز — ثم عبرتا غرفة مفتوحة واسعة تملؤها المكاتب، يحفهما موظفون صامتون تمامًا يُصورون الحدث بهواتفهم، ثم مرَّتا بجوار صفٍّ من ماكينات التصوير، ودلفتا إلى المصعد. تبع الزوجان آن إلى داخل المصعد، وانتظرا حتى يُغلَق الباب، ثم خرجوا جميعًا في الطابق الأول، حيث عبر الزوجان من تحت مجموعة من البوابات الدوَّارة وخرجا إلى الفناء. وهناك، اجتمع شمل العائلة في النافورة، في حين أقام موظفو ناشيونال جيوجرافيك حفلًا مرتجلًا. لا شك أن أحد دوافعهم إلى الاحتفال كان الاستراحة التي أتاحها لهم المشهد من روتين العمل اليومي، ولكنهم كانوا مدفوعين أيضًا برحمةٍ حقيقية تجاه الإوز. كان لذلك المكتب قناة مُخصصة على تطبيق التواصل «سلاك»؛ وكان يوجَد أيضًا كاميرا ويب تبثُّ مباشرةً المشهد الذي يُشاهده الآلاف من الناس حول العالم، وبينما كانت أبريل لينتون وآن لويس تراقبان العش، توقف العشرات من الناس للدردشة. هل الغرَض من كل هذا مجرد إرضاء للذات وتسكين للضمير ليس أكثر؛ ومِن ثَم يُشتت انتباهنا عن الجهود الجادة للحفاظ على البيئة؟ أم إنه قد يُمهد الطريق إلى رعاية أعمق وأوسع للبيئة والحيوانات؟ أنا أراهن على الاحتمال الأخير.
تركنا الإوز يستريح ذلك المساء، وعُدنا في صباح اليوم التالي لنُرافقه كما يفعل متطوعو برنامج مراقبة البط، إلى حدائق «كونستيتيوشن». ساعدت آن بولا في إدخال الإوز الصغير إلى القفص مرة أخرى، ثم أعطتني سترةً عاكسة وشبكة ذات مِقبض طويل. سأسير في الخلف لأساعد في منع الوالدين من الشرود، في حين ستتولَّى بولا حركة المرور، وتحمل آن القفص.
تقدَّم موكبنا الغريب في شارع ١٦، من المنطقة المشجرة المحيطة بمبنى ناشيونال جيوجرافيك إلى منطقةٍ أكثر ازدحامًا تحفُّها المحلات التجارية والفنادق الراقية، مرورًا بكنيسة سانت جون الأسقفية. عبرنا مُتنزه لافاييت، مباشرةً عبر شارع بنسلفانيا من البيت الأبيض، وسِرنا في شارع ١٧، على يَسارنا كانت أراضي البيت الأبيض حيث وقف عملاء الخدمة السرية يراقبوننا دون اكتراثٍ من وراء سياجٍ حديدي.
كنت أنوي تدوين الملاحظات والْتقاط الصور لكي أتمكن من وصف المشهد وصفًا أدق، لكن استحال ذلك. إذ صاحت آن لتُنبهني ألَّا أرفع عيني عن الإوزتين. أصبح الزوجان محط انتباهي، ولم أُدرك إلا بطرف عيني نظرات التعجُّب التي تتحول إلى بهجة ارتسمت على وجوه الأشخاص الذين مررنا بهم. تعب الوالدان؛ وصار وقع أرجلهم على الرصيف الساخن أبطأ، وفغرا منقارَيهما فيما خُيل لي أنه تعبير عن الإنهاك. في لحظةٍ ما، دنا منَّا رجل يركب دراجة أطفال. كان انطباعي عنه أنه مشرد، وبعد أن سألَنا عما نفعله، ابتعد مُتذمرًا.
خطر لي أنه في مجتمع يُعاني من العديد من المشكلات البشرية الملحَّة، يُعَد ما نفعله عين التفاهة. لكن لو أن بولا وآن وأبريل يُمضين أوقاتهن في مشاهدة التلفاز بدلًا من مساعدة الطيور، فهل كان أحد سينتقدهُن؟ من السهل انتقاد أفعال الرعاية المُغالى فيها بدلًا من الاحتفاء بها، ربما لأنها تجعلنا نُدرك أن بوسعنا أن نفعل الكثير، وهي فكرة ليست مريحة.
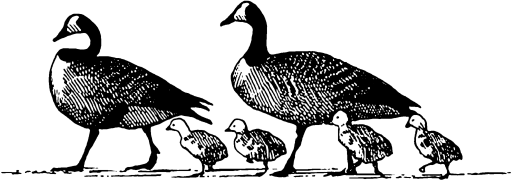
عندما اقتربنا من حدائق «كونستيتيوشن»، طلبت آن المساعدة من امرأة صادف أنها خرجت تتمشَّى أثناء استراحة الغداء. ساعدَتها في إيقاف حركة المرور في الحارات الثماني لشارع «كونستيتيوشن»، وزفَّنا السياح بصيحات تشجيعٍ عفوية أثناء عبورنا. كانت الإوزة الأم تعرُج بشكلٍ ملحوظ؛ إذ أنهكت الرحلة، التي كانت قطعًا الأطول في حياتها، عضلاتِها إلى أقصى حد. لا بد أن العشب الأخضر البارد في حدائق «كونستيتيوشن» كان بمثابة بلسمٍ لقدميهما. يبدو أنه أنعش الوالدَين. إذ صدَحا، وصاح الصغار، بينما اجتزنا العُشب وتوجَّهنا إلى حافة الماء، حيث ساعد «سيتي وايلدلايف» في إقامة عدة منحدرات يمكن للطيور المائية استخدامها لتسلُّق الضفاف الحجرية العمودية للبركة. أطلقت آن لويس الصغار؛ وهُرع الوالدان إليها. ومعًا، تهادت الأسرة مبتعدة.
•••
في غرفة مُبرَّدة في الجزء الخلفي من المستشفى، كان يوجد صندوق تبريد بحجم صندوق سيارة مكتوب عليه «الذين لم نتمكن من إنقاذهم». كانت تودع فيه الجُثث. وصفَته بولا جولدبرج بأنه «مبرد مُمتلئ بالأرواح المفقودة.» كان الصندوق ممتلئًا على آخِره تقريبًا. في الأعلى كانت صغار الأبوسوم التي جاءت في الصباح، وسنجاب، وأرنب صغير، ونقَّار خشب مرقَّط، والعديد من فراخ طيور لم ينبُت ريشها بعد. بدت مُسالِمة، وغريبة أيضًا، لا أقصد قبيحة، إنما دخيلة على ذلك العالم الذي صمَّمه البشَر من النوافذ والأسفلت والسموم. عالَم بُني حول عالمها وفوقه من قِبل أشخاصٍ يمكنهم تصميم هاتفٍ ذكي أو سلسلة إمداد لملح الهيمالايا ولكن ليس لدُرَّسة نيلية.
بعض الحيوانات تمكنت من التأقلُم فيه قطعًا. لكن حتى تلك الحيوانات غالبًا ما نكون نحن السبب في موتها. أغلب الحيوانات التي يستقبلها المُستشفى تكون إصاباتها ناتجة عن نشاطٍ بشري؛ فهي إما صدمتها سيارة وإما دهستها جذَّاذة عُشب، أو هاجمتها حيوانات أليفة، أو سمَّمتها المبيدات الحشرية. في غضون بضعة الأسابيع الأخيرة، نشر المُستشفى على صفحته على «فيسبوك» صورةً لبطَّة وُجِدت ملفوفًا على منقارها خيط سنَّارة، وأرانب صغيرة كاد يفترسها كلب غير مُقيد، وحمامة احتاجت إلى بتْر إصبعٍ بعد أن عَلِق فيه خيط ونخَر لحمه. كل هذه الحوادث كان يمكن تجنُّبها. وتُعَد رعاية مستشفى «سيتي وايلدلايف» لضحايا تلك الحوادث بمثابة عملية تدقيق، تُنبه المدينة وسكانها إلى الطرق التي يمكن أن يكونوا بها أكثر رأفةً بالحيوانات. قالت آن لويس: «لقد أصبحت منظمتنا مُنخرطة في المجتمع أكثر مما كنا نتصور. فالجهود اللازمة لمنع هذه الإصابات أكثر بكثيرٍ من تلك اللازمة لإنقاذ الحيوانات.» جهودهم تُصعِّب علينا غضَّ الطرف، وتَجنُّب المسئولية.
نحن مُلزمون أخلاقيًّا بمساعدة المخلوقات التي نؤذيها. لهذا السبب، تبدو لي وجهة النظر، التي ترى أن الأموال المُنفَقة على إعادة تأهيل الحيوانات البرية ستكون أنفعَ إذا أُنفقت على حماية الموائل، غير منصِفة، بقدْر ما يُعَد حرمان أحد المارَّة تعرَّض لحادث عند تقاطُع خطير من الرعاية الطبية لأنه سيكون من الأنفع إنفاق تكلفة الجراحة على الضغط من أجل تحسين لوائح سلامة الطرق. فأهمية التغيير المنهجي الواسع النطاق لا تُلغي أهمية الأفراد. وعلى المدى الطويل، هل سيهتمُّ مجتمع لا يرى أفراد البط الخضيري غير مُستحقة للرعاية بالحفاظ على التنوُّع البيولوجي؟
في غرفة الحضانة، واصلت لوري سميث إرضاع الصغار. واختبرت إليزا بربانك ما إذا كان أحد الطيور الموَّاءة مستعدًّا للمغادرة. ليس بعد؛ إذ لم يتمكن من الطيران على ارتفاع أعلى من ذلك الذي أطلقته منه. راجعت هي وبولا جولدبرج سجلَّات أبوسوم صغير كان يتعافى بشكل جيد. رن الهاتف مرة أخرى: عُثر على سلحفاة حمراء البطن على طاولة في مُتنزَّه بحي أناكوستيا، ملفوفة بخيط سنارة وبفمِها خطاف. طمأنت بولا المُتصل: «إذا لم يكن الخطاف قد استقرَّ في الأمعاء، فيُمكننا تخديرها ونزعه منها.» تذكَّرتُ أني في مراهقتي اصطدت سلحفاة بخيطٍ وخطَّاف لكن الخيط انقطع. لم يخطر لي أن أتساءل عن مصيرها.
كان آخر مريض ذلك اليوم فرخ بطٍّ خضيريًّا وجدَتْه امرأة شابة صباح ذلك اليوم بالقُرب من نصب جفرسون التذكاري، وأحضرته في صندوق كرتوني. قالت المرأة: «بحثتُ في كل مكان عن الأم.» أبقَتْه بجانبها في العمل، وكانت تضع الماء والخبز المُبلل في منقاره. وكانت قد أطلقت عليه بالفعل اسم فرانسيسكو. قالت لها بولا شاكرةً وهي تلفُّ فرانسيسكو في بطانية وتضعه في الحضانة: «لقد أنقذتِ حياته»، ثم أخبرتها عن برنامج مراقبة البط.



